كافكا الذي أعرف 1
في مدح المبهم، المحاسسة، أصوات السرد
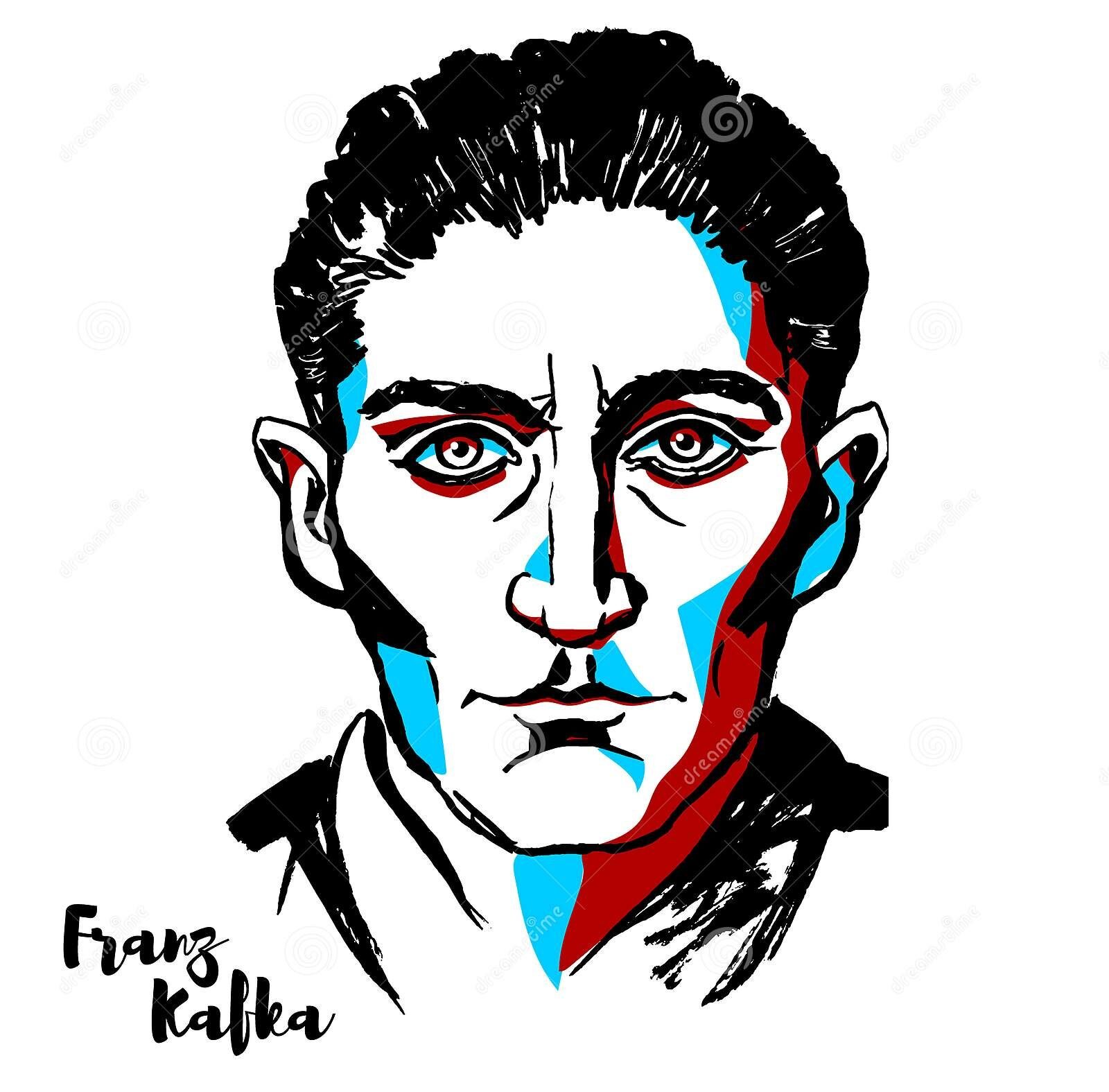
دعاء خليفة
(لا بد من التنبيه أن الآراء الواردة في هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن كافكا المعلوم لدى الآخرين، وإنما ذلك الذي يخصني)
في مديح المبهم
ننشأ منذ صغرنا على رؤية العالم من منظور الثنائيات، وكيف أن كل ما هو هنالك قائم عليها، لنكبر قليلاً بعدها ونتعلم أن الأبيض يحوي بداخله شيئاً من الأسود والعكس كذلك. ثم نرتقي بوعينا أكثر لنتعلم أنه لا بد من الجهل بكل ما تعلمناه حتى نرى الشيء في ذاته بقدر المستطاع. هذا الجهل المتعمد هو في باطنه ليس سوى إعادة برمجة قد تستغرق شهوراً، وفي أحيان أخرى سنوات وحيوات بأكملها حتى يؤتي ثماره معيناً لنا في تجاوبنا تجاه الحياة. كما لو تكتب جملاً مؤكدة، أو تفصح عن واقعة حدثت بحياتك ثم تنتهي إلى إضافة (كما لو) في بداية الفقرة لوصولك إلى مفترق طرق كنت تتجنبه طويلاً بالكتابة الحرة. ثم تباغتك طعنة الشك من حيث لم تحتسب. وكل هذا في سبيل أن تخلق نسخة أفضل لذاتك.
في قراءتي للشعر أنزعج لو مر عليَّ تحليل واضح لمغزى القصيدة بنحوٍ يجعلني واعية بها معرفيا، فأنا أفضل الإحساس بالقصيدة التي أمامي، وهذا ما يجعلني أعود إليها مرارا دون أدنى شعور بالملل فيم لو كنت أعرف خلفيتها المعرفية. لذات السبب قد يدمن بعضٌ على قصيدة ما لأن ما يستقونه من الشعر هو هذه المعرفة كما لو يقرؤون نظرية معرفية ما. لذا أنفر من الوضوح حين يتعلق الأمر بالشعر. كان أن مرت علي أيام ثلاثة ارتبطت بقصيدة1 للرومانسي الإنجليزي كوليردج، مبتدؤها باقتراح من والدي بالاطلاع عليها، ثم وجدتها تُذكر في كتاب2 يعني بالنقد الأدبي كنت أقرؤه حتى اطلعت عليها أخيراً في ثالث يوم، وكان أن ذكر الفرنسي ميشيل بوتور في كتابه كيف أن بعض القراء امتعضوا عندما أضيفت لاحقا حاشية للقصيدة حتى تُوضّّح مما يدل على تفضيل بعضنا لشيء من الغموض في عالم الشعر.
وعلى النقيض من قراءاتي الشعرية، تستهويني معرفة قصة ما وراء كواليس إنتاج نص أدبي. ما الذي دفع نصاً مسرحياً لأن يتشكل بهذا الجمال أو أن تروى رواية ما بتلك الوحشية. وكذلك الأمر مع اللوحات الفنية، والبورتريه خاصةً. بيدَّ أنَّه يبقى للمبهم قيمته. فبعض الكتب تتوقف في ثلثها الأخير، ولا يعدو موضوع إكمالها أكثر من عادة قرائية قديمة، تكون قد أخذت كفايتك منها أو وصلت إليك فكرتها أو أنك وجدت منها الإلهام الذي كنت تنشده، لكن الأمر مع كافكا يختلف. فما إن يكشف لك نهاية الحبكة منذ افتتاحية النوفيلا حتى تصبح أكثر تحمسا للمضي في القراءة. وقد يخطر ببالكم أني أعني قصة المسخ، غير أن الأمر يتكرر في كثير من قصصه الأخرى المنزوية بعيداً عن الأضواء. يتميز كافكا بإدراجه لشيء من الإبهام الذي يتخلل هذا الوضوح الجريء في افتتاحية القصص. إبهام يشجعني على المضي أبعد. هذه الفتاة التي تخشى التورط فيما يتبع خط البداية، تتخلى عن خوفها حين قراءة أعماله. لم يكن دافعي في قراءاتي الكافكاويّة واضحاً بادئ الأمر، وبعد مرور عقد من الزمان يخيل لي أني أدرك بعض الأسباب، هذا إن كان من داع لها في الأساس. أما الكيفية فقد كانت متقلبة بخصوص أدبه، وأبعد ما تكون عن الثبات. بداية كنت متأثرة بالرأي العام عن أن طبيعة كتاباته سوداوية، وأخطئ ظني لو رأيت غير ذلك. فمن أكون لأخالف الرأي العام! ثم تنفست قليلا مع قراءة دولوز وغوتاري لأعماله، ولم أعد أشعر بالتناقض، فتشجعت من بعدها على القراءة له بحميمية أكبر، فلست بحاجة للجوء إلى تفسير متفق عليه. وعلى كل أليست القراءة فعل ثوري يغربل النمطية في أطر التفكير؟ فكل ما هو مبهم يرتدي حُلَّة القصيّ متزينا بها. وإذا جمعنا في قراءتنا حَرفية كافكا وبيكيت مع شيء من رمزية المرآة في نصوص بورخيس فسنجد أن هذا التضاد يسقط عنا التعلم الزائف الذي لُقِّنَّا إياه منذ الصغر، ليبقي فقط على ما يوافق الذات الواعية. ساعدني كافكا بشخصياته على تقبل ما يستعصي على الوضوح في حياتي، وأن أتخلى عن هوسي ذاك في مقابل اعتناق المبهم.
وهكذا مع مرور القراءات والأصدقاء، لم يعد السؤال عما إذا قرأتَ لهذا المؤلف هو ما يهمني، بل امتد الأمر لمعرفة الدوافع الداخلية، ومحاولة رؤية هذه الاختلافات المبهجة ضمن هذا التآلف الواضح للعيان في اسم مؤلف أو شاعر ما، وأكاد أجزم أني أفهم أصدقائي أفضل بهذه الطريقة؛ في البحث عن المبهم في ما هو بيّن. لم يعد السؤال ماذا تقرأ إذن، وحتماً لم يتوقف عند لماذا تقرأ بل تعداه قليلاً إلى كيف. أول من كنت أطرح عليها هكذا أسئلة كانت ذاتي القلقة هذه، والتي لا ينتهي قلقها بانقضاء اختيار ما تود قراءته، بل يمتد أحياناً أثناء فعل القراءة، وينجح بدوره بأن ينتفي عن كونه “فعلا” ليصبح “وجودا قرائيا” إن جاز لي القول. ولذا لا أفهم كيف تكون القراءة محض هواية أو عادة يمارسها الشخص وقت الفراغ كما لو أنها شيء منفصل عن كيانه. فإن سألتك يوماً كيف تقرأ كافكا، فاعلم أننا غدونا أصدقاء حتماً.
في الأخير، حين تنزاح حبات الندى عن أوراق الشجر في الصباح، وتتكور على الحواف كما العبرات قبل رحيلها، وتسكن حبات الرمل عليها نافضة النضارة عنها في آخر اليوم، تتكاثر أسئلتي الصغيرة من حولي وأترك لها الدرب نحو باب الهاوية المطلة على الاحتمالات التي تضيق بي حتى أستحيل إلى نقطة مبهمة في آخر السطر، ولا سطر. ولا أتسع إلا في احتمال وحيد يجمعني بك. أترى كيف يكون انعدام الخيارات حرية حين أتخلى عن الإرادة الحرة للآخرين، وألتحف غموضك مكتفيةً بك؛ قدري الجميل.
- The Rhyme of the Ancient Mariner.
- بحوث في الرواية الجديدة. ميشال بوتور. ت. فريد أنطونيوس. وزارة الثقافة والرياضة- قطر 2019.
*
المحاسسة
في آخر زيارة لي للبحر، وقبل حلول حظر التجول، جلست امرأة بجانبي على مصطبة الشاطئ موليةً ظهرها للبحر في حين كنتُ أواجهه، وبدأت تعدّل من هندامها وخصل شعرها لتلتقط صورةً لها. عندئذ خطر لي كيف تبدو حياتي كتلك الفتاة التي تظهر في خلفية صورتها منكفئة على كتابها، غائصة فيه ومنعزلة عن المحيط حولها، سطحها كما الخليج العربي أمامها ساكن بلا درجة واضحة من الزرقة. منحني هذا الانسلاخ عن الذات لوهلة في الخيال إحساساً بالسكينة بعيداً.. بعيداً عن دعاء، وما يلحق ذلك من تعيينات لا حصر لها أو بكلمات أخرى، من هوية تشكلها.
يتكرر ذات الانسلاخ أعلاه عند كافكا، فتنتفي هويته المعيِّنة له، ولا أعد نفسي قرأت شيئاً في يومي إنْ لم أقرأ لكاتب آخر غير كافكا، بل يبدو أني لم أقرأ شيئاً يومها. ولا يعني ذلك أني أنتقص من قيمة القراءة له، وكيف لي، بيد أن القراءة له تنتمي لنشاط مغاير عن فعل القراءة كما يبدو الأمر لعقلي الباطن. والحقيقة أني لم أنتبه لهذا إلا مؤخراً، ومع انتهاء اليوم أفكر ماذا قرأت؟ وينفلت كافكا من حساباتي تماماً. ماذا يعني هذا، لم يكنْ كافكا خارج معيار القراءة، وإن كان له وجود عندي فأين هو إذًا؟ أيكون قد انتهى إلى التقمص في عبارته (Weg von hier).
وقد ظلت حقيقة أن يكون كافكا غير قابلٍ للقبض هو حاضر في حياتي بلا تبيان عدة سنوات حتى سنتين خلت، حين بدا أن التفسير الأنسب لحضوره متمثلاً في مفهوم بساط المحايثة1.1 الدولوزي (Plan d’immanence) فهو موجود على ذات الزمن حيث أنا موجودة جنبا إلى جنب وليس بطريقة تراكمية؛ أي أن رؤيتي لكتاباته تتطور وتتبدل مع تعرضي المتكرر له، ولا يسعني القول إنني انتهيت من قراءة أعماله الكاملة لأنه مستمر في الكتابة في الوقت نفسه الذي أحدثكم فيه الآن. عند قراءاتي لدولوز اكتشفت أن عادتي الموغلة في خصوصيتها مع كافكا لها مصطلح فلسفي -بِتُم تعرفونه من العنوان- وضعه الباريسيّ المولع بإعادة تعريف المفاهيم. ومع تحور سؤال الفلسفة الذي اتصل بدايةً بالما وراء من (كيف يجب على المرء أن يحيا؟) إلى (كيف يجب على المرء أن يتصرف؟) ببزوغ عصر التنوير، وتمحور الفنون والآداب حول الإنسان بعيداً عن المقدس، وظهور الفردانية. ثم طرحه بشكل مغاير في ما بعد الحداثة (كيف للمرء أن يحيا؟)، يضع دولوز الاختلاف في مقابل الهوية التي اعتمد عليها الفلاسفة على مر العصور ومنذ أفلاطون لمواءمة تصوراتهم الأنطولوجية مع ما اعتقدوه اكتشافاً للحقيقة، وليس عملية إبداع كما هي عند دولوز، وأعني بالأخص إبداع المفاهيم.
فبحسب برغسون فإن للماضي سيطرته، وضرورة لوجوديته لأجل تشكيل الحاضر، مما يتيح لك رؤية واقعك على أنه محض انعكاس لأفكارك التي خلت عمَّنْ تكون، مما يسمح لعامل التغيير للأفضل أن يأخذ حيزه في الحاضر. من هنا استقى دولوز فلسفته التي تحث على التوقف عن التفكير مكانياً (spatially) والتفكير بدلا عن ذلك زمانياً (temporally). زمن الآيون الذي يحويني آخذاً عني قلق الوجود خارج المكان. ومن ناحية موازية، لو أخدنا نظرية الزمن عند برغسون فإننا نحيا بعدد الكلمات التي نكتب، ونموت بالتي تكتبنا، فنبقى أبد الدهر صغاراً.
نجد شيئاً من مفهوم الزمن البرغسونيّ والمحايثة الدولوزيّة عند كافكا في محاولة أغامبين التفكيكية لعلم الجمال، فيذكر كيف أن استعصاء إيجاد معنى محدد في أعمال كافكا هي العبقرية التي وصل إليها فرانز بحسب تعبير بنيامين، ويرى أغامبين ذات الصعوبة بإيجاد معنى في أعمال كافكا، ورفضه الاستسلام لمعنى حاسم بقوله: “إنها له (كافكا) مواصلة الحركة التي بدأها بودلير: التضحية بنقل حزمة من المحتويات لصالح فعل النقل ذاته. ومن دون الأنساق الثقافية الثابتة للعصور الأقدم تحت تصرفه، وجد كافكا نفسه، متحرراً من عبء النقل الثقافي، منفتحاً على مغامرات من نوع جديد جذرياً. وهكذا، فإن مشكلة الإنسان الذي فقد القدرة على ملاءمة المكان الملموس لفعله ومعرفته، يمكن لأغامبين معالجتها واسترداد المكان من خلال قدرة الفن على تحويل اعتقال الإنسان بين الماضي والحاضر إلى مكان خاص يكون فيه قادراً على أخذ القيمة الأصلية لإقامته في الحاضر واستعادة معنى فعله في كل زمن من خلال السماح له أن يتصور مثل هذه العلاقة الجديدة مع التقاليد ومن خلال التشبث بالمكان الأصلي الذي يأخذ منه الإنسان قيمته ومقاسه.”2
وفي حديثه عن تصورنا للسعادة المتصل بالضرورة بمفهوم الخلاص، يرى بنيامين أن ذات الأمر يسري على الماضي، وتصير كل لحظة معاشة مُلزمة في يوم الحساب (citation à l’orde du jour3). تصبح الصيرورة إذًا حركة ترحّل دائب كما يقول دولوز عن الفن1.2. وخير من يجمع أنطولوجيا دولوز وجوتاري في الصيرورة هو تود ماي إذ يقترح أن هناك: “أنطولوجيا حيث ما هو هناك ليس ذات الأشياء المتعارف عليها، وإنما عملية من الإبداع المستمر، أنطولوجيا لا تسعى لحصر الوجود إلى ما هو معلوم، وبدلاً عن ذلك تسعى لفتح أفق التفكير حتى يجس نبض المجهول”.4 وهذه الصيرورة بما هي تحول مستمر على بساط المحايثة، تنفي مفهوم الهوية الثابت تماما، وتخلق نوعاً من القلق تعبيرًا عن الحرية عبر الإبداع الذي هو بدوره شكلٌ من التعبير. والتعبير (expression) بحسب دولوز هو الطريقة التي تشكل بها الكون. لذا يُوجد كافكا متصلاً بوجوديّ كرايزوم لا يتقيد بأصل معين وتوابع له. نتصل دون تصورات سابقة على بساط المحايثة. هذا المفهوم المناقض للتصنيف الصلد للعلوم التي هي مجال دراستي، والذي منحني متنفساً لكيفية رؤيتي للعمل الإبداعي، ولكيفية خوض تجربتي في الحياة. كما أن مفهوم الصيرورة المرتبط ببساط المحايثة نراه في أدب كافكا عند شخصياته المتحولة، والتي يصعب تحديد هوية لها، بل هي نفي للهوية، وربما هذا النفي هو ما يجعلني أتقبل التحولات الجسدية مع الأعراض الجانبية للعلاج، كما يمنحني شعوراً بالحميمية عند قراءة أعماله؛ أنني أنتمي لشيء ما في رواياته، ولست وحيدة كما أحسب.1.3
كان أن صادفني شيء من ذلك الشعور في مشهد بأحد أفلام المخرج السويديّ برغمان5. فقد ظلت أطراف معطف قريب الفتاة وهو يتمايل بظلاله على الجدار، يحتضن الفتاة وهي تخطو مبتعدة عنه كأنما تهرب من رعايته لها، تتخلى عن دورها ابنةً أخ، وتمضي إلى الحياة بدور جديد، تخلع عنها هويتها القديمة. وأجدني أميل إلى هذه النوعية من الأفلام الحوارية التي تكاد تخلو من الأحداث؛ فهي تريحني من عناء اللحاق بها في ترتيب كرونولوجي رتيب. أفلت من قبضة سريان الزمن الخطي في شريط بكرة الفيلم، وأعود لحيث تكمن الهيولى في بساط دولوز.
وبالمثل تجد من يحرص على أن تكون لممتلكاتهم لمسات شخصية، بوضع صورة شخصية لهم أو لمعارفهم على خلفية شاشة الهاتف أو المحمول، يبالغون بتزيين أثاث غرفهم وسياراتهم بما به من طابع يخصهم، في حين لا أملك ذات الإصرار، وذلك لحاجتي إلى مسافات من اللا انتماء لكثرة ما اعتدت على الغربة، بتُّ أتجنب الحميمية الزائدة التي يوليها الآخرون لأغراضهم. شيء ما يشدني إلى ما قبل لحظة التحول، نحو المادة الخام قبل التشكل الأول وتعيين هوية ما، إلى الوجودية قبل لحظة التحرر وما يرافقها من مسئولية.
تتمايع كلمات كافكا في صيرورتها أمامي فتطفو محيلةً الصفحة إلى بساط محايث ثم تنسحب خارجة من كتاب له تحتضنه يداي، صاعدةً لأعلى الغرفة، وتنتابني حكة حول عنقي. أقوم على الفراش متقدمة بوجهي، محاولة اللحاق بالكلمات التي بدأت في التحلق حول بعضها وهي تشكل فراغاً في المنتصف. تتقعر الحروف منكمشة على بعضها، وأجاهد لأتم الجملة الأولى غير أن الجو يبعث على الاختناق، وقدماي تنزاح عن حافة الفراش لتسقط مقدار شبر لأعلى.
* مفردة ابتدعها عبده مهدي تجمع بين مفهوم المحايثة الدولوزي والحدس.
- فلسفة جيل دولوز عن الوجود والاختلاف. عادل حدجامي. دار توبقال للنشر. الطبعة الأولى: الدار البيضاء 2012. ص147، ص166، ص186.
- الإنسان بلا محتوى: مأزق الفنان الذي يقف مشدوهاً أمام البياض المرعب للصفحة الفارغة. أماني أبو رحمة. مجلة الفيصل، عدد يناير 2019. ص9
- Illuminations: Essays and Reflections. Walter Benjamin. Translated by Harry Zohn. Thesis on the philosophy of history. P. 246.
- Gilles Deleuze: An Introduction. May, T. (2005). Cambridge, UK: Cambridge University Press. (p. 171).
- Summer Interlude 1951. Ingmar Bergman. AB Svensk Filmindustri.
*
أصوات السرد
حين لا ينصح المؤلفون بأن يبتدئ، مَنْ يرى الكتابة حرفةً وتطبيقاً للتمارين، قصته بمشهد استيقاظ البطل من نومه، فإنه لا ضير بظني أن أرتكب هذا الخطأ بمقدمة مقال. وإذ لا تزال يغشى عيني بيت قصيدة علق في آخر الحلم كقط لحوح يوقظني بشقاوة موراكاميّة من منامي، فتحت جوالي وأنا أفرك عيني، وكتبت البيت كما يتردد على بالي في محرك البحث (Strange fits of passion have I known)، وكانت النتيجة أنه مفتتح قصيدة لوليم وردزورث. فصرت أعود بذاكرتي لآخر مرة قرأت له شيئاً من ديوانه الذي بمكتبة والدي ولم أصل لتاريخ. أزحت اللحاف الذي ازدادت طياته مع الأبيات المثقلة بحزنها من القصيدة جانباً، أخذت مشطي وسرحت بعض الكلمات المتشابكة بين خصلات شعري المنتفش بسببها، وانسلت حروف من القصيدة حين تثاءبتُ إلى كياني وسكنتني يومًا كاملا. كنت مع قراءتي لقصائده الرومانسية أتخيلني أصغر عمراً، فسرده للقصص في أشعاره يمتزج برائحة أزهار النرجس البري، وجرس موسيقي بهيج، وحنينه دوماً للجبل المغطى بالبياض.
مؤخراً، أسرني الصوت السردي مع النجوم النيرة للأمريكي توماس وولف والتي ذكرتني بنجمة كيتس اليتيمة تلك، ولم يعد بمستطاعي المضي أبعد من ذلك. علماً أنها بادئة الجزء الأول من الرواية، أي أنني ما زلت عند عتبة الفصل الأول حيث لم يستوقفني مؤلف في هذا المكان قبلاً. يقال إن الانطباع الأول- والذي يحمل رمزية الصدى بنظري لتردده في اللقاءات التالية- يكون في الثواني العشر الأولى عند التقاء أحدهم. بيد أن الأمر مع وولف خارج هذه القاعدة. فها أنا أتورط في هذا السرد الشعري قبل أن أعرف إنْ كان يعود للراوي العليم (Omniscient narrator) أم هو للشخصية المحورية! وإليكم النص الذي أعنيه: “حصاة، ورقة شجر، باب ضائع لحصاة، ورقة شجر، باب. ولكل الوجوه المنسية. عراة ووحيدون جئنا إلى المنفى. في رحمها المظلم لم نكن لنعرف وجه أمنا؛ أتينا من سجن جسدها نحو سجن هذي الأرض العصي عن القول والتواصل. أي منا عرف أخاه؟ أي منا نظر إلى قلب أبيه؟ أي منا لم يبق أبداً حبيس سجنه. أي منا ليس بغريب ووحيد أبداً؟
يا للضياع المجدب، في المتاهات الحارة، ضائع بين النجوم النيرة على هذا الرماد السخام عاصف الإرهاق، ضائع! نتذكر في صمت كم نسعى للغة المنسية العظيمة، نهاية الممر الضائعة إلى الفردوس، حصاة، ورقة شجر، باب ضال.
أين؟ ومتى؟
يا للضياع، وباسم الريح الحزينة فلتعد أيها الطيف من جديد”.1
هي الأصوات السردية إذن، الأصوات وصداها الممتد الحافر فيَّ عميقاً ذلك أن للصدى رجع. وهذا التكرار الدولوزيّ يغلف يومي الرتيب بالعود الأبدي للزمان الكبير حيث للأسطورة معنى الجبل؛ كل هذه العزلة التي أحملها. عبء حمل التصخر الميدوسيّ الذي يخيل لي أنه يحن لإعادة الجمال العذري للساحة، وإلى الحب القديم كما يستدعي دانتي توقه إلى حبيبته Donna Petra دون ذكر اسمها صريحاً في جحيمه. كيف للعزلة، وهي عزلة أن تربط بين اليومي والأسطورة، هذا التناقض الصارخ لمعنى الزمن، التصخر الميدوسيّ والديمومة إذًا. ويا للعجب، أليس هذا ما يفعله الصوت السردي! فوفقَ البؤرة التي منها ينطلق الصوت السردي، وما إن كانت داخلية أو خارجية، مرتبطة بشخصية أو لا كيان يحويها، فإنها ستمنح النص معنىً يخص زاويتها. فلتتخيل نصك المفضل، نثرياً كان أو شعرياً وغير صوته ثم انظر بم تخرج. كرر التجربة بعدها مع نص لا تطيقه، وتأمل الجمال الذي صنعته بتغييرك لعنصر الصوت السردي وحده. ورغم أن الحديث هنا عن أصوات السرد إلا أن طريقة كيتس في ترتيب التراكيب اللغوية لأبياته من مثل ملحمته الشعرية (Endymion) خلقت له صوتاً موسيقياً مغايراً في الشعر الإنجليزيّ الرومانسيّ، مما يصعب تخطي ذكراها، ويشد انتباه حتى من هو غير معتاد على السردية الانجليزية القديمة.
ماذا عنكم، أي صوت سردي يحث على إخراج صوتكم حين الكتابة؟ في نظري بِتُّ حين أعود لإحدى قصائد شاعر سودانيّ معاصر، أسمعها بصوته وحين أرفع صوتي في الإلقاء خشية أن ينزلق الشوق مني على الصفحات، فاضحاً لي ومبللاً الأبيات، أجدني سرعان ما أستسلم دون انشغال بال باختفاء صوتي، عساه أين ذهب، تاركة له فرصة إكمالها نيابة عني وأنا أصغي إليه.
وحين يرى أحد الدارسين لمؤلفات كافكا أن صوته السردي معني بالذات2 فإن غيره3 يرى بعكس ذلك تماما، ففي نظرهم يرون صوته السردي معقداً ومتعدد الأبعاد. وكيف أن سرده المتضمن يختلف عن غيره من المؤلفين في كونه قادر على جعل مختلف الأصوات السردية تصطف بجانب بعضها بعضاً في كتاباته؛ فشخصية ثانوية قد تكون رمزاً لقصة بطل الرواية كما يرى جيرهارد كورتز. أما أنا فأرى أنَّ الصوت السردي لكافكا يبعث على الاطمئنان. حين أكون مشغولة بيومي، وفي محاولة دائمة للانخراط أكثر في الواقع محاولة الإحساس بكياني الهلامي، أفتح صفحة عشوائية، ودائما كان الأمر كذلك مع كتاباته، لأجده يهمس لي حيث تقع عيناي على كلماته بأنه هنا معي، يشهد وجودي، ولا يبتغي من وراء الإنصات إلى قصصه ورواياته سوى أن أنصت لصوتي الداخلي كما لو يحول الصفحة -وهو المولع بلعبة التحولات- إلى رقعة أحجية مشجعاً لي، هي ذي كلماتي مبعثرة وعصية، لكِ حرية ترتيبها بصورة نهائية تناسبك، وأنا على استحياء أخفي ابتسامتي باديةً القراءة من المنتصف لآخر الفقرة، ثم أختم بأول جملة، وأكتشف بعداً آخر قريب لعملية سرده، وبعيدًا عن طلاب الأدب المعنيين به، وعن أعين القراء الآخرين. تدور بي أصوات السرد كما دوائر دانتي وهو يخوض رفقة روح فرجيل في الجحيم خارجاً من دائرة داخلاً التي تليها في تكرار دولوزيّ لا يُمل. أحاول إرجاء لعبة تبديل الأصوات، والتركيز مع وجهة النظر المعطاة لحين إنهاء النص المنبسط أمامي. ختاماً، أترككم هنا، وأذهب إلى وولف يسرد لي عن أمريكيته، والأمريكا في داخل كل منا، وإن لم تكن لي أرض بالمعنى الذي يقصده بروايته. عساه يكون انتماءً للضياع الشعري عند توماس، فربما لا يستهويني غير اتباع خيل الشعر، خيل بيجاسوس.
1-Look homeward, Angel. Thomas Wolfe. The Windmill Press, Kingswood, Surrey 1930.
2-Friedrich Beißner. Der Erzähler Franz Kafka.1952.
3-Matthew Powell. Review of Lothe, Jakob; Sandberg, Beatrice; Speirs, Ronald, eds. Franz Kafka:Narration, Rhetoric, and Reading. H-Judaic, H-Net Reviews. October, 2011.



