كافكا الذي أعرف 3
تكيّة المفردات
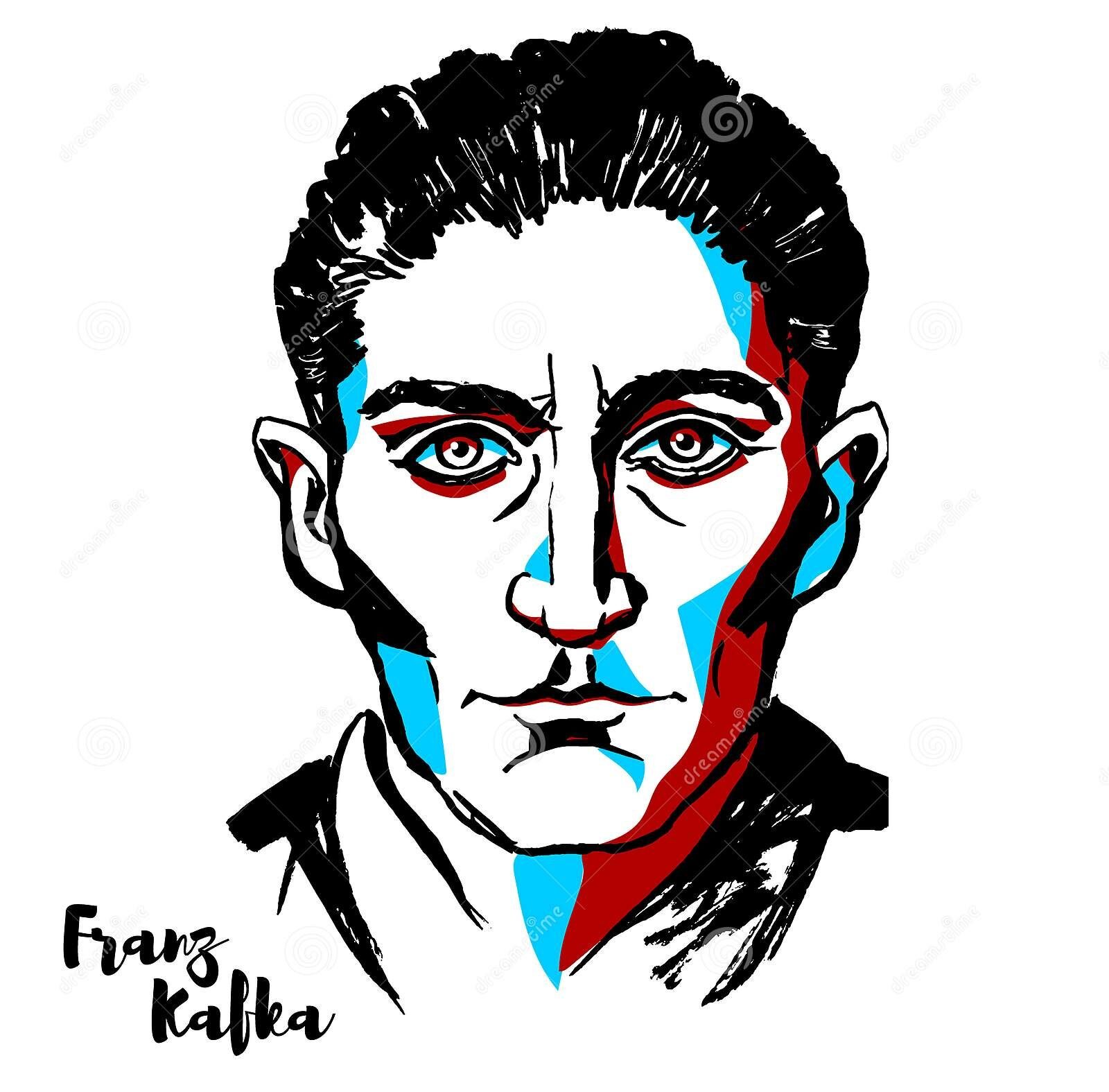
دعاء خليفة
أنا الفتاة التي تخترع مصطلحاً لا ينطبق إلا عليه، الفتاة التي لا ترى لغةً إلا وكانت تخاطبه. تحمل عبء إزالة الكلمات الزائدة عن حاجته من قواميس العالم الثخينة، لكن الكلمات لا تزول لحاجة الآخرين إليها. تلتصق بي فور خروجها من الصفحات الصفراء الباهتة، وهي تنفض غبارها على شعري، تنام بين تموجاته حتى لا يعود بائناً. أنا الفتاة التي لها شعر من الكلمات الفائضة عن حاجتنا، لكنها تواصل حملها، ربما يحتاج وحيدها يوماً إلى كلمة هناك، في تلك التموجات الليلية تعينه على مراسلتها، وحينها ستشعر حتماً بيده تمسد على شعرها، ويصبح للعالم معنى. توجد من المفردات التي تلتصق بمؤلفيها، تلوّن صفحاتهم حين تبهت، ترافق مسيرهم الليلي الطويل على منعرجات الصفحات المطوية والأقصوصات، وترسم حِسّاً بالأمان في قلوب القراء مع اقتنائها كتباً ودواوين في الأخير. تفرض سيطرتها على الكاتب فلا يعود يراها محضَ أداة مثل غيرها من تراكيب اللغة بل تصبح مثل عصاه، تتكئ نصوصه عليها.
حين يأتي ذكر الشاعر سيد كورمان تتبادر إلى الذهن مباشرة مفردة (Here) كما في قصيدته1: “أِشعر بذاتي هنا” فنرى كورمان يركز على ثيمة المكان، في حين لا توجد مفردة (هنا) عند كافكا. والذي نراه في قصته2.1 بعد أن تشارف على الدخول في الصفحة الثالثة من وصفه لمنزل الشخصية الرئيسة، يورد هذا الكلام: “ليس من طائل هنا لمواساة ذاتك بفكرة أنك بمنزلك، بل تبدو كما لو تقطن بعيداً في منزلهم.”
وكي لا نبتعد عن مفردات التعيين، لنذكر مفردة إميلي ديكنسون (This) كما في قصيدتها3:
“أما لمهنةٍ- فهذه-“
في الوقت الذي تنشغل مفردة إيميلي الرائجة على الكينونة التي تقف في المكان فإنه يصعب عليك أن تحدد ما يود كافكا الإشارة إليه، فما أن تنبسطَ سبابتك لتشير إلى مقصده في هذه القصة أو تلك الرواية، يتجمد إصبعك في الهواء كتلميحٍ ضال، فلا تحديد عند كافكا. وحتى لا ينزعج مني من هو ويتمانيّ الهوى، فحبي للاتجاه الديكنسنيّ في الشعر الأمريكي المعاصر لن يجعلني أغفل عن إيراد مثال لوالت يظهر فيه حبه المفرط للتعيين. فها هو في قصيدة واحدة4 يكرر مفردة (Now) التي تعكس اندفاعه في الحياة، وتقديره للحظة الحاضرة كما عودنا، ثلاث مرات دون إخلال بالوزن الشعري:
“ها أنا مليء بالحياة الآن، مكتنز ومرئي،
….
والآن، أنت المكتنز، المرئي، تلفت قصائدي انتباهك، تبحث عني؛
….
لا ضير في كونك غير واثق غير أني الآن معك”.
في حين نجد كافكا في المقابل ينفي الزمن الحاضر باستمرار. فتمتد أزمانه بعيداً عن الآن. فهو في حكايته الرمزية2.2 يحكي عن طريق العبور الذي على رسول الرسالة الشفهية عبوره في تسلسل متناغم حتى نصل فجأة إلى فقرة تختم أمر مسيره: “وهكذا لآلاف السنين”. كذلك في قصة السور العظيم2.3، وبعد تهيئتنا بشأن عملية البناء، وانتقال الرجال من منازلهم بأعداد كبيرة، يبدأ كافكا فقرة جديدة ذاكراً أن: “لم يكن العمل ليُأخذ دون حسبان. فقد استغرق الأمر خمسين سنة قبل وضع أول حجر”.
وها أنا ذا أنتبه متأخرةً أن قراءاتي للشعر الأمريكي المعاصر في سنوات مراهقتي الأولى كانت في جوهرها تناقض رغبتي في الابتعاد عن التحديد، والتعيين الزمكاني، ولهذا ربما في آخر سنين مراهقتي، ومع اكتشافي لكافكا المناقض لهم من هذه النواحي، وجدت نوعاً من الانتماء الذي كنت أنشده طوال هذا العقد الغاضب من حياتي. انتماء قصيّ عن كل ما يحيط بي، ينفيني عن طفولتي الوادعة، ويقذفني في العالم، مخلفاً لي غربةً إثر غربة. ماذا لو نترك الشعر يرتاح قليلاً، وتدعوني أعرج على السرد النثري، لأقف عند ثلاثة روائيين أمريكيين جمع بينهم محرر واحد، وكان لاثنين منهما الحصة الأكبر من قراءاتي النثرية أيام المراهقة كذلك. ولنبدأ بهذا المقطع لفيتزجرالد من روايته الأولى5: “أود إحضار سمكة سردين إلى الحفل الراقص في يونيو”. ربما حزرت المفردة التي قصدتها. نعم، السردين، فهو ما يذكرني به، ليس لأني أحب تناوله؛ فما زلت لا أستلطف اللحوميات بل لأن معناها هو الصبيَّة، وأنا مولعة بشاعرية فرانسيس هذه منذ عمر الحادية عشرة. ولا بد مع فيتزجرالد أن نأتي على ذكر غريمه وصديقه بذات الوقت إرنست هيمنجواي، الذي على الرغم من استخدامه المفرط للأفعال- وبظني يعكس الكثير عن شخصيته الصبيانية المغامرة- فإن المفردة التي علقت ببالي له هي (الأوراق)، وأقصد بها أوراق الشجر التي ذكرها في بداية روايته6 عن الحرب العالمية الثانية تلميحًا خفيًا عن مصير شخصية كاثرين باركلي، حبيبة البطل في نهاية الرواية برحيلها المبكر مع بداية علاقتهما العاطفية: “كانت جذوع الأشجار كذلك متربة وتساقطت أوراق الشجر مبكراً ذلك العام وشاهدنا الجنود سائرين على جانب الطريق والغبار ينتفض عالياً، والأوراق في ارتعاشة النسيم تتساقط، والجنود سائرون إلى الأمام، ومن ثَمَّ صار الطريق جله أعزل وأبيض باستثناء الأوراق الخضراء”. دائما ما ارتبطت عندي أوراق الشجر بهيمنجواي أين ما رأيتها أو جاء ذكرها في نص أو لوحة فنية ما.
أما ثالثهم، فهو المؤلف توماس وولف، ويبدو أنَّ المفردة التي يحرزها كل من قرأ له هي (النهر). يأتي على ذكرها في روايته7 بنثره الشعري: “والنهر، الثعبان الأصفر الذي يعب شراباً، الزاحف بطيئاً والمستنفذ لمياه القارة. كانت حياته شبيهة بذلك النهر الغني برواسبه وتغريته المتقادمة، خصب بتراكماته المترسبة، مفعماً بالحياة ليزداد غنى، وهذه الحياة، مع غاية النهر الأسمى قد أفرغها الآن في ميناء منزله، فردوس ذاته، والتي التفت الكرمات المغضنة حوله ثلاثاً، ونمت الأرض بوافر من الفاكهة وأزهرت، وأضرمت نار الحياة بجنون”. ثم نراه يتحدث في الفيلم8.1 عن إحدى معاني النهر المرتبطة بذكرى بعيدة له تتعلق بوالده: “قادني ذلك القطار إلى حياتي عبر التلال وفوق ضفاف الأنهار، ودائما ما كانت الأنهار. أحياناً تفيض الأنهار بعيداً عن أبي، وفي أحيان أخرى تسيل عائدة إلى عتبة بابه”, في حين تقف كلمة والت على الزمان، تذهب كلمة توماس إلى سريان الزمن. ويصبح هذا السريان عند كافكا غير منطقي بتمدد زمنَ بناء سور الصين العظيم مثلا أو تحيّن وقت محاكمته في رواية القضية أو انتظاره لأوامر العمل الذي استُدعي لأجله في رواية القلعة. وفي أحيان أخرى ينتفي معنى الزمن في قصصه القصيرة ليشير إلى زمان خارج أبعاد عالمنا الفيزيائي حيث لا يصير للزمن معنى الصيرورة كما اعتدناه.
أما محرر هؤلاء المؤلفين، ماكس بيركنز، لم يفته في وقت الشدة ملاحظة مفردة قد تعجب توماس كما جاء في مشهد الفيلم8.2 بالنهاية، فنسمعه يهاتف زوجته من المستشفى ليعلمها: “قال الجراح إنَّ دماغه مليء بالأورام، عدد وافر من الأورام. هذه المفردة التي استخدمها، عدد وافر. كان توم ليعجب بذلك. ليس بوسعهم فعل شيء، كما ترين.” ثم يمضي في الحديث عنها ذاكرا الجمع من هذه المفردة، لا معلومة لغوية وإنما طريقة يواسي بها ذاته، كما لو نمضي في الحوار مع أحدهم بزوائد خلوية حتى لا ينكشف أمر حزننا أو ارتباكنا أمامه.
يقول تشومسكي في محاضرة9 له عن اللغة والفلسفة، ضمن سلسلة محاضرات العميد الإنسانية في جامعة ماريلاند، إنَّ اللغة الناطقة لا تؤدي غرض التواصل المرجو منها، فإنَّ كافكا يذهب أبعد من ذلك في الكتابة. نجد في ورقة أدبية10.1 عن لغة كافكا تشرح غياب معنى التواصل تحت مصطلح اللغة المتلعثمة: “اللغة المتلعثمة تتطور إلى لحظة مستقلة بذاتها، والتي لا تخدم أداةً للتواصل. وإنما تُحوَّل إلى تعبيرٍ صاف، عنصر حيوي يخلُّ بكلا النظامين اللغوي وغير اللغوي”. ثم تأتي الورقة الأدبية على ذكر ما يراه دولوز10.2 خصلةً حميدة في كتابة كافكا النافرة من رغبة التواصل المعتادة: “الاشتغال على اللغة من كاتبِ أقلية لا ينحصر فقط ضمن الميزة السياسية، وإنما يتضمن كذلك موقفاً قوياً يتعلق بميزة الإبداع، كما تتحول المادة الاعتيادية للغة إلى مجال جديد كلياً ومفتوح جذريًا على الاحتمالات. يعلق دولوز على المشكلة في مقاله “لقد تلعثم”، مواجهاً نموذج الشجرة للنظام الجامد في مقابل نموذج الجذمور للشكل الحيوي: التلعثم الإبداعي هو ما يجعل اللغة تنمو من المنتصف، كالأعشاب؛ وهو ما يجعل اللغة كالجذمور بدلا عن كونها شجرة، ما يضع اللغة في توازن مختل دائمًا. أن تكون متحدثاً جيداً لم يكن يوماً الملمح المميز أو هم الكتاب العظماء. حقيقة أن شيئاً ما بإمكانه أن “يقال بنحوٍ سيئ” هو إشارة إلى إمكانية قوة اللغة. هذا النوع من الإمكانية يشمل كذلك للمفارقة استطاعة ذهاب اللغة لمدى أبعد من قواعدها ومساءلة شخصيتها الذاتية- أن “تقال بنحوٍ سيئ”. على المرء أن يتذكر أنَّ فعل التلعثم لا يتضمن مجرد أصوات معادة أو ممتدة على نحو أخرق، ولكن كذلك على وقفات عرضية تخل بنحوٍ ملحوظ بانسيابية الحديث. وما يجعل اللعثمة عصية على الفهم ليس فقط تراكم الأصوات غير الضرورية، ولكن كذلك اللحظات العشوائية من الصمت التي تنزع إلى تفكيك الشكل الكلي للنطق. إنَّ الاشتغال بالصمت فعلُ تلعثم منافٍ لفعل التواصل والمحتوى الذي تحاول إيصاله، وتتجه ناحية أسلوب من التعبير الصافي”.
كذلك نجد عند بلانشو، والمهتم أيضاً بكتابات كافكا، شذرات11 تصف ما أود إيصاله بصورة بلاغية يمتاز بها: “الإحجام عن الكتابة- ما أشقَّ بلوغَه، وهذا غير مأمون أبداً، فلا هي بالجزاء ولا بالعقاب، وإنما يجب ممارسة الكتابة ضمن الارتياب والضرورة. والإحجام عن الكتابة هو أثر الكتابة؛ كأنه سمة الاستكانة ومنبع الشقاء. كم من جهود بذلتُ للإحجام عن الكتابة، كي لا أكتب وأنا في خضم الكتابة، وأخيراً أقلع عن الكتابة في آخر لحظات التنازل، ليس يأساً بل لانعدام ما قد أتطلع إليه: تلك هي مِنَّة الفاجعة. رغبة غير مشبعة ودون إشباع، وبدون سالب رغم ذلك. ما من نفي في “عدم الكتابة”، وتلك هي الشدة التي لا تحكُّم فيها ولا سيادة، وهي هاجس الاستكانة البالغة”. ثم يتبع هذه الشذرة بأخرى في الصفحة التي تليها: “لتكف الكلمات عن أن تكون أسلحةً، وسائل عمل، وإمكانيات لتحقيق الخلاص. ولترتكن إلى الفوضى”. ثم يربط بعدها الكتابة بالاستكانة: “إنْ كان بين الكتابة والاستكانة من صلة، فذاك راجع إلى أنهما تفترضان المحو وإنهاك الذات: تفترضان تغييراً للزمن: تفترضان أن بين الوجود وعدم الوجود شيئاً لا يتحقق، ومع ذلك يحدث، كأنه حدث من قبل- إنه التعطيل الذي يقوم به المحايد، والخرق الصامت الذي يضطلع به الشذريُّ”.
هكذا، فإنه لا شيء خلف كلمات كافكا أو رغبة حميّة في التواصل كما توهمنا بها اللغة، ففي نظره ليست الكتابة إلا نوعاً من المحو أو لأقل العماء اللذيذ. ينفد صبركم بوصولكم إلى هنا، وفي بالكم السؤال المتوقع، ما المفردة المحببة لدي عند كافكا؟ وفي حقيقة الأمر، وكما هو الأمر مع فرانز دوماً، فما زلت أبحر في لغته المتلعثمة، لغة الأقلية، ولم أرسُ بعد على مفردة معينة، وأخشى أني تعودت على رقعة البحر هذه دون مرأى لجزيرة أو شاطئ على مدى البصر.
ماذا عنكم، أي مفردة هي المفضلة لديكم عند كاتب ما، وأي أثر تتركه مثل هذه المفردات على أرواحكم. ماذا وجدتم حين الذهاب إلى ما ورائها، وهل انتبهتم إلى وزن الكلمات في حيواتكم، وكيف كانت لتكون الحياة دونها. هل بإمكان الحياة أن تكون دونها!
أما عن مفردات الأصدقاء ذات الطابع الكافكاوي، فلن يسعني المقال لذكرها جميعاً، ولكن لأشارككم دهشتي في اكتشاف من أين أتى صديقي بتعبيره الساخر (بلا شك) وأنا أقرأ رولان بارت! نعم، بارت الفيلسوف السيميوطيقي الرقيق الذي تتخلل تصريحاته في النقد الأدبي نوعاً من التردد المغالي في تواضعه، والبعيد، البعيد عن التهكم الكافكاوي النزعة. في أي حال، فإنَّ صديقي يغالي في استخدام المصطلح طريقةً للتملص من محاوره، وإقحام رأيه المخالف بالمقابل ليس تلبية لما يتطلبه الموضوع محور الحديث بالضرورة أو سخياً بفرضها في أحيان أخرى للتخفيف عن حيرة صديق له، فلا أملك حيال مبالغته هذه إلا الابتسام. هذه الحميمية في معرفة مفردات معارفنا، تمنح الصداقة بعداً أجمل وتخلق من اصطفافاتها فقرات سردية توازي قصص اجتماعاتنا في أرض الواقع.
حين تغفو الكتب بين يدي، وأخطو بعيداً عن غرفتي، فإني أتأملُ الكلمات على الأشجار تمتد على طول الطريق في صف منتظم، وهي إذ تجاري الإنسان في استقامة يدَّعيها، توزِّع أغصانها باتجاهات فرعية لا تنتظم نحو الشمال، وأرى أوراقها تنبسط بانزلاقة في أولها مثل راءٍ، في حين تحتشد أوراق أخرى بجانب بعضها حتى تتفرع واحدة منهن كألف، وأخرى متكوَّرة تحمل نقطة من شعاع الشمس داخلها مثل نون. أتأملُ الكلمات على الأشجار من نافذة السيارة في حين يتأملُّها الآخرون في لافتات الطرق والمحال ليصلوا إلى وجهتهم، ولا أصل. تأخذني الأوراق إلى عوالمها. ربما ضلت كلمة ما طريقا في الغصن المنزوي هناك وهي تبحث عن شاعرها، وأخرى حسمت أمر ضياعها من روائي يحتاج إليها فسقطت مع أول الخريف. وذبلت تلك حتى شحب لونها لتنحية مسرحي لها خارج الخشبة. وأفكر، يوماً ما سأجد كلمة لي في شجرة.. وأكتبها.
- It isn’t for want poem. Cid Corman.
- The complete short stories. Franz Kafka. Vintage 2005.
2.1 The Burrow, P. 350
2.2 An Imperial Message, P. 5
2.3 The great wall of China, P. 254
- I dwell in Possibility . Emily Dickinson.
- Full of Life, Now poem. Walt Whitman.
- This Side of Paradise. F. Scott Fitzgerald. Scribner 1998. P. 35
- Farewell to Arms. Ernest Hemingway. Charles Scribner’s sons 1929. P. 3.
- Look Homeward, Angel. Thomas Wolfe. The Windmill Press, Kingswood, Surrey 1930. P. 45.
- Genius Film. Directed by Michael Grandage. 2016.
8.1.
8.2.
- Humanities Dean’s Lecture Series. The Department of Linguistics at the University of Maryland.
- Lingual Asthma: Stuttering of Language in Franz Kafka’s Writings. KATARZYNA CHRUSZCZEWSKA, University of Warsaw. Planeta Literatur. Journal Of Global Literary Studies 3/2014.
10.1. P. 64
10.2. P. 66
- كتابة الفاجعة. موريس بلانشو. ترجمة عز الدين الشنتوف. دار توبقال للنشر 2018. ص60، 61، 64



