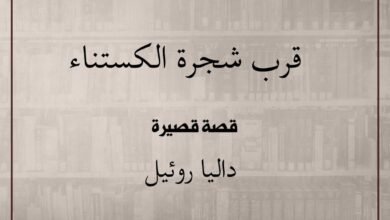حارة العجائز
قصة قصيرة

أمسِ وفي أثناء طريق عودتي إلى المنزل قصدت أن أسلك طريقاً غير الطريق المختصرة التي اعتدت أن أسلكها. بالطبع ستستغرق مني هذه الطريق وقتاً أطول للوصول إلى المنزل، ولكنني كنت أنوي أن أعرج على حينا القديم فقد مضى وقت طويل منذ آخر مرة زرتها فيه، وأنا معتاد على زيارته بين الفينة والأخرى عندما باغتني الشعور بالحنين إلى طفولتي ومراتع صباي. فبطبعي أنا امرؤ كثير التفجع على الماضي والحنين إليه، وقد حاولت جاهداً التخفيف من حدة هذا الطبع الشقي لكنني كنت أفشل دائماً، حتى انتهيت موقناً بأنَّ في المرء طبائع لصيقة ترافقه حتى مماته، ولا سبيل إلى تغييرها مهما فعل، إنها جزء من أناه، من كيانه الذي يُعرف به. سلكت بعضاً من الطرق الملتوية المؤدية إلى الحي، وانتقلت من زقاق ضيق بدا معظمه مألوفا لي على الرغم مما استحدث فيه من بنايات ذات طوابق مرتفعة تحجب تيارات الهواء المتدفقة، وتجعل ذلك الزقاق يبدو أكثر ضيقاً وظلمة. المزيد والمزيد من البنايات الملتصقة ببعضها، والهواء لا ينفك يزداد اختناقاً ورطوبة في هذه المدينة الحارة.
ها قد وصلت أخيراً. أمام ناظريّ يمتد زقاق لا يتجاوز عرضه أربعة أمتار وقد رُصف ببلاط حجري رمادي اللون. كان الوقت نهارا والسماء مزرقة وصافية، وأشعة الشمس الحارقة قد انسكبت بعنف على جدران البيوت والطرقات المرصوفة، وعلى قمم الأشجار القليلة المتناثرة هنا وهناك. لم تكن ثمة أشجار كثيرة، فقد زحفت المساكن البشرية على كل شيء، ولم تترك موطئاً تُغرس فيه حتى شجرة واحدة. (ليس هذا من قبيل المبالغة). وعلى جانبي الزقاق تظهر المنازل الأسمنتية المتهالكة بارتفاعات متفاوتة، ها هنا منزل بأربعة طوابق، وبجانبه آخر بثلاثة طوابق وآخر بطابقين، وكلٌ ارتفع منزله بالقدر الذي أنعم الله به عليه من المال. في نهاية الزقاق يقع مسجد الحي بمئذنته الدائرية وقد دهنت واجهاته من أسفل باللون الأخضر، ودهن الجزء العلوي منها باللون الأبيض. تنتصب أمام المسجد شامخة شجرة اللوز الهندي، شجرة عجوز ضخمة تتكئ بأفنانها المخضرة على جدران المسجد، وقد بقيت عجوزا كما عرفتها أول مرة منذ عشرين سنة، كأنما هي تعيش عمرنا الإنساني مضاعفاً مئات المرات. حين كانت تنتشر فروعها اللا نهائية وتلتف متشابكة لا تعود تقوى الشجرة العجوز على حملها فتلقي بها منهكة أرضاً، واذ ذاك تمتد يد الإنسان الغاشمة، فيهب رجال الحي متعاونين لقطعها، ويتجلى ذلك المشهد المؤلم لي -أنا الذي أحببتها بعمق ولعبت نهارات عديدة تحت ظلها الحنون- جذعا باسقا ضخما عاريا من فروعه المورقة الملقاة بجانبه كجثة هامدة. لم يكن ألمي يدوم طويلاً، إذ سرعان ما كانت الفروع تنمو من جديد مرة أخرى.
أذكر شيئا مضحكاً يتفق مع ذكري لشجرتنا العجوز، حين كنا نسكن هنا كانت والدتي تسمي هذا الحي -متندرة- باسم حارة العجائز، وذلك لأن معظم ساكنيه صادف أنهم كانوا من العجائز والشيوخ، وقلما وجد الشباب فيه والأسباب وراء ذلك مجهولة! أقول الأسباب مجهولة لأننا جئنا لنسكن هنا فجأة بعد أن غادرت جدتي منزلها، وسافرت لتكمل ما تبقى من حياتها عند أحد أبنائها خارج البلاد، وقد تركت لنا هذا المنزل لنقطن فيه -كنا وقتها بلا منزل نتملكه- ونحميه من يد الزمان التي تُبلي كل ما تأتي عليه، ومن يد اللصوص أيضاً.
أما إذا أردتم التعرف إلى أولئك العجائز والشيوخ الأفاضل، والذين قضوا نحبهم جميعاً منذ ست سنوات من وقت زيارتي البارحة، فهأنذا ماضٍ لإرضاء فضولكم وسأقص عليكم جزءاً يسيرا مما عرفته عنهم محاولا الاختصار قدر ما أمكنني ذلك.
تقدمت بضع خطوات نحو أول منزل في الحي. ها هو ذا منزل الحاج قاسم يظهر بطوبه الأسمنتي منفراً وعارياً من أي كساء يجمل مظهره. يتكون المنزل من ثلاثة طوابق، كان الطابق الثالث قد استحدث بعد وفاة الحاج قاسم بست سنوات. كان الباب موارباً ومن شق صغير تستطيع أن ترى فناء المنزل يغصُّ بخردوات وأثاث قديم ومهترئ. حين جئت وعائلتي أول مرة إلى هنا كان الحاج قاسم مستقراً في بيته مع زوجتيه وأبنائه الخمسة. وحسب أقوال جدتي وحكاياها فإن الحاج قاسم كان يعيش خارج البلاد قبل أن يسكن هنا، وقد جمع ما استطاع جمعه من أموال وابتنى له هذا البيت الذي أصبح أشبه بالخردة الآن، ثم تزوج بعد ذلك بامرأة جاء بها من قريته، وهي زوجته الأولى سُعاد. كانت ضئيلة الحجم، نحيلة، وعلى قدر مقبول من الجمال، ولم تنجب له أطفالاً، ثم تزوج بعدها بامرأة أخرى، أنجب منها كلّ أبنائه، وهي نقيض الزوجة الأولى تماماً، فقد كانت امرأة طويلة ضخمة وبدينة، وكان أولاد الحي يتهيبونها لضخامتها، فلا تسوّل لأحد نفسه الاقتراب من صغارها. أما صغارها هؤلاء فقد تركتهم هملاً ترعى بلا سائم لولا تدخل سعاد لتربيتهم. كان الحمل ثقيلا على سعاد، فالحاج قاسم قد كبر سنه وأرهقته سنين الغربة فلم يعد يولي هؤلاء الصغار أي اهتمام. ذات مرة وحين كبر الأبناء قليلاً وشب عودهم استيقظت العائلة على خبر صاعق لم يكن بالحسبان، فقد أخبرتهم إحدى صديقات ابنتهم بالمدرسة الثانوية أن ابنتهم ركبت سيارة مع شخص غريب وفرت السيارة مسرعة. اتضح فيما بعد بأنها قد هربت مع رجل من العاصمة بعد قصة حب ملتهبة. صعق أهالي الحي ايضا لهذا الخبر المروع وكالوا الشتائم والسباب للابنة وعائلتها. أما الحاج قاسم فقد اكتفى -وعروق وجهه تكاد تنفجر- باستنزال غضب الله وصب اللعنات على ابنته الشقية ووالدتها وعلى كل من في البيت، وكان ذلك كله على مسمع من أهالي الحي الذين أخذوا يتنصتون قرب الأبواب سعيدين بحادثة مشوقة كهذه. توالت الأيام والسنوات والابنة تعيش في العاصمة بعيدة عن أهلها بعد أن تزوجت بمن هربت معه، وفي الوقت ذاته كان مرض الحاج يتفاقم يوماً بعد آخر حتى توفي ذات صباح مشمس كئيب. قيل إنه قد سامح ابنته الهاربة وعفا عنها قبل أن يتوفى. هذا ما كان يردده أهالي الحي وعيونهم تلتمع أسى وحسرة حين يتطرقون إلى ذكره. تعيش اليوم ابنته الهاربة مع صغارها في منزل أبيها عائدة اليه بعد أن هجرها زوجها، ويعيش معها أيضا بقية أولاده وزوجته الثانية، أما الأولى فقد لحقته بعد وفاته بسنتين. كان لابنه البكر زوجةً نحيلة مزهوة بشقارها وعينيها الخضراوين.
تقدمت بضع خطوات أخرى وانعطفت يساراً نحو الزقاق الجانبي لمنزل الحاج قاسم. كان أول ما يتراءى للعين منزلُ منى، المرأة العجوز التي كانت تعيش فيه وحدها مع زوجها الذي عمل صياداً. كان لمنى التي عملت موظفة في مكتب التربية ثلاثُ بنات وابنٌ واحد. تزوجوا جميعا وانتقلوا بعيدا عن منزل العائلة قبل مجيئنا. بقيت منى وحيدة تقتات هي وزوجها على معاش التقاعد يزورها أبناؤها بين حين وآخر، وكنت لا أنقطع عن زيارتهم أيضا بعد أن كلفتني والدتي بالذهاب إليهم ومقاسمتهم طعامنا. كان ذلك امتداداً لفعل جدتي التي كلفت خالي بإرسال الطعام لهم شفقةً بهم على وحدتهم وكبر سنهم. حين كنت أذهب إلى منزلهم يستقبلني الحاج علي زوج منى جالسا على باب منزله يراقب المارة بعينيه الضئيلتين حينا، ويحدق في السماء حينا آخر، بعد أن انقطع منذ زمن طويل عن الذهاب لصيد الأسماك لمرض في ركبتيه أقعده عن مهنته البسيطة والمحببة إلى قلبه. كانت منى تجلس على سرير خشبي موضوع في فناء المنزل الصغير تقرأ القرآن. كان يسعدها مجيئي. وبعد أن تأخذ الطعام تبقى تسأل عن أحوال دراستي، وعن والدتي وتدعو لنا. كانت منى بهية الوجه، جميلة بعينين واسعتين، وشعر ينسدل خفيفا على كتفيها بلونه الأحمر. كل من يراها يحرز أنها كانت امرأة نشيطة ومحبة للحياة في شبابها. كان منزلها يروق لي بأثاثه الدافئ والبسيط وأرائكه بنية اللون. زيّنت الجدران أيضا بإطارات مذهبة تطل منها صور بناتها صغارا بفساتين مزركشة، وفي إحدى تلك الإطارات تظهر صورتها وهي شابة مع الحاج علي في زفافهم. في ليلة ساجية من ليالي شهر رمضان توفي الحاج علي عن عمر ناهز الثمانين عاماً على سريره الخشبي في فناء منزله الصغير، وتوفيت الحاجة منى بعد ذلك بسنة إثر فشل كلوي حاد، ووُريَ جثمانها الثرى إلى جانب زوجها. بعد وفاتها بيومين سمع أهالي الحي صراخ وعويل يرتفع من منزلها. كان ذلك إثر نزاع حاد نشب بين البنات وأخيهن حول أمر البيت. أراد الأخ أن يسكن فيه رفقة زوجته في حين أرادت البنات بيعه وتقاسم المال، وانتهى الأمر إلى ذلك فعلاً. بيعَ سريعاً إلى إحدى الغرباء. تقاسم الإخوة قبل ذلك كل ما بداخله من أثاث وممتلكات وتنازعوا على ذلك أيضاً. حتى الإناث. حتى هاته الكائنات الرقيقة تحولنَّ إلى غولات يتقاسمن بهمجية ملاعق والدتهن وملابسها ومُزقها. أخذت إحدى تلك الغولات سنارة والدها ودستها خفية في كيس، ولا أحد يعلم حتى الآن فيمَ قد تحتاج إليها! يا لهؤلاء الأبناء القساة! كيف، هكذا بلا مبالاة فجة، تدوس قدم الشره الإنساني كل ما هو جميل ومقدس؟ كيف لا يرف جفن لتلك الأعين التي اعتادت رؤية هاته الجدران، يستند إليها الأب حيناً والأم حيناً أخرى؟ كل هذا ما لا أستطيع فهمه وما لن أفهمه أبداً.
عدتُ إلى الزقاق الذي انعطفت منه إلى هنا وواصلت سيري. في أثناء ذلك اعترض طريقي بعض الصغار الذين أخذوا يتفرسون في وجهي مستغربين سيري المتباطئ، كان عددهم يتجاوز العشرة، وينظرون إليّ بوجوه لوحتها الشمس. تابعت السير متجاهلاً إياهم حتى وصلت إلى نهاية الزقاق. في الجهة المحاذية للمسجد مباشرة يرتفع منزل بطابق واحد مبني من الطوب وتعلوه نوافذ خشبية تزينها ستائر بيضاء من الخارج. عند اقترابي منه كنت أسمع صوت صراخ سيدات وصيحات أطفال مختلطة ببكاء أطفال آخرين. كان ذلك منزل السيدة نهاد أو بيت الهنود كما أطلق عليه أهالي الحي. كانت نهاد وزوجها من أصل هندي، حين قدم أجدادهم إلى عدن منذ زمن بعيد واستقروا فيها، وشيئاً فشيئاً انصهروا مع المجتمع العربي هنا، وأصبحوا جزءاً لا يتجزأ منه، لكنهم مع ذلك أصروا على الاحتفاظ بهويتهم الهندية. كان بعضهم مع حبهم الشديد لعدن ودفاعهم عنها، حتى لتكاد تظن أنهم سكانها الأصليون، يتحينون الفرصة ليخرجوا من خزاناتهم جوازاً هندياً يشهرونه أمام وجهك، ولسان حالهم يقول: انظر! هذه الهند التي تقبع وراء المحيط، بغرائبها وعجائبها، أنا أنتمي إليها، وأستطيع متى ما شئت زيارتها. عمل زوج نهاد عطاراً، وتوفي في ريعان شبابه إثر مرض عضال تاركاً خلفه أرملة شابة وثلاث صبيات صغار. اضطرت نهاد أن تعود بعد وفاته إلى أن تعمل ممرضة بعد أن تركت العمل منذ زمن طويل لتتفرغ لتربية صغيراتها. عند مجيئنا كانت السيدة نهاد تبلغ الستين من العمر، وتعيش في منزلها مع ابنتها الصغرى، في حين تزوجت البنتان الكبريان برجال ميسوري الحال، وأخذتا على عاتقهما إعالة والدتهما العجوز، وأختهما الشابة. كانتا تحرصان على زيارتيهما دائماً، وتشيعان بحضورهما مع أطفالهما جواً من المتعة والبهجة في المنزل الصغير. ويعلم بحضورهما كل من في الحي، فقد كان صوت المسجل يصدح عالياً بأغانٍ وأهازيج، وفي الداخل ترقص السيدات ويغنين. تلك كانت وسيلتهن للترفيه عن أنفسهن ومواجهة همومهن الصغيرة. ولكن يا لها من وسيلة سيئة وغير موفقة! فقد جعلت من سمعتهن لقمة سائغة تلوكها ألسنة رجال الحي ونسائهم. كانوا يتهامسون سراً، ويرسلون إشارات، وكثيراً ما كانت تتلمظ شفاههم إذا مرت إحداهن بالقرب منهم. ومع ذلك لم تكن البنات وأمهن يبالين بكل ما يقال. كانت السيدة نهاد -مع كبر سنها- سليطة اللسان ولا تهاب أحداً، وقد تطبعت البنات بطبع والدتهن، وكثيراً ما كانت تنشب شجارات حادة -لأسباب تافهة- بينهن وبين رجال الحي. حتى أولئك الذين شابت لحاهم كانوا ينضمون أحياناً إلى تلك الشجارات. في السبعين من عمرها توفيت السيدة نهاد إثر مرض استمر طويلاً ينهك جسدها، وقد ازدادت حدته بعد زواج ابنتها الصغرى. كانت البنات تتناوبن على العناية بوالدتهن والبقاء إلى جانبها يوماً بعد آخر حتى ليلة وفاتها. تعيش اليوم في المنزل البنت الصغرى وزوجها وأطفالها الثلاثة. أما الأخوات فقد بقين على عادتهن بالاجتماع دائماً مع أطفالهن في منزل والدتهن، لكن دون أغانٍ وأهازيج تتسرب من خلف النوافذ.
مرة أخرى تجمع الصغار من حولي، وأخذوا يطرحون أسئلتهم:
– بيت من تريد؟ أخبرنا، نستطيع أن نساعدك.
كلما قلبت بصري هنا وهناك كان عددهم يتزايد. وجوه بريئة وماكرة بأجساد صغيرة تسيطر على المكان وعلى الزقاق بكله. لو رأتهم والدتي الآن ستعيد التفكير بالاسم الذي أطلقته بالطبع.
ربما بعد عشرين سنة أخرى سيتطوع أحد هؤلاء الصبية الصغار ليكتب عن حارة العجائز مرة أخرى، وعن قصص أخرى مختلفة لكنها مترابطة ومتشابكة كفروع شجرة اللوز العجوز.
عندما تُقطع الفروع وتموت تنمو فروع أخرى مكانها، فروع شابة مخضرة تزهر وتنتشر، ثم لا تلبث أن تشيخ وتتدلى فتطوحها الشجرة أرضاً حتى تأتي يد الموت من جديد لاقتلاعها، وتبقى الشجرة صامدة ثابتة في مكانها.
أرسلت الشمس أشعتها المذهبة فامتدَّ ظلي طويلاً أمام ناظري، وفي السماء تناثرت غيوم رقيقة وصغيرة، وهبت نسمات ريح باردة محملة برائحة البحر النفاذة فلطفت الجو، وأخذت أكمل طريقي سيراً على الأقدام، وعند وصولي إلى المنزل كانت الشمس قد غابت وراء الأفق مودعة.
فاطمة ياسر: قاصة من اليمن.