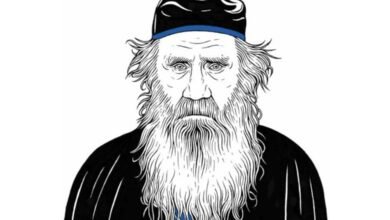جان جوك روسو (1712-1778)
Great Thinkers

ترجمة: عبد الرحمن يونس
إنَّ الحياة العصرية وبطرق شتى تتمحور حول فكرة التقدم، وكلما زاد تحصيلنا للمعارف، خاصة في العلوم والتقنيّة، تناسبَ طردياً مع الزيادة في نمو الاقتصاد بنحوٍ أكبر، وهذا في نهاية المطاف يجعلنا أكثر سعادة. في القرن الثامن العشر أصبحت المجتمعات الأوربية واقتصاداتها أكثر تعقيداً، فكانت النظرة التقليدية أنَّ البشرية وُضِعتْ بقوة على مسار إيجابي، حيث ابتعدت عن الوحشية والجهل وأحلت محلها الرفاهية والتحضر. لكن كان هناك في الأقل فيلسوف واحد على استعداد تام للتشكيك بقوة في “فكرة التقدم”، والذي لا يزال في جَعبته الكثير ليستفزنا فيما يقوله عن عصرنا.
ولدَ جان جاك روسو، ابنَ إسحاق روسو، صانعِ ساعات متعلم، في جنيف عام 1712. عانى روسو مباشرة عند ولادته مما أطلق عليه لاحقاً المصائب، فبعد تسعة أيام فقط من ولادته توفيت والدته سوزان برنارد نتيجة مضاعفات تسببت بها العمالة الشاقة. عندما بلغ العاشرة من عمره، دخل والده في نزاع قانوني وأجبرت العائلة على الفرار إلى مدينة برن حيث سيتزوج إسحاق لاحقاً للمرة الثانية. بدءا من هذه المرحلة اتسمت حياة روسو بالاضطراب والوَحْدة. غير روسو موطنه مراراً وتكراراً طوال سنين مراهقته وسنوات بلوغه، وفي بعض الأحيان لا لشيء إلا بحثاً عن الحب أو طلبَ الثناء والشكر، وفي بعض الأحيان هرباً من الاضطهاد.
في مقتبل عمره، ذهب روسو إلى باريس وغازلته هناك نسائم الرفاهية والترف التي كانت نسق اليوم الاعتيادي في نظام باريس القديم. لقد كافحتِ البرجوازية الطموحة لتحاكي الأذواق والأساليب التي عرضتها الملكية والأرستقراطية، بل أضافت الروح التنافسية التي غذَّت الساحة الاجتماعية الباريسية المتنامية. تعرض روسو في باريس الى ما كان بعيداً كل البعد عن ما عرفه في مكان نشأته في جنيف، المدينة الرصينة التي خالفت وبشدة النهج الباريسي في البذخ والإسراف.
كانت حياة روسو محطاتٍ شكلتها بعض الفرص التي صارت علاماتٍ محورية في حياته. وأحد أهم هذه المحطات كانت في عام 1749 عندما قرأ في نسخة من جريدة تسمى “معجزة فرنسا”، وتضمنت إعلاناً عن كتابة مقالٍ يتناول في طياته الكلام عن التطور الحاصل في العلوم والفنون ودوره في تهذيب الأخلاق. عندما قرأ روسو الملحوظة التي خطت عبر أكاديمية دي ديجون، أحس بالإلهام يطرق بابه أولَ مرة، وأرشده الى أن التحضَّر والتقدم لم يساهما حقيقةً في تطور البشر بل كان تأثيرهما شديد الفظاعة في تأثيره على الأخلاق البشرية، التي كانت ذات يومٍ حسنة طيبة. تبنى روسو هذه الفكرة وحولها الى أطروحة اشتهرت فيما بعد باسم الخطاب حول الفنون والعلوم، وحاز بفضله على الجائزة الأولى في المنافسة التي نظمتها الصحيفة. تناول روسو في مقالته المجتمع الحديث، ونقده نقداً لاذعاً لتحديه للمبادئ المركزية لفكر التنوير. كانت حجته الجدلية يسيرة: كان الناس فيما مضى سعداء وصالحين. ولكن حين الإنسان من وضعه قبل-الاجتماعي فقد ابتلي بالرذيلة وتردي الأخلاق وانحدر إلى الفقر المدقع.
يرى روسو من خلال الاستقراء الدقيق لتاريخ الشعوب أنَّ العالم طوال تاريخه لم يكن حكاية تحول من البربرية إلى ورش العمل والتمدن كما في مدن أوربا الكبرى، بل حالة انتكاس عن حقبة متميزة عشنا فيها بسهولة منحتنا الحرية الكافية لنحيا في أيامنا كما نحب. ويذهب روسو في “حالة الطبيعة” في أنَّ الناسَ أثناء التخلف التقنيّ في مرحلة ما قبل التاريخ، يوم عاش الرجال والنساء في الغابات ولم يدخلوا محلاً أو يقرأوا جريدة، كانوا أملك لعقولهم وذواتهم لذلك أعملوا الحرص في اهتماماتهم تجاه الضروريات التي تقيم حياة الإنسان الهانئة اليسيرة مثلَ الدفء والوئام العائلي، وتقدير الطبيعة، والتفكر في الخليقة (الكون)، والاندفاع في اكتشاف الآخر، وتذوق الموسيقى والاستمتاع بالحياة. يصوِّر روسو “حالة الطبيعة” بأنها مفعمة بجو أخلاقي ومسيرة بالرحمة والشفقة تجاه آلام الآخرين ومعاناتهم. لذا يقول إنَّ التجارة الحديثة (الحضارة) جرَّتنا إليها تاركةً إيانا للحسد والطمع والمعاناة في عالمٍ وافرِ الخيرات. أدركَ روسو مدى الجدل الذي كان عليه استنتاجه، فقد توقع “احتجاجًا عالميًا” ضد أطروحته، وقد أثار الخطاب بالفعل عددًا كبيرًا من الردود. أثناء ذلك عرف الناس روسو وحاز على الشهرة.
لكن ما الذي جعل روسو يقدم على اتهام الحضارة ويصفها بأنها مفسدة الإنسان وماحقة الأخلاق؟ يجيب روسو بأن سبب العداء يعود الى أن السعي نحو الحضارة أيقظ الأنانية وحبَّ النفس في صدور بني البشر، وأعملت فيهم الكبرياء والغيرة والتغطرس والزهو. ويرى أن هذا الشكل المدمر من حبِّ الذات انبثق على السطح نتيجة لانتقال الناس الى مستوطنات ومدن أكبر، وقد بدأوا في التطلع إلى الآخرين من أجل إثارة إحساسهم بالذات. فأهملَ سكَّان المستوطنات والمدن احتياجاتهم في أصل خلقتهم وفقدوا الإحساس بأرواحهم، واقتصروا على تقليد بعضهم لبعض ودخلوا دوامة صراعاتٍ هدامة على السلطة والمال. يرى روسو أن الإنسان البدائي بقي على الفطرة ولا يرى نفسه في منافسة مع الآخرين، بل يصب كل اهتمامه على ذاته وما هدفه في الحياة إلا البقاء حيًّا. ومع أنَّ روسو لم يوظف مفهوم (الهمجي النبيل) ولم يتطرق اليه في فلسفته، وجذبت كتاباته بشأن الإنسان الطبيعي العقولَ إلى هذا المفهوم. أما الذين قد يظنون أن هذه قصة عاطفية مستحيلة، خيالية لمؤلف متحمس يحمل في نفسه ضغينة ضد الحداثة، فيجدر بنا أن نشير أنه كان من الأجدر لو أنصت القرن الثامن عشر لحجة روسو، وذلك لأنه كان قُبالةَ مثال صارخ على حقائق واضحة في تشكيلِ مصير سكان أمريكا الشمالية من الهنود الأصليين.
لقد أوضحت التقارير التي وصفت مجتمع الهنود في القرن السادس عشر بأنه بسيط مادياً لكنه على مستوى عالٍ من التنظيم النفسي، فلقد تكون من مجتمعات صغيرة مترابطة بإحكام وقائمة على المساواة ومتدينة ومرحة وذات تقاليدٍ راسخة. كان الهنود متأخرين بلا شك في وعيهم المالي. وتغذوا على الفواكه والحيوانات البرية وناموا في الخيم ولم يتملكوا الكثير طوال حياتهم، وارتدوا ذات الملابس والأحذية ما دامت صالحة للاستعمال. وحتى رئيس القبيلة لا يتميز الا بالرمح وبعض الأواني. وعلى الرغم من كل هذا ساد بينهم مستوى متميز من القناعة وسط سهولة العيش. على كلٍ وفي عقودٍ قليلة ومع وصول أول الأوروبيين، تأثر النظام الاجتماعي جذريًا بسبب الاتصال الحضاري مع التقنيّة الأوروبية والرفاهية الرأسمالية. وما يهم هو حقيقة أنَّ الفرد فقد الحكمة والعقل الفهيم الذي يتبصر به للعيش في الطبيعة. بل استعاضوا عن ذلك بحيازة الأسلحة والمجوهرات والكحول. وأصبح الهنود يتوقون لرؤية أقراط الفضة، وخواتم القصدير، وقلادات الزجاج الفينيقيّ، وزجاجات الجليد، والبنادق، والكتان، والخرز، والقفازات، والمرايا. لم يأتِ هؤلاء المتحمسون الجدد لم بمحض الصدفة، فقد حاول التجار الأوروبيون عن عمد تشجيع الرغبات في الهنود، لتحفيزهم على اصطياد الأحشاء الحيوانية التي كانت رائجة في السوق الأوروبية. للأسف، لم يبدُ أن الثروة الجديدة التي أطلت على أصحابها قد أكسبتهم أي سعادة أخرى غير تلك التي امتلكوها، وعلى العكس عملوا بمشقَّة أكبر. وبين سني 1739 – 1759 قتل محاربو قبيلة شيروكي، وقوامهم ألفا رجل، مليون غزال وربع مليون لتلبية الطلب الأوروبي. وارتفعت معدلات الانتحار وإدمان الكحول، وتمزقت المجتمعات، وتناحرت الفصائل. ولم يكن زعماء القبائل بحاجة إلى روسو لفهم ما حدث ومع ذلك وافقوه تماماً على تحليله.
توفي روسو في عام 1778، في سن السادسة والستين، أثناء سيره خارج باريس. وقضى سنواته الأخيرة رجلًا ذائع الصيت، يعيش مع زوجته. ولكنه كان أيضاً في تحرُّكٍ مستمرٍ هربًا من الاضطهاد في جنيف بعدما تسببت به بعض أفكاره المتطرفة، والدينية على نحوٍ خاصٍ يإثارة الجدل (وكان الإجهاد الناجم عن هذا أيضاً سبباً في سلسلة من الانهيارات العقلية). دفن روسو في البانثيون في باريس، ويحتفل الجينيفيون به اليوم على أنه أحد أشهر أبنائهم الأصليين.
في عصر مثل عصرنا، عصر فشا فيه الغرور والترف وصار مما يستحسنه الناس ويصيرهم عدائيين جدًا على حد سواء، ما زالت تأملات روسو تتردد في الأرجاء. وتحثنا على تجنب الأنانية والمنافسة غير الشريفة، وتوجهنا عوضاً عن ذلك إلى تنمية ذواتنا واكتشاف قيمتنا الذاتية. لن يتسنى لنا أن نتجنب مشاعر البؤس والقصور إلا بمقاومة شر المقارنة. ورغم صعوبة الأمر فقد وثقَ روسو أن ذلك ليس مستحيلا، وبالتالي فهو يترك وراءه فلسفة النقد التأسيسي، بل أيضا فلسفة التفاؤل العميق. ثمة مخرجٌ على الدوام من البؤس والفساد اللذين تحدثهما الأعراف والمؤسسات. إن الجزء الأصعب من الحضارة الحديثة هو أنها تنطوي على التطلع إلى أنفسنا وإلى إنعاش طيبتنا الفطريّة.