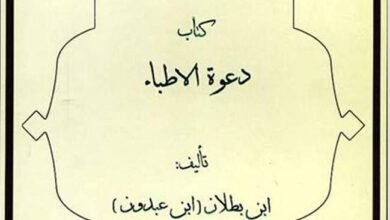اسم الوردة – أمبرتو إيكو
مؤمن الوزان

يُرسل الراهب الفرانشسكاني غوليالمو دا باسكرفيل رفقة أدسو دا مالك الراهب المتدرب المبتدئ إلى دير في منطقة نائية شمال إيطاليا للتحقيق بحادثة موت أحد الرهبان، وبعد وصولهما إلى الدير يمكثان سبعة أيام فيه، وتبدأ رحلتهما التي رافقتها الكثير من الأحداث وشهدت موتا متتابعا لعدد من الرهبان، يبحث غوليالمو عن القاتل رفقة أدسو. ودائما ما كان غوليالمو متأخرا بخطوة عن القاتل مما يجعل مطاردته تبدو عديمة النفع في تقدم تحقيقه لكنها تفتح له أبوابا مغلقة متعلِّقة بهذا الدير حتى نهاية اليوم السابع الذي ينتهي بحادثة حرق الدير ومكتبته العظيمة والسرية، أعظم مكتبة في العالم المسيحي كما يقول غوليالمو. تدور أحداث الرواية في بداية القرن الرابع عشر، ولا يُخدع القارئ لهذه السطور أو يظن أن الرواية هي رواية بوليسية قروسطية، فما الجرائم إلى حجة ووسيلة استخدمها إيكو لسرد ما في جَعبته من مخطوطات ومعلومات شكلت مادة اهتمامه ودراسته خصت الطوائف المسيحية واختلافاتها وقضايا اللاهوت في معتقداتهم وأفكار متعلقة بفقر المسيح وفقر الرهبان والأساقفة، والصراعات السياسية ما بين سلطة البابا والإمبراطور والسعي الحثيث بين المتنافسين إلى سدة الحكم، إضافة لمسائل العلوم والكتب والعلاقة مع الآخر الذي تمثل بالعرب والمسلمين -الكفّار كما وُصفوا- كل هذا يُجسَّد ويُحشَّد في هذه الرواية. ولاهتمامات إيكو بالسيمياء والعلامات والإشارات فإن الرواية تغص بالعلامات والإشارات حتى عدَّها بعض الباحثين بأنها مُدخل لمن يود دراسة علم العلامات والسيميائية.
في مستهل تمهيده للرواية، يبتدئ إيكو روايته بالإشارة لتسلمه مخطوطا ألَّفه رئيس دير هو الأب فاليه بعنوان مخطوط الدون أدسون دي مالك، وهو بهذه الحركة يعطي طابعَ الغموض لقصته التي سيحكيها راهب “أدسون أو أدسو” عاش في القرن الرابع عشر وهو القرن الذي تدور فيه أحداث الرواية، وزاد الأمر غموضا وتشويقا للقارئ أو هكذا أراد بعدم ذكره لأسماء أغلب من ساعدوه أو استشارهم في بحوثه في مخطوط أدسون دو مالك الذي كتبه الأب فاليه. ويستمر بعملية التملص من كتابته لهذه الرواية حين يقول بأنه لا يدري لماذا قدم المخطوط للقارئ، وكأنه مجرد وسيط فقط استلم المخطوط وأتمَّ نقوصاته وتقديمه لقارئ مشتاق لهذا المخطوط. وهذه حيلة تحمل جانبين أحدهما سهل الفهم حيلة روائية والآخر محفوف بمخاطر تعدد الاحتمالات، وأن إيكو قد يكون صادقا وهذا بلا شك ما يوده إيكو إثارته في نفوس قرّاءه ليحبس أنفاسهم في صحبة كتابه.
لا يخفي إيكو إعجابه بجويس وعالم جويس الروائي ولا سيما رائعته الروائية عوليس، الرواية الثورة في عالم الرواية الحديثة، ويبدو تأثيرها واضحا على إيكو، وهذا ما يعترف به في كثير من كتاباته، مما يجعلنا نتأكد أن إيكو قد وضع أمامه روائيا في نظره هو المثال والقدوة التي سيحاول اقتفاء آثاره، كما يذكر في تأملاته حول رواية اسم الوردة. يقسِّم اليوم في رواية اسم الوردة إلى ثمانية أجزاء هي: “أول الصبح – صلاة الحمد – أولى – ثالثة – سادسة – تاسعة – صلاة الستار – صلاة النوم”. نجد هذا التشابه في تقسيم اليوم في بُنية رواية عوليس التي تدور الرواية في يوم واحد، وأحداث هذا اليوم موزعة على ثماني عشرةً حلقة، تجري فيها أحداث الرواية خلال يوم واحد في مدينة دبلن. فهو لم يجعل روايته تدور في يوم واحد بل في أسبوع واحد، وكما أن جويس قسم أحداث اليوم في روايته اعتمادا على الأوديسة ومغامرات أوديسيوس في البحر أثناء رحلة العودة إلى الديار- فقد قسّم إيكو الرواية إلى أيام، والأيام إلى مدد زمنية محددة. لم تكن هذه التقسيمات لليوم ذات ضرورة أو أهمية في متن الرواية أو سير الأحداث أكثر من أنها تأثر بجويس وأسلوب ترتيب للانتقالات ما بين الأحداث في اليوم الواحد، كفصول ومقاطع ترتيبة كما في روايات أُخَر.
تمتاز الصفحات المئة الأولى لرواية اسم الوردة بكثرة التفاصيل وكثافة السرد، الأمر الذي دعا أصدقاء إيكو والناشر أن يطلبوا منه تخفيف هذه الكثافة اللغوية والمعلوماتية في هذه الفقرات الطويلة لأنها تبدو مضجرة ومعقدة، لكن إيكو رفض هذا الاقتراح وأجاب: “لو أراد أحد أن يدخل إلى الدير، وأن يعيش فيه سبعة أيام، فعليه أن يقبل نسق الدير… تلك الصفحات المئة الأولى هي مثل تدريب، وإذا لم يقبلها القارئ فالأمر أمره، وسيبقى في أسفل الجبل” ويضيف في مجمل كلامه حول علاقة القارئ والنص “الدخول إلى الرواية أشبه بتسلق الجبال: عليك أن تلتزم بنَفَس وأن تضبطه على وقع الخطى، وإلا فالأولى أن تتوقف عن الصعود”. فها هو إيكو يجعل الصفحات المئة الأولى بكل ما احتوته من معلومات وصفية وتاريخية وسياسية ودينية، وتصويرية للكنيسة هي حجر اختبار لقدرة القارئ على مجاراة إيكو. وأثناء وصف أدسو للكنيسة واللوحات بداخلها، يستخدم إيكو أسلوب اللوائح أو القوائم، وهذه التقنية التي تقوم على التعداد والجرد والتصنيف، قد لاقت اهتمام إيكو وأفرد لها أحد مؤلفاته وهو “القوائم من هوميروس إلى جويس”، ويستخدم أدسو هذه التقنية في الوصف والتصوير إذ يقول في وصف جزء مما رآه داخل الكنيسة: “ومخلوقات بعدة أذناب ومسوخ كثيفة الشعر وسمندلات وحيَات قرناء وثعابين برمائية وحيّات ملساء وذوات رأسين مسننة الظهر، وضباع وقنادس وأوزاغ وتماسيح وحيوانات مائية ذات قرون منشارية، وضفادع وعنقاوات وقردة وقردوحات ومسوخ مهق ووحوش مانتاكورة، ونسور ومخلوقات تشبه الإنسان وسراعيب وتنانين وبوم ومليكات، ومتفرعات، ويافرات وأشباح التين وعقارب وعظايات وحوتيات وأشياق وعطاءات خضراء وأخطبوطات وسلاحف”.
يُؤكد إيكو لنا في روايته اسم الوردة أن كتابة الرواية ليست مجرد موهبة على السرد والحكي، بل هي كذلك اجتهاد ودراسة وبحث وتنقيب وجهد جهيد، وهذا ما يبرز لنا وهو يصف ويصور أحوال الكنيسة التي دارت فيها روايته في القرن الرابع عشر، وما يورده من معلومات وأخبار وحوادث وأسماء وتواريخ لا ينتجها إلا باحث أعياه البحث، فهو يقدم لنا صورة متكاملة الجوانب والزوايا، حتى لا تكاد تهرب من شاردة ولا تفلت من يديه واردة، ويبدو أنه يؤثر الصدق في النقل كما آثر الصدق في محاكاة أسلوب ولغة القرن الرابع عشر، فهو في أكثر من موضع يؤكد على عظمة الشرق وتطوره في العلوم والمعارف المختلفة، فلا يفوته أن يذكر مكاتب بغداد أو العلماء العرب والمسلمين إذ يقول على ألسن شخصياته:
فقال غوليالمو بتواضع: “قليلا جدا، لقد حصل مرة بين يدي كتاب أبي القاسم البلداشي… تقويم الصحة، أبو الحسن المختار بن بطلان أو القاسم المختار كما تريد”.
يخطئ غوليالمو في اسم صاحب الكتاب فيصحح له آخر الاسم، وأبو الحسن المختار طبيب نصراني من أهل بغداد ترك كتاب تقويم الصحة وهو الكتاب الذي ترجم إلى اللاتينية ونشر في أوروبا عدة مرات، وفيه الكثير من الكنوز المعرفية والتي حدد فيها عناصر صحة الإنسان فذكر: هواء لطيف، وأكل وشرب معتدلين، وتوازن بين العمل والراحة، وتوازن بين الاستيقاظ والخمول، وانتظام خروج الفضلات وانشغال العاطفة. وفي ذكر إيكو لهذه الأسماء والمعلومات نقطتان مهمتان الأولى هو التلاقح المعرفي والأمانة في تصوير الكنيسة في هذا العصر من خلال ذكر العلوم في الكنيسة بصورة تامة دون تغييب أو إقصاء حتى لو كان أصحاب هذه الكتب في نظر الكنيسة من الكافرين، والأخرى هي مدى تطور أهل المشرق عربا وعجما في ميادين العلوم والمعارف الأحيائية والتطبيقية. وقد لا يتعجب القارئ من سعة علمية هذه الرواية إن عرف أن لإيكو اهتمامات في القرون الوسطى بحثا ودراسة، وحين قرر كتابة الرواية لم يكن الأمر شاقا عليهه فقد قضى ما يقارب الخمسين عاما الأولى من عمره في الدراسة، قبل أن يكتب روايته في سن الثامنة والأربعين.
*
تُجيب رواية اسم الوردة عن سؤال لم يُسأل لكنه متماهٍ مع كل عمل روائي، لمَ نكتب الرواية؟ ولمَ الرواية دون غيرها من الفنون الأدبية النثرية؟ لأن الرواية بوضوح تمنح الكاتب ما لا يمنحه غيره من حرية العرض والكتابة كيفما يشاء، غير محدودة بضوابط وكما قيل عنها فن ذو صيرورة مستمرة، فهي متطورة دائما ولا يوجد نقطة ختامية لها، فبين يدي الكاتب البارع المبدع تفتح له أُفق واسعة وأبواب مغلقة. رواية اسم الوردة ليست رواية جرائم ومحقق يلاحق المتهمين حتى يصل إلى الحقيقة فحسب، وليست رواية تاريخية تدور في القرن الرابع عشر ميلادي في إيطاليا فحسب، وليست رواية لاهوتية تَطرحُ أفكارا ونقاشات عن المسيح وحياة المسيح وأقواله وأفعاله فحسب، وليست جردًا للرذائل التي انتشرت ما بين الرهبان والقساوسة من زنى ولواط وسرقة واستغلال الفقراء واغتصاب النساء وعيش حياة ماجنة تسودها كل المحرمات فوق الأرض المحرمة فحسب، ولا هي رواية سياسية تطرح دور الكنيسة والبابا في اختيار الملك فحسب، ولا هي رواية تطرح الأفكار المسيحية ونظرتها إلى الآخر الكافر في الشرق الذي يفصله عن أوروبا بحرٌ لُجيٌّ، والجماعات المسيحية وعقائدها المختلفة التي انضوت تحت مِظلة المسيحية الكبيرة فحسب، بل إنها جامع لكل ما ورد سالفا، ما بين التاريخية واللاهوتية والسياسة والجرائم والفضائح والأفكار والعقائد، هكذا إيكو قد اختارته المخطوطات والدراسات التي أفنى نصف عمره الأول فيها لتخرج على يديه رواية أقل ما توصف بأنها عمل عظيم ومُجهد للكاتب قبل القارئ، وممتع بما حمله في طياته من أخبار وضمته جنباته من أسرار، هي هكذا الرواية، عمل لا تُنهي بحور متعتَه شواطئٌ ولا تستنزفُ عمرَه الأيامُ كلما تعاقبت، بل هي دائمة النضرة ومستمرة التكوين بين يدي الكاتب العظيم. ويواجه الروائي أثناء كتابته عن زمن ليس بزمنه مأزقًا صعبا، يتمثل في كيفية محاكاة لغة ذاك العصر ووصف عاداته وتصوير الحياة فيه بكل صدق وحرفية دون أن يخرج عن النص ويُخطئ في نقل هذا العصر إلى روايته، أو أن يسقِّط عصره وزومانه وكل اتجاهاته الاجتماعية والفكرية والحضارية واللغوية على زمن آخر هو المقصود في روايته، ويعترف إيكو في حديثه عن رواياته عن مثل هذه المشاكل خاصة تلك التي تتعلق باللغة وكيفية استحضار لغة القرن الرابع عشر بكلمات لها أبعادها الرمزية أو التناصية أو الدلالية، فتندرج هذه الصعوبات ضمن الإكراهات التي يجد الراوي نفسه محاصرا بها ولا يمكنه أن يتجاوزها وهو من اختارها فتصبح أي هفوة أو زلة مُنبئة بخراب العمل وخروجه عن المكانة التي طمح إليها الراوي، ومن هذه الإكراهات التي نجدها في رواية إيكو، تلك الأحداث العرضية التي تلفي فيها شخصياته نفسها أمام اختبار حقيقي ومن خلفهم إيكو في وصف أدوات لم يكونوا يعرفوها من قبل، فأن تأتي بشخص من القرن التاسع الميلادي وتطلب منه أن يصف لك شاشة التلفاز سيكون هذا الأمر في النظر الجميع ضربا من الجنون، وهنا يضع إيكو شخصيته أدسو فوق حجر الاختبار وهو يصف النظارات التي لبسها غوليالمو فيقول على لسان شخصيته لأجل أن يُوصل للقارئ كيف يُمكن لإنسان في القرن الرابع عشر ميلادي وصف النظارة: “… وأخرج شيئا كنت قد رأيته من قبل بين يديه، وفوق وجهه أثناء السفر. كانت شدادة صُنعت بحيث يمكن أن تستقر فوق الأنف (وأحسن من ذلك فوق أنفه هو، البارز والأقنى) كالفارس على صهوة جواده أو كطير فوق عود، وعند جانبي الشدادة بحيث تقابل العينين تمتد دائرتان من المعدن في شكل بيضة تكبسان على لوزتين من الزجاح، غليظتين كأنهما قاع كأس”. فإيكو يحاول على لسان أدسو بكل ما أمكن لمخيلته من مجاز وتصوير واستعارة أن يصف النظارة، إلى ذاك التعقيد الذي يُصاحب المرء حين يجهل، في الوقت الذي يعطي العلم بالشيء واتساع رقعة استخدامه- تسهيلات وتيسراتٍ، واليوم إن أردنا أن نصف نظارة القراءة، نختصر تعريفها بأداة تتُستخدم للمساعدة في القراءة أو وسيلة علاج لتقوية البصر، لكن أنى لأدسو هذا الوضوح في الطرح وهو يواجه شيئًا غريبا لا يعرف له اسما ولا صفة ولا ملجأ له في الوصف إلا بصره وخياله.
*
يقول إيكو في كتاب “اعترافات روائي ناشئ” بأنه دخوله عالم الرواية جاء متأخرا في نهاية عقده الخامس على الرغم من رغبته من كتابة الرواية في سن العشرين، وأنه حين قرر كتابة الرواية وجد كل ما يحتاج إليه كاملا لكتابتها، نظرًا لاهتمامه ودراسته للقرون الوسطى وهو زمن الرواية وكل سماتها، وأما لمَ جريمة القتل موضوعا لحبكة الرواية، فيجيب مازحا بأنه كان يريد قتل راهبٍ في شبابه. وبما امتلكه إيكو من خلفية معلوماتية واسعة عن الموضوع الذي أراد الكتابة فيه، فإن الرواية جاءت بكثافة معلوماتية يضخها إيكو في السرد على لسان شخصياته، وتكاد الرواية في كثير من المواضع والمحادثات تتجاوز السرد الروائي إلى سرد تاريخي وتوثيقي قد لا يتناسب مع الرواية، بل وإن ما نجده واضحا أن هناك أقسام من الرواية جاء سرد المعلومات لأن إيكو أراد إضافتها ولم يجد بُدًا من أي يُخصص لها جزءًا خاصا بها، وبحسب رأي الروائي محسن الرملي: “فإن إيكو امتلك معلومات عن هذا الموضوع ولم يجد طريقة لعرضها أفضل من رواية، هذا التكثيف في ضخ المعلومات والحوادث التاريخية سياسية أو دينية أو علمية أو فلسفية، يكاد يكون أحيانا مخصصا لنوعٍ معين من القرّاء دون غيرهم، أو حتى للباحثين المتخصصين بالقرون الوسطى”. يعمد إيكو في سرده على المراهنة على قدرة القارئ في فهم الاستعارات أحيانا أو السخرية النصيّة، فعندما كان غوليالمو يتحدث مع أدسو عن المتاهة يقول: “…، أو قد يلزم للطواف داخل متاهة أن تكون معنا أريانا طيبة تنتظرنا عند الباب ماسكة بطرف الخيط.” وهنا استعارة واضحة لأسطورة خيط أريادني، وأريانا كما تسمى لدى الرومان ساعدت ثيسيوس بقتل المينوتور بإعطائه خيطا حتى لا يضيع في المتاهة مع سيف لقتل المينوتور. ويتهكم كذلك على جماعات مختلفة فلسفية أو دينية، فيقول على لسان غوليالمو أيضا: “لا أدري لماذا ولكني لم أرَ قط آلة وصلت إلى الكمال في أوصاف الفلاسفة، وكانت كاملة أيضا في استعمالها الميكانيكي، في حين منجل الفلاح الذي لم يصفه أي فيلسوف يعمل كما ينبغي…”.
اهتمامات إيكو بالعلامات واضح وجلي للقارئ، وهو الاختصاص الذي درسه وكتب الكتب في السيميائيات، لذلك نراه في روايته يكثر من التركيز على موضوع العلامات، وهذا ما يضيفه لصفات غوليالمو وذكائه في الاستنتاج اعتمادا على ما يراه من علامات وإشارات، وهذه التذكير المستمر لإيكو حول موضوع العلامات هي رسائل منه للقارئ بأن النص ليس كما يبدو وأن يخفي أكثر مما يعلن وهو بحاجة إلى الغوص في أعماقه من أجل الوصول لأسراره.
يقول غواليالمو:
كل كائنات الدينا،
هي لنا كتاب ورسم،
يتجلى في مرآة.
*
حين يكشف إيكو أولى خيوط الجريمة التي أُنيط بشخصيته الرئيسة غوليالمو في البحث فيها، ومعرفة أسبابها، فيُعترفُ له أثناء تحقيقه عن أسباب الجريمة، بأن هناك فظائع جنسية تحدث في الكنيسة وهي اللواط، هذه الخطيئة التي تحدث في الكنيسة قد لُمِّحَ إليها سابقا حتى وصل بالقارئ إلى التخوم النهائية للاعتراف، وبما أن إيكو لا يذكر الجريمة لأجل حبكة روائية فقط، فعند التفصيل في أسباب حدوث اللواط في الكنيسة، فالممارسون يستخدمون المقايضة في تبرير هذه الفعلة، فما هي هذه المقايضة؟ العلم مقابل الجنس، وبالتأكيد إيكو لا يقصد الحادثة هذه التي وقعت في القرن الرابع عشر في الكنيسة التي تدور فيها روايته فحسب، لكنه بالتأكيد يقصد ممارسات عامة تحدث في كل زمان، ولربما يقصد أشخاصا معنيين دون غيرهم، بأنهم يستغلون حاجة الآخر للعلم مقابل الجنس، حتى وإن لم يكن هناك أشخاص معنيون بهذا، لكن هذه المقايضة (الجنس مقابل العلم) لها جذور ممتدة في كل مكان، جامعات، شركات، مؤسسات، وهذه المقايضة (الجنس مقابل العلم) هي صنف واحد من نوع أشمل هو أكثرها انتشارا تتمحور حول أعطيك ما تريده لتعطيني ما أريد، لكنه تبادل من النوع الخبيث والاستغلالي، ولا تكتفي الفظاعة التي كُشفت أولى خيوطها بالجنس لكنها زادتها بأنه لواط، وزاد اللواط بأنه بين الرهبان، وازداد الأمر سوءا بأنه في دار عبادة، لينتهي بختامٍ وهو القتل. فالجريمة مُضاعفة والإثم مُركّب، إذا انتُهِكت حرمات ثلاث: الأولى حرمة اللواط، والثانية حرمة العهد الذي يأخذه الرُهبان على أنفسهم بالتعفف من المتعة الجسدية، والثالثة حرمة المكان الذي هو مخصص للعبادة فقط. فاجتمعت نتائج هذه الحرمات الثلاث في القتل وهو الجريمة التي تمثل بوابة لكشف فضائح مخفية أخرى، ستوضحها بقية الأحداث.
علاقة الذات والآخر في رواية اسم الوردة
يركز إيكو على علاقة الذات والآخر من منطلق: الأنا (المؤمن)/ الآخر (الكافر) والأنا (الجاهل)/ الآخر (العالم)، وما زاد هذه العلاقة تشديدا وحدِّة في إطلاق الأحكام أن هذا الآخر هو العربي والمسلم، والأنا هو المسيحي وليس مسيحيا كأي مسيحي آخر بل هو المسيحي الراهب المؤمن، لذلك نرى أن إيكو لا يتوانى عن التأكيد على هذه الثنائية المتضادة (ثنائية الإيمان والكفر) و(ثنائية العلم والجهل). تُوضع علاقة الأنا مع الآخر في حقل الاختبار المتمثل في الإيمان فإن توافقت معنا فمرحبا بها وإن اختلفت معنا فهي ضالة وكافرة وعدوة. ولكن يبرز لهذا الحقل حجر عثرة يكون الإيمان أو الكفر ليسا المعيار الأول والأهم، إذ إن الكفر قد اجتمع مع العلم، لذلك لا تتردد الكنيسة في أخذ العلم والاستفادة من علوم هؤلاء العرب والمسلمين وإن كانوا في نظرها كفرة وهراطقة وضالين ومحرومين من ملكوت الرب ومطرودين من رحمته. ومن هذه العلاقة الثنائية المتضادة (الكفر/الإيمان) التي يكتنفها العلم، ومن خلال ما ورد على ألسن الشخصيات الرهبانية تبرز لدينا بعض الحقائق التي يستند إليها الرهبان في تعاملهم مع العلوم وأصحابها وكيف تتناسق مع عقيدتهم:
١- العلم ليس مختصا بالمؤمنين وإن كانوا هم أولى به من غيرهم الكافرين.
٢- علمك ومعرفتك بالحقائق ليس حصنا لك من الكفر ولا دليلا على إيمانك.
٣- لا مانع من أخذ العلم من الكافرين.
وفق هذه الأسس الثلاثة يتعاملون مع العلوم العربية دون التأثير في العقيدة التي يلتزم بها الرهبان. لكن ما يبرز أيضا ليس الكفر العقائدي فقط، لكن هناك استحقار ونظرة دونية أيضا، إذ تجري هذه المحاورة:
“أدسو بدون تلك العدستين المجعولتين للقراءة لا أقدر على فهم ما هو مكتوب على هذه الكتب اقرأ لي بعض العناوين”.
فأخذت من بينها كتابا: “سيدي ليس مكتوبا!”.
– كيف؟ أرى أنه مكتوب. ماذا تقرأ؟”.
“لا أقرأ. ليست حروفا أبجدية ولا يونانية، لو كانت كذلك لكان بإمكاني التعرف عليها. تبدو ديدانا أو ثعابين، أو وسخ ذباب…”.
“آه، إنها عربية. هل هناك كتب أخرى مثل هذا؟”.
أدسو الذي يخجل من جهله اليونانية ويحاول أن يعوض جهله بها بمساعدة أستاذه غوليالمو، لكنه حين يرى كتابة يجهلها أيضا، يصفها بأوصاف قبيحة، كالديدان والثعابين ووسخ الذباب، وعلى الرغم من عدم قدرة غوليالمو على القراءة بسبب سرقة عدساته، فإنه يخمن مباشرة ودون تردد أو ذكر عدة احتمالات بأن هذه اللغة هي العربية، هذا يعني أن الوصف الذي وُصِفت العربية به معروفٌ لدى من يجهلها أو حتى من يعرفها، لذلك حين يسمع غوليالمو أوصاف كلمات هذه اللغة فهو يعرف أن المقصودة هي العربية، وهذه النظرة الاحتقارية للغة، لا تخرج عن العلاقة الثنائية المتضادة ما بين الذات والآخر، الآخر العليم، الذي نأخذ منه العلم لكنه علم تشوبه قذارة أصحابه ولغتهم.
لا يكل أدسو عن إرداف وصف الكفر بالعلماء المسلمين لكنه حين يجد ما يلامس روحه وذاته من هؤلاء العلماء يتغير خطابه لهم ووصفه إياهم بل يتحول الأمر لتخبط لا يعرف كيف يتعامل معه، فبعد أن يدخل أدسو مع أستاذه غواليالو المكتبة/ المتاهة مرة أخرى، ويصادف القسم الخاص بكتب الحب، يصف أصحابها: “… لا يمكن دون شك أن تُسلّم بالقراءة إلى كل إنسان، لأنها بطرق مختلفة تتحدث عن أمراض متنوعة تصيب الجسم والعقل، وتكاد تكون كلها من تأليف علماء كفار”. ما زال أدسو حتى اللحظة يستخدم وصف الكفر مرادف للعلماء المسلمين لكن خطابه يأخذ منحًى أكثر احتراما: “وتأثرت وأنا أقرأ صفحات ابن حزم، الذي يعرف الحب كمرض عضال، دواؤه فيه والمصاب به لا يريد الشفاء منه ولا يبتغي الخروج منه (والله يعلم كم كان هذا القول صائبا!)”. فمن أين أتى كل هذا الاحترام لعالم مسلم؟ فأول شيء رفع صفة الكفر منه وذكر اسمه مجردا ثم عاد ليقسم على قول ابن حزم لدقة توصيفه الذي وجده أدسو في حالته إذًا، وهذا ما يُبينه لنا إيكو من تخبط واضطراب مسألة الكفر لدى الرهبان وأن الكفر قد يُرفع إن قال صاحبه شيئًا يرضينا وينفعنا، لكنه سرعان ما يعود لذكر وصم أبي بكر الرازي بالكفر: “… وهي فكرة يشاطرها أيضا كفار في المستوى نفسه من الحكمة، إذ وقع نظري على السطور المنسوبة إلى أبي بكر محمد بن زكريا الرازي…”. هذا هو التخبط الذي وقع به أدسو هل هؤلاء كفار أو هل هؤلاء عظماء يستحقون التقدير؟ أدسو لا يدري ويعود لاضطرابه في الوصف، فيصف ابن سينا بالعظيم: “وأخيرا لم تبقَ لدي شكوك حول خطورة حالتي عندما قرأت استشهادات لابن سينا العظيم،…”. ويحار القارئ في أمر أدسو الذي يسقط في يديه، لكنه وكما عودتنا السطور الآنفة الذكر يعود لسيرته الأولى فيقول: “كان العلاج الذي يشير به ابن سينا هو الجمع بين المحبوبين عن طريق الزواج. صحيح أنه كان كافرا، وإن كان حكيما، لأنه لم يقرأ حسابا لحالة راهب مبتدئ،…”. فكما نرى ابن سينا تارة عظيم وحكيم وتارة تعود له صفة الكفر. ويريد هنا إيكو تبيان أمرين:
الأول: حالة التخبط الذهني التي يعاني منها أدسو بسبب الحب.
الثاني: حالة الفوضى الفكرية وعدم اتساق واتزان الأحكام في التكفير، والتي أمام أول اختبار حقيقي لمريدي هذه الأفكار يدخلون في مطبات كلامية وتخبطات اعترافية ما بين الإجلال والتحقير، وما بين الاحترام والتكفير.
المتاهة
“المكتبة متاهة؟ فتلا الشيخ وكأنه غارق في تفكير عميق: “تلك المتاهة هي صورة من هذا العالم: فسيحة لمن يريد الدخول، وضيقة لمن يرغب في الخروج” المكتبة متاهة كبيرة وهي دليل على متاهة العالم. ادخل إليها ولن تعرف إن كنت ستخرج. لا ينبغي أن نتعدى أعمدة هرقل…”. يذكر إيكو في (هامش/ تأملات) في اسم الوردة، “أن هناك ثلاثة نماذج في المتاهة، الأول هو نموذج المتاهة الإغريقية، وهي نوع لا يسمح لأحد بأن يضيع فيه: فأنت تنفذ إليها وتبلغ المركز، وهناك من المركز تصل إلى المخرج. والنموذج الثاني هو المتاهة النمطية والتي إذا ما فككتها تجد شيئا يشبه الشجرة، بُنية ذات جذور، ولها مسالك مغلقة كثيرة. فيها مخرج واحد، ولكن يمكن أن تُخطئ، تحتاج إلى خيط أريادني (تحليل منطقي لحل عدة مشكلات في آن واحد، وهو مأخوذ من أسطورة أريادني) لكي لا تتيه. والمتاهة الثالثة، الأخيرة، هي متاهة الشبكة، أو ما تسمى بالتفرع اللا نهائي، وهو مبني بحيث يمكن وصل أي مسلك فيه بأي مسلك آخر، فليس له مركز أو محيط أو مخرج، لأنه لا متناه بالقوة”. ويضيف أن “متاهته هي متاهة نمطية، غير أن العالم الذي يدرك غوليالمو أنه يعيش فيه مبني مثل تشعب نهائي: أي أنه قابل للبناء ولكنه غير مبني أبدا بصفة نهائية”. نحن الآن أمام المتاهة/المكتبة، المتاهة التي لها ارتباط وثيق كما يعتقد غوليالمو بالجرائم التي تحدث في هذا الدير، ولهذه المتاهة رمزية وتشير إلى أكثر من حقيقة في ذات الوقت:
الأولى: توصف المكتبة بأنها متاهة وأنها صورة لهذا العالم فسيحة أثناء الدخول ضيقة أمام الخروج، أي أنها أشبه بالفخ، وأنها ذات طبيعة تيهانية، تجعل الداخل إليها في حالة ضياع مستمر، وبما أن العلم مرتبط بالمكتبة، فإننا نصل إلى هذه المعادلات:
إذا كانت المكتبة = المتاهة
وإذا كانت المكتبة = العلم
فإن احتمالية أن يكون (العلم = متاهة) واردة جدا خاصة وأنه يصف متاهة المكتبة دليلا على متاهة العالم، كيف عرفنا العالم ومتاهته؟ عرفناه بالبحث والتجربة والتفكير، وتتلخص جميعا في العلم، فهذه إحدى العلامات التي يبعثها إيكو للقارئ، أن المكتبة (العلم) تعني متاهة، وأن الداخل فيه يبقى حبيسا في هذه المتاهة.
الثانية: تطرح علينا السؤال الآتي ما علاقة المتاهة بالجريمة وما علاقتها بغوليالمو؟ يصف إيكو متاهته بأنها نمطية وقد تُخطئ فيها وتحتاج إلى خيط أريادني، أي أن غوليالمو مطالب بحل لغز المتاهة التي يظن أن فيها دليلا قد يوصله لحل لغز الجرائم التي تحصل في الدير والوصول إلى المجرم. وهذه المتاهة تعطي عدة احتمالات منها أن غوليالمو قد لا يصل إلى الحقيقة ولا إلى معرفة المجرم كما تعطي احتمالات وصوله إلى معرفة المجرم. لكن ما تؤكده المتاهة هو أن غوليالمو لن يصل إلى حقيقة المجرم، فهناك ربط ما بين المتاهة والجريمة، وتيهان غوليالمو في المتاهة هو تيهانه وضياعه في معرفة حقيقة المجرم، وهذا التيهان هو العلامة التي يبعثها إيكو للقارئ قبل أن تنكشف الرواية في النهاية على حقيقة فشل غواليالو.
*
منذ بداية قراءتي لرواية اسم الوردة والتقدم في أحداثها وما ذكره إيكو من معلومات تاريخية تخص الكنيسة والبابا والطوائف المسيحية والخلافات فيما بينها سواء على منهج البابا والكنيسة أو في قضايا عقدية تخص فقر المسيح أو لاهوتية، وأنا يراودني سؤال عن مدى صحة المعلومات المذكورة بين دفتي الكتاب، بقيتُ منتظرا لعل إيكو يبعث بعلاماته ليجيب سؤالا لم يُطرح عليه، حتى وصل إلى السطور التالية والتي أرجح أن إيكو يشمل بها روايته، وينهي الجدل الذي خامرني حول صحة المعلومات. يذكر أدسو ضمن حواره مع غواليالو في المكتبة ما يلي: “الكتب لم توضع كي نؤمن بما تقوله ولكن كي نتحرى فيها. لا يجب أن نتساءل أمام كتاب ماذا يقول ولكن ماذا يريد أن يقول، وهي فكرة واضحة جدا عند مفسري الكتب المقدسة القدامى. ووحيد القرن الخرافي كما تتحدث عنه هذه الكتب يخفي حقيقة أخلاقية، أو رمزية أو تأملية تبقى حقيقية، كما تبقى حقيقية فكرة أن العفة فضيلة نبيلة. ولكن بخصوص الحقيقة الحرفية التي تقوم عليها الثلاث الأخرى، يبقى أن نرى أي تجربة أصيلة نشأ اللفظ. يجب أن نناقش اللفظ، حتى عندما يكون المعنى الإضافي صحيحا. لقد ذُكر في بعض الكتب أن الماس لا يقطعه إلا دم تيس. فقال أستاذي الكبير روجر بيكون إن ذلك غير صحيح، لأمر بسيط، لانه جرب ذلك ولم ينجح. ولكن لو كان لعلاقة الماس بدم التيس معنى سامٍ، فذلك المعنى يبقى ساميا.
فقلت: “إذن يمكننا أن نقول حقائق سامية ونكذب بخصوص المعنى الحرفي. ولكن ما يؤسفني هو أن وحيد القرن الخرافي، هكذا كما وصفوه، غير موجود، أو لم يوجد، أو لا يمكن أن يوجد يوما”.
إيكو والمرأة وسوء الاقتباس من رواية اسم الوردة
بما أن الرواية تدور في العصور الوسطى وشخصياتها من الرهبان ذوي الأفكار المسيحية المتدينة، فإن الكثير من الأقوال ستبدو غريبة عن الوقت الحالي وفي المجالات كافة. كان يُنظر إلى المرأة نظرة دونية من الناحية الدينية ومن أمثال هذه الممارسات التي مورست باسم المسيحية ضد المرأة هو حرمانها من تعلم الكتابة أو ممارسة كتابة الكتاب المقدس، وكذلك شيطنتها وجعل جسدا للشيطان ووعاءً للشرور، لذلك نرى أن الكثير من الأقوال التي تصدر من الرهبان تجاه المرأة تكون عدائية وتصمها بالشر والسوء وأصل كل رذيلة، مما يجعل الاقتباس في هذه المواضع مخلا بقيمة ومعنى الاقتباس، إذ يُخرجه من مساقه الصحيح، وسيفهم خاطئًا أو منحرفا أو قد يُوصم إيكو بالجهل إن قُرِئ منفردا دون نصه الأصلي المنسجم في ضمن سياق أكبر هو سياق الرواية والعصر والمكان وفكر المتكلم.
من الذي يسرد؟
– واستنتجت من ذلك أن مذكرات أدسو تبدو في نفس طبيعة الأحداث التي ترويها… ص 28
– ها أنا أتهيأ لأن أترك على هذا الرق بينة على الأحداث المدهشة والرهبية التي عشتها وأنا شاب، معيدا بالحرف والكلمة ما شاهدت وما سمعت، دون مجازفة بأي حكم أو استنتاج… ص33
– ولفهم الأحداث التي وجدت نفسي أشارك فيها فهما جيدا، قد يكون من الأفضل أن أذكّر بما كان يحدث في تلك الفترة من بداية القرن، كما فهمتها آنذاك وأنا أعيشها وكما أتذكرها الآن وقد أضفت إليها حكايات سمعتها من بعد، إن استطاعت ذاكرتي أن تصل بين خيوط تلك الأحداث المتعددة والغامضة جدا. ص34
– وقد سُمِحَ لك بالحضور، لأنني طلبت كاتبا يتولى تدوين ما سنقوله. ص177
– إنني أكتب بنفسي متعبا وأنا أكتب كما كنت أحس بالتعب في تلك الليلة، أو بالأحرى في ذلك الصباح. ص221
– المشكل هو بالأحرى، أن أقص ما حدث لا كما أراه الآن وكما أتذكره (حتى لو أني كنت أذكر إلى الآن كل شيء بحيوية لا ترحم)، ولا أدري إن كانت التوبة التي تبعته هي التي ركزت بتلك الحيوية ظروفا وأفكارا في ذاكرتي… ص293
– وعندما تفضل غوليالمو بتقديمي إليه تلميذه وكاتبه قال لي “أحسنت أحسنت”. ص355
– على كل حال اكتب يا أدسو ليبقى على الأقل أثر مما يحدث اليوم. ص405
فكما تُشير الاقتباسات فإن المخطوط قد كتب ليكون مذكراتٍ من قبل أدسو بعد مرور ستة عقود على رحلته مع غوليالمو في الدير ما عدا بعض النقاشات التي يذكر فيها إيكو بأن غوليالمو استخدم أدسو كاتبا لها، يقول إيكو في جوابه عن هذا السؤال في كتاب تأملات حول اسم الوردة: “يروي أدسو وهو في سن الثمانين ما شاهده حين كان في الثامنة عشرة. من المتكلم إذًا: أدسو ذو الثماني عشرة أم أدسو ذو الثمانين سنة؟ واضح أنهما معا، وهذا شيء متعمد. كانت الحيلة تكمن في جعل أدسو العجوز الحاضر باستمرار، وهو يمعن النظر فيما يتذكر أنه شاهده وأحس به، بوصفه أدسو الشاب.
وهنا لا بد من طرح تساؤل، ما الذي يدعونا أن نصدق بأن أدسو امتلك ذاكرة حديدية حتى يسرد أحداثا وحوارات ونقاشات طويلة حدثت قبل ستة عقود من الزمن دون أن ينسى شيئا أو يذكر للقارئ أنه قد نسى بعضها، فهو يسرد وكأن الحدث يحدث مباشرة وهو ينقله، وليس سردًا لأمور عادية أو أحاديث سهلة، بل نقاشات لاهوتية أسئلة وأجوبة تحتاج إلى تدوين مباشر حتى تُحفظ كما قالها أصحابها دون حذف أو نقص أو زيادة وعلى الرغم من ذكر إيكو أن غواليالمو عرّف واستخدم أدسو كاتبًا له في بعض المواقف وأمر بكتابة وتدوين بعض الحوارات فإنه لم يتطرق أين وكيف ومتى كتب وحتى أدسو لا يذكر هذا، مما يجعل آلية الكتابة في أغلب أحداث وحوارات الرواية، التي لم يذكر غوليالمو أو أي شخص آخر أن أدسو كان يدوِّنها، تلفها الغموض فهي تحتاج إلى الرق وأدوات الكتابة وحملها ونقلها من مكان إلى آخر كلها أمور تبقى مجهولة للقارئ، الأمر الذي يدفعني للتساؤل متى، أين، كيف كتب؟ ولم يقتصر الأمر على هذا، فأدسو يصف لوحات ومنحوتات، ويسرد لوائح كاملة لما يراه، وهي تأخذ أوراقا عديدة وكأن اللوحة مطبوعة في ذهنه لم تتعرض لآفات النسيان التي يجلبها الزمن وكذلك يروي انطباعاته ومشاعره أثناء مشاهدته هذه اللوحات والمنحوتات بكل دقة وتفصيل وهذا ما يجعلني لا أصدق وجود هكذا شخص بهذه القابلية على الحفظ ولو اختار إيكو طريقة أخرى للعرض دون أن يعتمد على مذكرات كُتبت بعد قرابة ستين عاما لكانت أقرب إلى الواقع خاصة ونحن نتحدث عن رواية قروسطية واقعية وليست فانتازيا أو خيالية حتى نؤمن بوجود هكذا شخص ولا يشير إيكو أيضا لأي قابلية غير اعتيادية عند أدسو بل هو حتى ظهر في الرواية شخصية عادية وربما أقل من عادية. يقول الروائي الدكتور محسن الرملي بعد سؤاله عن إمكانية السرد اعتمادا على الذاكرة بعد مرور كل هذه المدة الزمنية أجاب: “بشكل عام، يجوز في الأدب كل شيء بما في ذلك الفانطازيا واللا منطقي والشطح في الخيال والمبالغات وغيرها. وبالنسبة لإيكو وشخصياته في هذه الرواية، ما يبرر شيء كهذا أنهما متشابهان من حيث الاحتراف وتكريس الحياة للمخطوطات والتدقيق فيها. أما فنيا، فإيكو نفسه اعترف لاحقا بعد أن تعلم فن الرواية الاحترافي -لأنه في الأصل ليس روائيا- اعترف أنه بالغ في حجم روايته هذه ولا ذنب للشباب خاصة والأجيال القادمة تحمل كل هذه التفاصيل وكان في نيته أن يصدر منها نسخة مهذبة ومشذبة ومختصرة أكثر لكنه مات”.