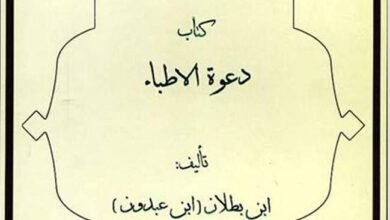إدوارد سعيد – أماكن الفكر
إدوارد سعيد بعيني تلميذه وصديقه تِمُثي برنن

عمران أبو عين
صدر في الأشهر الماضية (آذار/ مارس 2022) كتابٌ ضخم من 528 صفحة، من سلسلة عالم المعرفة الكويتية العريقة، عن إدوارد سعيد بعنوان “إدوارد سعيد – أماكن الفكر” بقلم صديقه وتلميذه “تِمُثي برنن”، وقد رأينا، لضخامة الكتاب من جهة وأهميته من جهة أخرى، أن نُقدم مُلخًصا في شذرات لجوانب مختلفة من حياة إدوارد سعيد، سواءً شخصية وأخرى أدبية وثالثة سياسية.
شذرات شخصية
يقدم تِمُثي لنا صديقه وأستاذه إدوارد سعيد على أنه أكبر من الواقع بكثير، فهو على سبيل المثال لم يحضر إلى أمريكا بل أمريكا التي حضرت إليه، يعني ذلك أنه استطاع بوجوده في أمريكا أن يحرك المياه الراكدة في المجتمع الأمريكي بدلاً من أن يذوب فيما يُعرف بــ”وعاء الذوبان”، كناية عن أمريكا؛ المكان الذي يجمع الوافدين إليه ويصهرهم في بوتقته ليعيشوا متجانسين، بعد أن كانوا غير ذلك سابقاً. يعلق تمثي على وجود إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا قائلاً “إن وجوده هو الذي جعل من جامعة كولومبيا جامعة مميزة من بين الجامعات الأمريكية”، ويستشهد الكاتب بقصة احتجاج بعض طلبة الجامعة على وجود إدوارد سعيد في جامعتهم إثر حادثة بوابة فاطمة وإلقاء حجر من خلف السور الفاصل بين إسرائيل وجنوب لبنان (القصة أخذت أبعادها في الصحافة العالمية)، فاجتمع رئيس الجامعة بالطلبة المحتجين وأخبرهم بداية بأنه لم يكن في برنامجه، وأنه أراد أن يذكرهم أن الامتيازات التي يتمتعون بها بعد تخرجهم من جامعة كولومبيا تعود في أصلها إلى وجود مَن ادعوا تسميته زوراً وبهتاناً بــ”أستاذ الإرهاب”. أي أن سمعة الجامعة وشهرتها لا تأتيان من فراغ، بل من العاملين فيها الذين يعطونها من تميزهم ما يجعلها تكتسب هذه السمعة وتلك الشهرة، وهذا ما يعنيه الكاتب بلغته المجازية أن أمريكا حضرت إلى إدوارد سعيد وليس العكس.
ولد سعيد في العام 1935م في القدس، لأب يعمل في التجارة، وبما أن تجارة الأب كانت هي المزود الرئيس لمعدات المكاتب للجيش البريطاني المحتل ولحكومة الانتداب المصرية، فقد كان على أفراد العائلة أن يعملوا وقتا أضافيا لإثبات انتمائهم وكونهم عربا فلسطينيين أصليين. وقد كان إدوارد طالباً لامعاً ذا إحساس رهيف بالطرفة، ويقول عنه نبيل مالك، الذي عرفه منذ بدايات شبابه، إنه كلما اقترب من سعيد للعب اعتذر وتحجج إما بالبيانو وإما بالتنس وإما باللغة الفرنسية. فقد كان يتكلم الفرنسية منذ أيام دراسته في مدرسة الجزيرة الاعدادية، وتعلم المزيد منها في كلية فكتوريا. تركت الطقوس الدينية آثاراً عميقة في نفسه، فقد صرح قائلاً “لا أزال احتفظ بكتاب الصلوات من أيام القاهرة”. وأنه كان ما يزال يقرأه (في العام 1998). فهو ناقد فلسطيني أمريكي، ومفكر، وناشط، يعد الآن واحداً من أهم المفكرين الذين غيروا نمط التفكير في نصف القرن الأخير. شارك بالكتابة للدوريات العلمية والمجلات الشعبية والصحف ذات التوزيع الواسع، وما تزال كتبه ومقالاته تُقرأ بما يربوا على ثلاثين لغة. ويحظى بالإعجاب في جميع أنحاء العالم، فقد عمل سعيد مديراً لأوركسترا فايمار، وسارداً لحكايات في التلفزيون القومي، وكاتباً محلياً في صحف القاهرة، ومفاوضاً من أجل الحقوق الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية. إنَّ الذين عرفوا سعيد من قراءة كتبه فقط لم يروا كل ما فيه: لم يروا صبيانيته بلا شك مثلما لم يروا ولاءه العميق لأصدقائه. كان سعيد خليطاً يصعب التنبؤ بأفعاله، ويمازحه أصدقاؤه أحياناً بوصفهم إياه بأنه مزيج من “إدواردو” (مفكر إيطالي من عصر النهضة) و”أبو وديع” وهو اسم يتبع عادة الثوار الفلسطينيين في اتخاذ أسماء مستعارة بدلا من الأسماء الحقيقية. أما عن اختيار اسم “إدوارد”، تكتب والدته هيلدا موسى سعيد في دفتر مذكراتها: “لا تسألني عن السبب. كلانا أحب الاسم، كان هنالك كلام كثير عن إدوارد، أمير ويلز، فاخترنا اسمه، لكن إدوارد كرهه عندما كبر، وكان يفضل اسما عربيا”.
في العقد الثاني من حياته، صادف الأفكار الجادة للمرة الأولى على يدي منير نصار، وهو جارٌ يكبره قليلاً وابن أحد كبار المسؤولين في شركة تأمين مقرها لندن، فأعاره منير وإخوته الذين يكبرونه سناً بعضَ كتبهم وناقشوا كانط وهيغل وأفلاطون، الذين سمع أسماءهم للمرة الأولى. شارف إدوار على تجاوز عتبة الصبا إلى عالمِ شبابٍ يتحدثون بحماس عن أفكار لم يسمع بها من قبل مثل “محمد علي، بونابرت، إسماعيل باشا، ثورة عُرابي، حادثة دنشواي”. وفي الخامسة عشرة من عمره وصل سعيد برفقة والديه إلى الولايات المتحدة في العام 1951م للالتحاق بالقسم الداخلي في مدرسة ماونت هيرمن، وعُرف عنه في هذه المدرسة حماسُه الشديد للقضية الفلسطينية. وتشكلت حياة سعيد الفكرية على مدى ثماني سنوات أو يزيد قليلاً بالحضور الطاغي لأربع من الشخصيات التي أدت دور المثال الذي يحتذى به: بلاكمر وسوتماري في برينستن، وهاري لفن في هارفارد، وشارل مالك رجل الدولة اللبناني وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت. غير أن الدور السياسي لمالك في النقاط الحساسة صار إشكالياً عندما تكشَّفت، فقد تحول من ناطق باسم الفلسطينيين في الأربعينيات الى المهندس الفكري للتحالف المسيحي اليميني مع إسرائيل بعد العام 1949. وقد حقق سعيد انتقاما صغيراً بالسخرية من مالك في مذكّراته.
قبل التحاق سعيد بجامعة هارفرد ببضعة أشهر، وفي أثناء زيارته الأولى للحفل الموسيقي في مدينة بايرويت، وهو في الثالثة والعشرين، تعرَّض لحادث اصطدام دموي مرعب مع راكب دراجة بخارية في سويسرا، وأصيب بجروح في الرأس استدعت قضاء بعض الوقت في المستشفى. فلم تمضِ سنة كاملة حتى فاز سعيد بجائزة باودن في هارفارد على رسالته عن كونراد، فالتحق بأمثال إمرسن وهنري آدمز وجون أبدايك في ذلك التشريف. ولا شك أن سعيد كان مسحوراً بوعي كونراد بأنه أسيرٌ للكتابة مربوطٌ الى المنضدة كالعبد، وأنه مضطر إلى نحت الكلمات ليخلق شيئاً شبيهاً بالتجارب الإنسانية التي لم يكن يتوقع من أبناء جلدته أن يفهموها تماماً. هذا التعلق بكونراد لا يبدو على هذا القدر من الوضوح إلا إذا تجاهلنا الاختلافات. إذ يرى سعيد أن كونراد كان إمبريالي النزعة، متشائماً كارهاً للبشر. لكن كثيراً ما انجذب سعيد لكتَّاب بدا أنهم لا يناسبون ذوقه أو آراءه السياسية، فامتدح سوِيفت المساند للملكية وليس ويليم بليك المعادي للاستعمار ، وفضَّل كونراد ذا المواقف السياسية المشكوك في أمرها على ر. كننغم غريم، وهو كاتب اشتراكي متمكن (قارن سعيد نفسه به). لكن وبخصوص كونراد فقد ألمح سعيد الى أن هوسه به استندَ الى حقيقة أنهما مغتربان في عواصم العالم الإمبريالي.
من الطرائف التي يخبرنا بها أحد زملائه في الغرفة، يقول: أن سعيد كان يتكلم في نومه باللغة العربية، أما في أثناء اليقظة فإنه كان يغيِّر اللغة وفق الزائر، العربية عندما تتاح الفرصة، والفرنسية مع من يعرفون اللغة، ونوعان من اللغة الانجليزية، إحداهما أمريكية والثانية أوكسفرديَّة. وكان سعيد سريع القراءة على نحو خارق، فعندما وقعت يده على نسخة من رواية ” الدكتور جيفاكو” قرأ الكتاب ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى منتصف الليل، وعندما فرغ منها قال: “ها هي ذي انتهت”، في الوقت الذي كان زميله في الغرفة ينظر إليه مندهشا.
شذرات أدبية
جرَّب سعيد كتابة الرواية بين السنة التي قضاها في القاهرة ونهاية الدراسة في كلية الدراسات العليا، وكانت أشد محاولاته طموحا قد جرت في بيروت في صيف العام 1962، وهي رواية أعطاها عنوانا مؤقتا “مرثاة”، وتتكون من سبعين صفحة من النثر المصقول وثلاث عشرة صفحة من الملاحظات. كانت قصته، كما يحصل مع كثير ممن يكتبون رواياتهم الأولى، تصويراً شبه مخفي لعناصر من طفولته، ومحاولة لبعث الحياة في القاهرة في الأربعينيات. أرسل سعيد قصائدَ إلى المجلات الأدبية منذ أواخر الخمسينيات (نُشرت اثنتان منهما في مجلة “الكلية” في العام 1959)، وانسحب عندما رفضت مجلة “النيويوركر” نشر القصة، وتوقف عن كتابة القصص على مدى خمس وعشرين سنة. عمل سعيد على نحو متقطع على رواية عن الخيانة ما بين سني 1987 و 1992، ومع حلول منتصف التسعينيات، وفق ما قاله لزوجته مريم مرّاتٍ عديدة، كان موضوع الخيانة قد تداخل مع موضوع آخر يركز على عجز رجالٍ من العرب (وهو يناسب حقبة ما بعد أوسلو)، لكنه في النهاية تخلى عن المشروع. وعن كتابه الأشهر “الاستشراق” فقد اُسْتُقبلَ الكتاب استقبالا بهيجاً، ورشُّح الكتابُ لنيلِ جوائز، الذي تُرجم بعدها الى ثلاثين لغة، لكنه خسر ذلك، وتلقى مراجعاتٍ تنم عن الحسد، وتطلَّب الأمر عدة سنوات قبل أن يتحول إلى فضيحة على رغم أن سعيد كان قد شرح أفكاره الجدلية قبل عامين من نشره في مقالة نشرتها مجلة “ذا نيو يورك تايمز بك رفيو”.
وامتدحَ محرر دار النشر، التي نشرت الترجمة الفرنسية من كتاب الاستشراق، “مزيجَ رهافة الفكر والعنف اللذين أرى أنهما من خصائص نظراتك النقدية”، ورفض الكتاب بحجة أنه أكاديمي أكثر من اللازم، وأمريكي أكثر من اللازم. أما نجاحه الباهر مع لندن ريفيو أوف بوكس، فقد تمثل في جهوده الفردية التي أدَّت إلى تحويل ما تنشره المجلة عن الشرق الأوسط باتجاه داعم للقضية الفلسطينية. وبعد أن خرج سعيد من حروب النظريات وجد أن عليه أن يعدّل أسلوبه ليتوافق مع أسلوب المحادثة الهادئة المستخدم في لندن ريفيو أوف بوكس، وعندما أجرت المجلة بعض التعديلات التحريرية على مقالاته كان من عادته الاتصال بالهاتف ليقول للقائمين عليها إنهم “ارتكبوا مذبحة بحق نصه، على رغم أن ما حصل لا يعدو شيئاً طفيفاُ يمكن إصلاحه بسهولة”. كانت المجلة من جهة المبدأ سعيدة بنشر كتاباته عن الشرق الأوسط في حين كانت منشورات نيويورك ترفضها. ولقد أثرتْ مقالاته عن خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وعن طفولته في بيروت، وعن المجادلات الدائرة حول الصهيونية في هيئة التحرير.
عندما بدأ سعيد في العام 1992م بكتابة مذكراته ” خارج المكان” (1999) فإنه فعل ذلك ليس لأنه فشل في إتمام الرواية، التي عمل على كتابتها بين الحين والآخر لما يقرب من خمس سنوات بعد العام 1987، بل لرفضه إتمامها. ففي انقلاب على النفس في الجزء الأخير من حياته في ضوء حياة قضاها في التعليم رفض الرواية بوصفها شكلاً من أشكال الأدب، وقال إنها لم تعد تعني شيئاً. ومع أنه لم يبدأ بكتابة المذكرات جدياً إلا في أوائل التسعينيات، فإن أصولها إلى وقت أبكر في المقالة المعنونة ” القاهرة في الذاكرة” المنشورة في مجلة هاوس أند غاردن في عام 1987، وأكثر حتى من ذلك في عام 1988 عندما أرسل قصة عن طفولته لجيمز أتلس في مجلة “نيويورك تايمز”.
شذرات سياسية
لم يكتب سعيد إلا أقل القليل عن أعمال سارتر، فقد كان سارتر يتمتع بشهرة واسعة بين المثقفين العرب، وكان مفهومه المعروف بــ”الأدب الملتزم” وعبارة “أدب ملتزم” في كتابات الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. وكانت مواقف سارتر المعادية للاستعمار باستمرار، وانفتاحه نحو النظم الاشتراكية القائمة، ومقدمته الشهيرة لكتاب فانو “معذبو الأرض” قد دفعت سعيد إلى أن يدعوه في يوم ما بأنه: “واحد من عظماء المفكرين في القرن العشرين…”. على أن إعجاب سعيد اضمحل اضمحلالاً ملحوظاً بعد المديح الأولي للعدد الخاص الذي أصدره سارتر في مجلة “الأزمنة الحديثة” في يونيو من العام 1967 وخصصه للصراع العربي – الإسرائيلي. وفي نهاية المطاف لم يكن سعيد قادراً على أن يغفر لسارتر دعمه لإسرائيل. في العام 1970 نظم سعيد مع صديقه سامي البنّا (وهو أستاذ لمادة الصور الحاسوبية في كولومبيا) مظاهرة تثير الإعجاب اتخذت شكل الجلوس حول المسألة الفلسطينية في كولومبيا، وفيها تحدث سعيد الى الجمهور.
كانت المرة الأولى التي اعتُرف فيها بمنظمة التحرير الفلسطينية علناً في الساحة الدولية في العام 1974. وفي هذه الأثناء وصل سعيد إلى نيويورك لإلقاء خطبته الافتتاحية أمام الأمم المتحدة، وكان سعيد قد وطد صداقته مع كمال ناصر، عضو حزب البعث الاشتراكي المناهض للإمبريالية. ولم يكن سعيد قد قابل أيّا من كبار القائمين على منظمة التحرير الفلسطينية حتى العام 1974. وانشغل سعيد وصادق العظم بإجراء المقابلات مع جناح فتح التابع لعرفات لفهم الكيفية التي تجري عبرها الأمور في المنظمة لأنهما كانا غير راضيين عما يريانه. وسُحرَ سعيد بمقال تشومسكي “مسؤولية المثقفين” إذ دعا الأستاذة إلى التصريح بآرائهم الناقدة… وقد التقى سعيد بتشومسكي مراراً في لقاءات عن قضية فلسطين/ إسرائيل.
بالنظر إلى النجاح الذي حققته مقالته “صورة العربي” التي انتشرت في الشرق الأوسط وفي الشتات العربي انتشارا واسعاً، فقد أصبح شخصاً معروفاً وطُلِبَت منه المعونة في الترجمة الإنجليزية لخطاب عرفات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1974. كان أحد أقرب مستشاري عرفات يُدعى “الحوت”، وفي أثناء مكوث الوفد الفلسطيني، الممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، توطدت العلاقة بين سعيد والحوت مباشرة، مما أعطى سعيد إمكانية الوصول إلى كبار المسؤولين في المنظمة. وعند وضع الصيغة الأصلية لخطاب عرفات، كانت قد أعيد النظر فيها من عدة شخصيات منها وليد الخالدي، ومحمود درويش، وصلاح دباغ، ولم تكن النتائج مرضية، فاتح الحوت هنا سعيدًا فوافق سعيد على تنقيحه وعمل مع رندة خالد فتّال، وهي تعمل في مهنة التحرير، فأنتجا الصيغة التي ألقيت في الأمم المتحدة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974. أضاف سعيد أموراً يعرف أنها ستترك حسناً لدى مستمعيه الأمريكيين، وأضاف بحماس خاتمة الخطاب الشهيرة “لا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي”.
كانت حالات النجاح والفشل التي رآها سعيد في الحركة الفلسطينية في السبعينيات في لبنان قد دفعته على نحو لا فكاك منه ليس فقط إلى أداء دور الناطق الفكري باسمها، بل إلى أن يكون عضوا فاعلاً فيها ايضاً. وأصبح داعياً ماهراً بمقالاته وخطبه، وعلى الرغم من ذلك، فإنه منذ أواسط السبعينيات فصاعداً وجد نفسه يسافر في كثير من الأحيان لحضور الاجتماعات والمناقشات. وتبيَّن من المتابعة الحثيثة التي كان يجريها مكتب التحقيقات الفدرالية الذي كان يتابعه عن كثب أن سعيد، من وجهة نظر المكتب في الأقل، “هو حلقة الوصل غير الرسمية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية”، وأن عرفات كان يطلب منه النصح أكثر مما يطلبه من الممثلين الآخرين للمنظمة في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة. نجد أن سعيد بقي عنصراً أساسياً في الكفاح الفلسطيني، وتلقت محاولاته المترددة الأولى ليكون الناطق الأول باسم الحركة في المحافل الدولية دعما من الترحيب النسبي الذي أبدته سنوات حكم كارتر. وقد ألمحت جريدة ” نيويورك تايمز” في مقال خاص نشرته في شهر فبراير/ تشرين الثاني 1980 أبرزته على صفحتها الثانية، إلى أن سعيد ينتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وإن كان ذلك بنحوٍ غير رسمي. ووقع اختيار المنظمة على سعيد لإعلان الأخبار الطيبة.
وجدت أنشطة سعيد السياسية أساسها في النقد الأدبي، فالقضايا التي شغلته في كتاب “العالم والنص والناقد” على سبيل المثال كانت ترفرف فوق طلب عرفات في العام 1988، كما فعل في العام 1974 حين ساعدَ في ترجمة مسودة بيان المنظمة التي كتبها درويش. وأثناء عمل سعيد على ترجمة البيان شعرَ بأن ذلك البيان يفضح جهل عرفات المطبق بما ينبغي أن يتضمنه بيان من هذا النوع. وكان رئيس المنظمة قد حذف كل ما ينبغي أن يُقال للمجتمع الدولي بعبارات أدخلها سعيد بعناية وأحل محلها مواقفه العرجاء. علق سعيد على الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في العام 1988 بقوله ساخراً إنه يشبه “مؤتمراً للنحويين” بسبب ذلك القدر من التدقيق في صياغة القرارات. وتعرض مكتب سعيد للتفجير، وترك أحدهم سيجاراً متقداً على مكتبه، وسُكب الحبر على أوراقه، وسُرق أربعون كتاباً من فوق الرفوف: “زارني أفراد من مكتب التحقيقات الفدرالي وقالوا لي أن الفاعل مجموعة من المجموعات اليهودية المتطرفة…”. وبسبب المبادرات الإصلاحية التي اقترحها سعيد، فقد هاجمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي غازلها في يوم من الأيام، هاجمته بحجة أنه برجوازي أكثر من اللازم، فقطع علاقته مع زعيمها جورج حبش. وقد اشاعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية شائعة مفادها أنَّ سعيدًا كان عميلاً أمريكياً.
لقد قُدر لسعيد أن تدخل حياته السياسية مرحلة ثانية بعد أقل من سنة، تفصل المرحلتين مناصفة فيها اتفاقيةُ أوسلو للسلام بعد عقدها في سبتمبر/ أيلول 1993. فبعد النتائج المذلة لهذه الاتفاقية التي وقعها بأجواء احتفالية باذخة كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين في الباحة العشبية للبيت الأبيض في أثناء حكم كلينتون، قطع سعيد علاقته برئيس منظمة التحرير الفلسطينية التي قد دافع عنها بلا كلل طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات. ثم تعرض سعيد لهجوم مرير من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبلغ من كثرة المقالات التي كتبها والمقابلات التي أجراها عقب “إعلان المبادئ”، كما كان اتفاق أوسلو لعام 1993 يسمى رسمياً، أنها ملأت خمسة مجلدات. عاش سعيد في العقد الأخير من حياته وفق ما قاله ابنه وديع في حالة دائمة من الغضب والألم، وعندما أتيحت الفرصة لعرفات منع تداول كتب سعيد في الضفة الغربية وغزة.
الخاتمة
في أبريل/ نيسان من العام 2003، وبعد تسلم شهادة فخرية من جامعة السوربون، جعل الورم اللمفاوي، الذي يسببه العلاج الكيميائي، بطنه يكبر أكثر من حجمه المعتاد فصار الوشاح التكريمي أصغر من اللازم، فجلس بدون حراك في حين أخذ الموكلون بوضعه يدورون حوله لربط وشاحين معا لإكمال الزي المطلوب. والأسوأ من ذلك أن قصة قذف الحجر عندما وصلت الى الصحف قبل بضع سنوات كتبَ أحد الطلبة رسالة عديمة الذوق في جريدة يومية تصدر في جامعة كولومبيا يسخر فيها من سمنته، من دون أن يدرك أن الانتفاخ في الوسط جاء نتيجة للورم. أما جريدة “واشنطن بوست” فقد راكمت كلاماً بالغ اللؤم في التهجم على شخصه: “ذلك الرجل الأشيب، وصاحب الرداء الفضفاض، والقلنسوة، والنظارات الشمسية الأنيقة يبدو أنه تقدم في السن، وأنه أكثر أناقة… من أن يليق به قذف الحجارة نحو الجنود الإسرائيليين”.