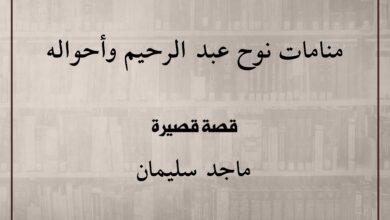صيف وشتاء
قصة قصيرة

حل شتاء سنة 2023 مبكراً على مدينة عدن واستبشر الأهالي بذلك خيراً. ولا يسألن أحدكم، ولو عن حسن نية، كم بلغت درجة الحرارة حينها فلكل مدينة شتاءها المميز لها كما نعرف جميعاً. هدأ البحر الهائج، وهبت نسائم باردة أنعشت الأجواء. ها هي ذي الوجوه الرطبة قد جفت وأشرقت قسماتها، وتطاير الشعر الملتزق على الجماجم أخيراً. عاد إلى العيون بريقها المفقود، وسار الناس بخفة وليونة متطلعين بسعادة نحو حياة غامضة. حتى أشعة الشمس غدت أكثر رقة وما عادت تشق الرأس إلى نصفين. أضف إلى ذلك أن الهدوء قد عم الحارات والبيوت، ولم تعد تسمع الشتائم والصراخ لأسباب تافهة. ليس سوى قدر معتدل من الشتائم اليومية المعتادة. بعثت حلاوة الشتاء الدفء في النفوس وأخمدت الأحقاد، لذا فقد تقلصت الشجارات بين الأزواج المحترمين واشتعل الحب مجدداً. باختصار غمر السلام كل ركن وكل زاوية وصدحت الأطيار مغردة. لقد كان وقتاً سعيداً أشرق فيه كل شيء وامتلأ بهجة وجمالاً.
وسط ذلك العالم الأخاذ بسحره وشتاءه المتواضع وفي أحد أحياء المدينة الضيقة ارتفع منزل صغير بطابق واحد. كان منزلا بسيطاً ومتواضعاً ورثه الأستاذ علي من والده المتوفى. وهو يقطن به الآن مع زوجته وطفليه. جلس الأستاذ علي وزوجته هدى في عصر أحد أيام الشتاء الجميلة في ردهة منزلهما يتبادلان الأحاديث ويحتسيان الشاي الممزوج بالحليب. فُتحت مواضيع كثيرة وذُكر أناس طيبون وآخرون أشرار لئام. فجأة تذكر الأستاذ علي أحد هؤلاء الطيبين أو اللئام، لا أحد يعرف على وجه الدقة من أي فصيلة هو. اسمه الأستاذ مصطفى سعيد وهو زميل للأستاذ علي ويعملان معاً في المدرسة نفسها. كان ذلك منذ مدة طويلة. أما الآن فقد هاجر مصطفى إلى إحدى الدول الأوروبية. قدم طلب لجوء وانتظر كثيراً وفي النهاية تم قبول طلبه. باع كل أثاث منزله وتسلف قليلا من هنا وقليلا من هناك إلى أن استطاع السفر أخيراً رغماً عن أنف الحُساد. بالأمس تحدث زملاؤه بالمدرسة أنه استطاع استقدام عائلته إلى أوروبا بعد ثلاث سنوات من المحاولة. لذلك دار الحديث عنه اليوم في حوار الزوجين الهادئ.
– في الأمس تخيلت نفسي مكان الأستاذ مصطفى وقلت بأنه لو سنحت لي فرصة مثل فرصته ما كنت لأذهب. هذه أوروبا يا هدى، لا يخدعنك بريقها الكاذب فهم ينتزعون الأطفال من أحضان آبائهم وأمهاتهم ويلقون بهم إلى أحضان الشواذ لينشئوا بينهم. أي جنون هذا؟ لا لا مستحيل. أفضل أن أموت قبل أن أتخيل نفسي في حال كهذه.
– وأنا أيضا أفضل أن أموت على أن أراهم ينتزعون أطفالي من بين يدي. ألم تسمع عن المدارس أيضاً؟ إنهم يعلمون الشذوذ في المناهج ويدعون إليه ويشجعون الفتيات الصغيرات على العيش مع أصدقائهن. وليجرؤ الأب فقط على أن يعترض أو يقول كلمة واحدة فالسجن سيكون بانتظاره.
– شيء فظيع حقاً. دمار أسري. انهيار بشع للقيم. ما الفائدة أن نأكل ونشرب ونعيش في شقة محترمة والأولاد يتسربون من بين أيدينا وقد يحاكموننا يوماً ما! ما الفائدة من سعادة مؤقتة وخراب دائم. لا، لست على استعداد لأن أعض على أصابعي ندماً وحسرة وأُنبذ والشيب يملأ رأسي كما يُنبذُ كلبٌ أجرب.
فجأة وهم غرقى بخيالات التشرد والتعاسة على أبواب أوروبا هبت من النافذة الصغيرة التي تتوسط جدار الردهة ريح باردة اختلطت بها رائحة البحر القوية التي تخترق الصدر وتترك في النفس شعوراً غريباً أشبه بالشجن و الغبطة معاً.
هنا ارتفع صوت الأستاذ علي وصاح متنهداً
– آه يا هدى من يقدر على أن يفرط بهواء عذب كهذا. هل تشمين الرائحة؟ رائحة البحر الذي يريد أن يذكرنا بوجوده، حتى لا ننساه ونحن محشورون بين هذه الصناديق التي تسمى بيوتاً. أين ستجدين بحراً أجمل وأنقى من بحرنا؟ وهذا الشاي الذي أشربه. (في اللحظة ذاتها أمسك بفنجان الشاي بين يديه وراح يصبه في فمه مصدراً صوتاً أشبه بالفحيح) أين يكون لمذاقه حلاوة ولذة كالتي أجدها هنا؟ تعتقدين أنني أبالغ، صحيح؟ ولكنك لن تفهمي هذا الشعور!
– لا، بالطبع فأنا أوافق ما تقول وأفهم شعورك. ولكن دعك من الشاي ومن البحر. الناس أيضاً ما زالت فيهم بذرة خير لم تذهب بعد. لم تتوحش طباعهم مثل أولئك الذين يعيشون في الخارج. بالطبع هناك حسد وسوء خلق وأنانية لكن ليس بذلك القدر الذي لا يمكنك أن تتعايش معه.
– صحيح. ليس بذلك القدر. الطيبة والخير لم ينقرضا بعد. الناس هنا طيبون حقاً ولم يفقدوا انسانيتهم على الرغم من كل ما حدث. لذلك ما زلت أفضل البقاء هنا على أن أنعم بخيرات أوروبا، كان عذر مصطفى باختياره اللجوء وعقباته أنه لا يقدر على احتمال الشقاء هنا. لكن يا لغبائه. يا لغبائك يا مصطفى! اخترت النقود والراحة ولم تفكر أبعد قليلاً. سحرتك أوروبا وأنفدت صبرك. قلت إنك لا تستطيع أن تحتمل بعد شقاء مدينتك الصغيرة و جشع أناسها الطيبين. ولكن، لنرى من سيبكي أخيراً ويشق ملابسه!
هكذا انتهى الحوار اللطيف بين الزوجين بعد أن أقسم كلٌ منهما بحرارة وصدق، ألا يغادر عدن حتى يختلط رفاته بثراها الطاهر الحبيب.
وكما ينقضي كل شيء جميل في حياتنا كالتماعة برق انقضى شتاء تلك السنة سريعاً مثل حلم قصير. وحلّ الصيف مجدداً، جاء ذلك الزائر الثقيل وأطبق بجناحيه الضخمين على المدينة المسترخية فوق بركان خامد. شعر كل كائن حي بذلك الثقل الرهيب الخانق. عادت الوجوه كما كانت رطبة ومبللة وعاد الشعر ليتلبد ويلتزق على الجماجم دون مقاومة. فقدت العيون بريقها وارتسمت من أسفلها هالات غائمة. تصبب العرق من كل مكان وتبلل كل شيء. صار من الصعب أن يتقبل المرء جسده ناهيك عمن حوله، لذا اندلعت شجارات تافهة وأخرى خطرة بين معظم الأزواج. صار المرء أينما حل وارتحل يسمع الشتائم والصراخ. في البيوت وفي الأحياء الكبيرة والحارات الضيقة وفي الدوائر الحكومية والمراكز الخاصة. باختصار لم ينجُ أحد من ذلك الجنون. الكل متوتر وهائج حتى البحر هو الآخر عاد لهيجانه واضطرابه. محطة الكهرباء أيضاً أصابها الهيجان ذاته وتضاعفت ساعات الانقطاع. ست ساعات، ثمان، عشر ساعات، اثنتا عشر ساعة، عشرون ساعة. كان ذلك اختباراً واضحاً للصبر. وبسبب ذلك لم يعد أحد يسير بخفة وانطلاقة، حتى أولئك السعداء فطرة كانوا يجرون أقدامهم جراً. افترش الناس الطرقات. ناموا في الأسطح وفي الأفنية وقرب الأبواب وفي كل مكان قد تصل إليه نفحة هواء. كان وقتاً مظلماً أصاب فيه الإنهاك كل شيء، وشارف فيه الكثير على الهلاك.
في مساء يوم من تلك الأيام الصعبة وفي الردهة التي غمرتها في ما مضى نسائم الشتاء افترش الأستاذ علي وزوجته وطفليه الأرض منتظرين عودة التيار الكهربائي. مضت عشر ساعات ولم يعد بعد. أخيراً غط الطفلين في نوم عميق والمروحة تنفث فوق رأسيهما. لم تكن ثمة مروحة أخرى تساعد على نوم الأبوين لذا بقيا يتصببان عرقاً. كان بيد كل منهما قطعة صغيرة من الورق المقوّى يروح بها عن نفسه، ويخفف عنها هول ذلك الحر. كانت رطوبة الجو تبعث على الاختناق حقاً، ومن حسن حظهما أنهما لم يصابا حتى الآن بأي مرض مزمن، وإلا فإن نهايتهما كانت قريبة حتماً. انتصف الليل ولم يناما بعد. تطلع علي بعيني زوجته التي كانت تحاول النوم عبثاً وهمس قائلاً
– والله الحياة هنا ما عادت ممكنة. ما يحدث معنا غير إنساني وبشع. إلى متى ستستمر هذه الحال؟ إلى متى سنظل نذوق هذا العذاب؟ لو كانت حرباً طاحنة لاحتملتها. في الأقل كنت سأموت ميتة سريعة. أما هذا الموت البطيء، هذا الاستنزاف المنهك، فلا طاقة عندي لاحتمله. تخيلي معي إنساناً معذباً يسحب أحدهم دمه بإبرة صغيرة كل يوم، وبلا توقف إلى أن يزرق جسده، ويضعف نبضه فيصير بعدها جثة هامدة. كيف مات إذًا ذلك الإنسان التعيس؟ لم يمت ميتة سريعة ومريحة، كان يحس بجسده يضعف ويخور يوماً بعد آخر، شاهد جسده ينهار أمامه. لا بد أنه فقد عقله قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
– لن أتخيل شيئا مرعباً كهذا. ولكن برأيك ما الحل؟ لا بد أن نستسلم ونرضى. هذا قدرنا.
– اسمعي، قلبت الأمر برأسي كثيراً وقلت ماذا لو قدمنا طلب لجوء؟
– لجوء؟ إلى أين؟
– إلى أين؟ إلى أوروبا طبعاً!
– أوروبا! ولكن ماذا عن…
– ماذا عن الأطفال، أليس كذلك؟
– نعم.
– سنتدبر أمرهم. أولاً لسنا مجانين نستطيع أن نحافظ على هدوء أعصابنا، ولن نصرخ عليهم أو نعاقبهم. باللين يتعلم المرء ما لا يتعلمه بالشدة. ربما هم على صواب من ناحية معاملة الأطفال.
– لا أظن أنهم على صواب. لكن ماذا عن دراستهم أيضاً؟
– دراسة منزلية مثل الكثيرين هناك. أو ربما سنرسلهم إلى المدرسة ونكون قد غرسنا فيهم قيم ديننا ومبادئه لذا لن يتضرروا إن شاء الله.
– لن يتضرروا! هه! طيب ماذا عني أنا؟ تعرف أنني لا أقدر على البقاء وحيدة بلا أهل ولا جيران. سأموت إن لم أزر أحداً أو يزورني أحد. وأنت تعرف طبيعة الحياة هناك.
– هذا ما تفكرين به! هل فقدت عقلك مع هذا الحر؟ أقول بأننا نموت موتاً بطيئاً وتتحدثين عن الزيارات والجيران. على زعم أننا هنا أرهقنا بعضنا بالزيارات. سنموت وحيدين ونبعث وحيدين هذه سنة الحياة أين المشكلة؟
– لم أقتنع كفاية بما قلت، ليكن بعلمك. طيب، هل فكرت من أين سنحصل على المال للسفر؟ أو هو شيء ثانوي لا يستحق منك التفكير حتى.
– لا بالطبع، فهو أول شيء فكرت فيه. لدينا ما جمعناه أنا وأنت، إضافة إلى أننا سنبيع بعض قطع الأثاث، ونستلف قليلاً من هنا وقليلاً من هناك. يعني أختك في الخارج تعرف وضعنا هنا، وربما يرق قلبها فتساعدنا.
– تقول قليلاً من هنا وقليلاً من هناك! صعب. صعب جداً. هذه مخاطرة. أعطني وقتاً كافياً لأفكر. الأمر ليس بهذه السهولة كما تظن…
فجأة عاد التيار الكهربائي فانقطع وابل الأفكار على رأس الزوجة، وذهب الجميع إلى النوم مستغلين عودة التيار القصيرة.
هكذا أيها الرفاق كما شاهدنا وسمعنا مرات كثيرة، يتغير ما يحسب الناس أنهم مؤمنون به حتى الموت، مثلما تتغير فصول السنة بين صيف وشتاء. ولا يمكن لأي منا إنكار أن المعاناة تضع معظم الناس في مأزق فلسفي لا يُحسدون عليه.
فاطمة ياسر: قاصة من اليمن.