مقامات بديع الزمان الهمذاني
مؤمن الوزان
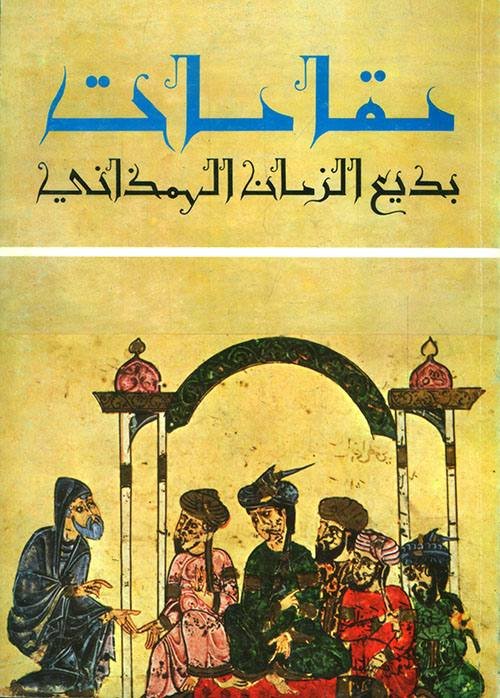
فن المقامة
شقَّ فنُّ المقامة لنفسه مجرًى في الأدب العربي القديم، وسرعان ما ثبَّت أركانه نوعًا أدبيًّا قائمًا بحاله، له أعلامه وشخصياته، وشرَّاحه، وبُنيته التقليدية والمِعيارية التي شهدت محاولات للخروج عنها، والإبداع فيها مثل أي نوعٍ أدبي شعري أو نثري يقبل التغييراتِ ومتطلبات عصره، وتجدُّدَ المواضيع التي تفرض نفسها على بُنية المقامة. وإذا عجزَ النوع الأدبي عن الاستجابة لتغيرات العصر والمجتمع والمتلَّقي سيكون عرضة للاندثار والزوال، وبروز أنواع أدبية جديدة وهذا ما كان مع المقامة. وما الأدب إلا إبداع مستمر وتجديد دائم لا يقف عند زمنٍ ولا نوعٍ واحد فهو مرتبطٌ بالإنسان وعلاقته بمحيطه وبيئته وعالمه والكون، فالتحولات التي تشهدها الأنواع الأدبية أو الظروف المولِّدة لأنواعٍ جديدة كلها خاضعة لفكر الإنسان وخياله وكيف يرى العالم واحتياجاته. ليست المقامة بِبدعة عن هذا، يقول د. عبد الملك مرتاض في كتاب فن المقامات في الأدب العربي مجيبًا عن سؤالِ لماذا المقامات؟ “إنَّ بديع الزمان الهمذاني حيث كتب المقامات التي أقام موضوعها على الكدية إنما استجابة لموضوع كان يشغل أذهان الأدباء في عصره فصاغ كل ذلك في قالب قصصي زاد فكرة الكدة وضوحا ورسوخا في الأدب العربية، ولم يفته أن يعالج مشاكل عصره”1. شهدت المقامات انطلاقتها الرسمية ببُنيتها المتعارف عليها وأعرافها مع بديع الزمان الهمذاني في العقد التاسع مع القرن الرابع الهجري، كما هو مرجَّح ويقوله غير واحدٍ أشهرهم الثعالبي النيسابوري. لكنَّ هذه الانطلاقة أشرعت الباب على مصراعيه في البحث عن أصول المقامة ونشأتها ومصادرها، وهل كان الهمذاني أول من كتب المقامات، وهل يُمكن للمقامة أن تنبتَ من صدع الأرض، وقبل كل هذا ما معنى المقامة، وهل استخدم العرب لفظة مقامة وما عنوا بها؟ أسئلة كثيرة تُطرح في هذا الحقل الدراسيّ الخاص بتاريخ المقامة منذ النشأة الأولى والعناصر المُساهمة سواء البُنيوية أو الموضوعيّة في وصول المقامة إلى صيغتها الأخيرة المعروفة.
تُحيل كلمة مقامة إلى ثلاثة معانٍ، تعضدها أشعار العرب قبل الإسلام، هي المجلس والنادي (مكان التجمُّع والحديث)، والجماعة، وأطلقَ أيضًا لفظ المقاماتِ على الأحاديث الوعظيّة. وأخذت مع الهمذاني معناها الاصطلاحي، وهو معنى لا يخرجُ كثيرًا عن الأصل المستخدم، وهو حديث يُلقى في جماعة من الناس، لكن هذا الحديث كما في بعض المقامات ليس بالضرورة أن يُلقى في جماعة من الناس، فقد يكفي أن يُقال لرجلٍ واحد. يغلب التسوُّل أو الكُدية (مهنة التسوُّل) غايةَ هذا الحديث، ولأجل هذه الغاية، التي تُوجب استدرار عطف الناس وأموالهم، فلا بد أن تكون بلغة فصيحة بليغة يعرضُ بها المتحدِّثُ مسألته ويشكو حاله ويؤثر فيمن يستمع إليه. لكن هذا الحديث وإنْ كان لبَّ المقامة فهو ليس العنصر الوحيد في بنائها فكان لزاما إلى توطئة افتتاحية ثم الحدث الرئيس ثم النهاية، وفي هذه الأجزاء الثلاثة الرئيسة تتشكل لدينا بُنية المقامة كاملة، فيقودنا هذا إلى الوقوف على نصٍّ أدبي كامل وقائم بذاته ذي بُنية ثابتة أشبه ما يكون بالقصة، بمعناها المتعارف عليه اليوم، وهي كذلك بالفعل. يسأل مارون عبود في كتابه بديع الزمان الهمذاني “هل المقامة قصة؟ نعم يا سيدي، إنها قصة. والفرق بينها وبين قصص اليوم كالفرق بين هندامك أنت وهندام جدك، رحمه الله ورحمني معه. لكن ليست كل مقامات البديع قصصا فقسم منها لا شيء، والقسم الآخر شيء عظيم. وحسب الرجلَ ما خلق. إنه لفنان بديع”2. ويقول عبد الملكِ مرتاض بأن “فن المقامات للبديع يدخل في باب القصص على حين مقامات الزهَّاد أو العباد تندرج في إطار الخطب والعظات والأحاديث أو الحكايات…”3.
يعترضنا سؤال مهم في هذا الحقل كيف استلهمَ الهمذاني فن المقامة، وهو سؤال خاض به الباحثون والدارسون ولم يتوقَّفوا فنقَّبوا في كتب التراث وشرَّقوا فيها وغرَّبوا وما تركوا نصًا لم يقصدوه ويستقرأوه ويستنطقوه بحثًا عن إجابة تبدد الغيوم عن حقيقة أصول المقامات وريادة الهمذاني لها، والأسئلة الأخرى التي تصبُّ في المجرى نفسه. والحقيقة أنَّ النتائج، مع بعض اختلافها، تصل إلى حقيقة واحدة وهي أنَّ المقامة أخذت مع الهمذاني شكلها وبُنيتها وسار على نهجه من تبعه، وإن لم يكن أول من كتبَ مقامة، التي أشرنا في أن معناها قبل الهمذاني الحديث في جماعة أو الموعظة أو الحكاية. تعود أول إشارة إلى هذا الموضوع ما ذكره الحُصْري في كتابه زهر الآداب وثمر الألباب4: “ولمّا رأى أبا بكرٍ بن الحسين بن دريد الأزدي أغربَ بأربعين حديثًا وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، واستنخبها من معادن فكره، وأبداها للأبصار والبصائر، وأهداها للأفكار والضمائر، في معارض أعجمية وألفاظ حوشية فجاء أكثرُ ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع ولا ترفع له حُجبها الأسماع وتوسَّع فيها إذ صرَّف ألفاظها ومعانيا في وجوه مختلفة وضروب متصرِّفة، عارضها [أي الهمذاني] بأربعمئة مقامة في الكُدية، تذوب ظرفا وتقطر حسنا، لا مناسبة بين المقامتين لفظًا ولا معنى، وعطفَ مُساجلتها، ووقفَ مناقلتها، بين رجلين سمّى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبا الفتح الإسكندري…”.
يقول الحصري بأن أبا بكرٍ ابنَ دريد (تُ. 321 هـ) جاء بأربعين حديثا من إبداعه بلغت الهمذاني، فعارضها بكتابة أربعمئة مقامة في الكدية؛ رواها عيسى بن هشام من أخبار أبي الفتح الإسكندري. يوردُ أبو علي القالي الكثيرَ من أحاديث ابن دريد، فاقت الأربعين خبرًا وحديثًا، في كتابه الأمالي، وهي أحاديث فيها الخبرُ والحكاية والشعر وفي غالبها ذات غاية لغوية، لكن في بعضها حكاياتٌ ذات لفظ رفيع وأسلوب بديع، والسجع فيها واضح أصيل راقٍ غير مكرر أو مبتذل. وبعضها خطبُ وموعظة في الناس كما في المقامة، وفيها أحاديث مثل حديث وصف الفرس الذي نجد له شبيهًا في المقامة الحمدانيّة عند الهمذاني. إنَّ الفيصل الذي نتحكم إليه في هذا الموضوع هو ما المعيار في القول إنَّ هذا النص مقامة أو ليس بمقامة؟ فيصلنا في هذا هو الاتفاق على تعنيه لفظة مقامة أي التفريق ما بين المقامة من الناحية التاريخية والمقامة من الناحية الإبداعية، فلا يُنكر قارئ وجود مقامة بمعنى الحديث في جماعة قبل الهمذاني كما في أخبار الزهّاد والعبّاد، لكنها مع الهمذاني أخذت طابعًا آخر هو المتعارف عليه من بعده ببنيتها المميزة ولغتها مواضيعها: إذ يقوم راوٍ ثابتٍ برواية المقامة يُقدِّم فيها حاله وأخباره، ثم يجتمعَ برجلٍ يتحدث بفصاحةٍ وبيان لا نظير لهما من أجل نيل المال من الناس (الكدية)، ثم يعرف فيه شخصَ أبي الفتح الإسكندري. وهذا ما يُشير إليه د. عبد الله إبراهيم في حديثه عن الريادة الإبداعية وضرورة تفريقها عن الريادة التاريخية5، وهذا ما أوقعَ بعض دارسي المقامات في الخطأ وعدم التفريق بينهما كما فعل زكي مبارك، والريادة الإبداعية يشهد بها الحريري في خطبة افتتاحية مقاماته: “وقد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه، وخبت مصابيحه، ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان، علّامة همذان، رحمه الله تعالى. وعزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها، وإلى عيسى بن هشام روايتها، وكلاهما مجهول لا يُعرف، ونكرة لا تَتَعرَّف. فأشار من إشارته حُكمٌ، وطاعته غُنْمٌ، إلى أن أنشئ مقاماتٍ أتلو فيها تِلوَ البعيد وإن يدرك الظالع شأو الضليع… هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سبَّاق غاياتٍ، وصاحبُ آياتٍ، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة، ولو أوتي بلاغة قدامة، لا يغترف إلا من فُضالته ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته”. ويقول القلقشندي (ت821 هـ) في كتاب صبح الأعشى “إن أول من فتح باب المقامات علامة الدهر وإمام الأدب البديع الهمذاني”6.
إنَّ الريادة الإبداعية في فنِّ المقامة هي من حقِّ الهمذاني بلا ريبٍ، بل هو المؤسس لفنِّ المقامة، وما أخذت المقامة إلا معه معناها الاصطلاحي ووظيفتها الأدبية، وصارت نوعًا أدبيًا يكتبُ فيه الكتَّاب من بعده يحذون فيه غالبًا حذوَ القذَّة بالقذَّة وينطبقون عليه انطباق الحافر على الحافر. لقد أسَّسَ الهمذاني بُنية المقامة، وشهدت مقاماته أكثرَ من بُنية واحدةٍ وإنْ غلبَ عليها البُنية الرئيسة، التي صارت تقليدية ومعيارية، فهو استلهمَ فكرة المقامة وجزءًا من بُنيتها مما سبقَ لكنه أعطاها هيكلة جديدة وبُنية مختلفة التزمَ بها في كتاباته. وهنا لا بد من طرح مسألة مهمة جديدة، وأراها ضروريةٍ جدًا في أي مسألة تخصُّ الريادة الإبداعيّة، وهي هل كتبَ الأديب هذا النصَّ ببُنيته الفريدة عن وعيّ منه وإرادة أو إن الأمر بمحض الصدفة من دون سابقٍ إدراك ورغبة؟ لا تكمن الإجابة هنا إلا بتفحُّص النص المكتوب والمنسوب لهذا الأديب. بتفحُّص مقامات الهمذاني نرى بأنه عارفٌ بما يكتب وواعٍ بالطريق الجديد الذي سلكه في الكتابة، بل إنَّ أي عوار وضعف وخلل سيكون جليًا في النصِّ لا تُخطئه عينٌ بصيرة، فلا يوجد من سبق الهمذاني في بناء جسد النص على هذا النحو: براوية وبطلٍ ثابتين يُشكلان بحركتهما في محيطهما تفاعلهما الثنائي فيما بينهما والعالم الخارجي مادةَ المقامة وموضوعَها في الكُدية حيث يلتقيان ويفترقان، بلغةٍ ذات محسنات لفظية ومعنوية يطغى عليها السجع. وأثبتَ للهمذاني مقامه التزامُ من أتى بعده بمنهجه ونظامه، وهذا ما فعله الحريري في مقاماته الخمسين ومن جاءوا خلفه.
*
أما الإجابة عن سؤال مصادر مقامات الهمذاني (لهذه المصادر تأثيرٌ في نشأة فن المقامة) ومواضيعها فهي عريضة مترامية الأطراف، ولا سيما أحاديث الكُدية والوعظ والنوادر والشعر، وأحسنَ د. عبد الملكِ مُرتاض في جردِها والتعليق عليها: مقامات الزهاد (وهي أحاديث يقولها الزهَّاد في حضرة الأمراء والملوك غايتها الوعظ)، وأخبار الأعراب (وهي أخبار تبرزُ فيها البلاغة والفصاحة العالية لاستعطاف المستمع ليمد لهم يد المعونة)، أخبار المتطفلين (وهم الذين يتطفلون على الناس في محافلهم لنيل عطاياهم والأكل معهم)، والمرويات الحكائية المسجَّعة والأدب العربي القديم حافلٌ بها، وأحاديث ابن دريد التي سبق الحديث عنها. وأهم مصدرين استلهم منهما الهمذاني هما القصيدة الساسانية، وهي قصيدة طويلة ينظمُ فيها أبو دُلَفٍ الخزرجي أخلاقَ المكدين ونسبهم إلى ساسان وأحوالهم وحيلهم وكلَّ ما يخصُّ عملهم، ونلمس تأثيرها الواضح والبارز في المقامة الرِّصافيّة. يصف عبد الملك مرتاض هذه القصيدة بأنها “دستور حقيقي لفن الكدية الذي أقيم عليه فن المقامات بزعامة البديع”. أما المصدر الآخر المهم في مقامات الهمذاني فهو كتابات الجاحظ لا سيما في فرعين: الأول وصية خالد بن يزيد لابنه، ونرى في هذه الوصية من الألفاظ والعبارات التي ترد في مقامات الهمذاني، بل إنَّ مقامة الوصيَّة، وهي وصيّة أبي الفتح الإسكندري لابنه، مشابهة تمامًا لوصية خالد بن يزيد، ولا ريب في أنَّ الهمذاني جاراها حذو النعل بالنعل، وابتنى جزءًا من شخصية أبي الفتح الإسكندري استنادًا إلى خالد بين يزيد، كما يُرجّح مُرتاض. والفرع الآخر من أدب الجاحظ فالمتمثل في أخبار البخلاء ونجد ذلك في المقامة المضيريّة، وحديث الكدية للجاحظ، الذي يرويه عن شيخٍ، فيه عن حالِ هذه المهنة وأحوالها، ونرى أيضا أن جزءًا من صفات الإسكندري وسلوكياته وطبيعة حياته الجوَّالة المعتمدة على أموال الناس مبنيةً على ما تركه الجاحظ في هذين الفرعين.
لكن الهمذاني لم يقتصر على هذه المنابعِ الرئيسة في استلهام مادته فنراه كما في المقامة الإبليسية يجمحُ بخياله ويُجسِّد شخص إبليس، الذي ظهر بهيئة شيخ اسمه أبو مرة، وهي كنية إبليس، ليخبره بأنه أملى على جرير قصيدةً شهيرة له، وإنَّ لكل شاعرٍ شيطان شعرٍ. لم تكن هذه الفكرة من إبداع الهمذاني فقد شاعَ عند العرب وادي عبقر وزعموا أن شياطين الشعراء تسكنه، لكن ما يُحسب للهمذاني هو أخذ هذا الزعم والفكرة إلى بُعدٍ آخر. ونهج ابنُ شُهيد الأندلسي (382 – 426 هـ) على نهجها رسالته الشهيرة التوابع والزوابع، وهي رحلة الشاعر في أرض الجن حيث التقى أصحاب الشعراء من الجن وأسماهم الزوابع، وأصحاب الكتَّاب من الجن وأسماهم والتوابع. التقى من أصحاب الكتَّاب ثلاثةً أحدهم صاحب الهمذاني وأسماه زبدةَ الحِقب. كان لهذه الرسالة تأثيرها في شيخ المعرة، أبي العلاء المعري، في كتابة رسالة الغفران، وأرسلَ ابن القارحِ في رحلة إلى العالم الآخر. تبرزُ كذلك مصادرُ غير عربيّة استهلم منها الهمذاني مقامته البِشرية، عن بِشر بن عوانة قاتل الأسد. في ورقة بحثيّة بعنوان “أسطورة يونانيّة في مقامةٍ لبديع الزمان الهمذاني”7 يقدّم الأستاذ محمد الهدلق مقاربةً ما بين المقامة البِشرية وأسطورة هرقل وأعماله الاثني عشر. أوضحَ الهدلق ثلاثة تشابهات ليست باعتباطية ولا مصادفة ما بين مهام هرقل الاثنتي عشرة وبين المقامة البشرية لا سيما في قتل الأسد والأفعى، وموت هرقل وقتلَ بِشرٍ المعنوي على يد ابنه. وتكشفُ بوجهٍ أو بآخر وصول خبر هرقل وأعماله إلى الهمذاني الذي اقتبس منها وأعاد إبداعها في صياغة جديدة تتلاءم من البيئة العربية بدقةٍ كبيرة في نسجٍ مقامته، حتى ظنَّ بعضُ الدارسين أنَّ بشر بن عوانة شاعر جاهلي من صعاليك العرب وما حسبوا قطُّ أنّه من ابتداع خيال الهمذاني مثل عيسى والإسكندري.
*
يجدرُ بنا قبل الانتقال إلى الجزء التالي من مقالتنا التوقُّفَ قليلا عند نصٍ قريبٍ في بُنيته من مقاماتِ الهمذاني، ولا يُعدمُ تأثيره في نصوصٍ لاحقة، هو حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي، وهو نص مغمورٌ لا يُعرفُ الكثير عن كاتبه إلا من نصِّه إذ يشيرُ إلى أنه عاش في القرن الرابع الهجري: “ولَعهدي بهذا الحديث سنة ست وثلثمائة…”. يقدِّم للحكاية مؤلفها، الشيخ الأديب أبو المطهّر محمد بن أحمد الأزدي، وهو السارد العليم لهذا النص، وفي جملة ما يذكره في تقديمه موجزًا الحكاية وغايتها ووقت قراءتها فيقول: “هذه حكاية رجل بغدادي كنت أعاشره برهةً من الدهر فتتفق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة، وعباراتٍ لأهل بلده، مستفصحة ومستفضحة، فأثبتها في خاطري لتكون تذكرة في معرفة أخلاق البغداديين على تبيان طبقاتهم، كالأنموذج المأخوذ من عاداتهم…”. ويقدّر زمن قراءتها فيقول: “وإذ قدمت هذه الجملة فأقول: هذه حكاية مقدَّرة على أحوال يوم واحد، من أوله إلى آخره، وليلة كذلك، وإنما يمكن استيفاؤها واستغراقها في مثل هذه المدة، فمن نشط لسماعها، ولم يعد فصولها تطويلا وفضولها كلفة على قلبه، ولا لحنا يرد فيها من عباراتهم، قصور معرفة يعيّرني بها، لا سيما مع انتهائه منها إلى الحكاية البدوية الأدبية (هذه الحكاية مفقودة ولا توجد ضمن مخطوطة حكاية أبي القاسم) التي أردفتها بها…”.
ومع أن النص ليس حكاية بالمعنى الفعلي فلبنيتها الداخلية جو عام متناسق فتتقدم في نَفَس سردي ثابت يخترقه الشعر ليدعمه لا ليشتته، ولا نشعر بوجود حكاية أكثر من حديث أبي القاسم في مجلس في أصفهان يذكر فيه بغداد ومحاسنها وأهلها وخيراتها ويذم أصفهان وأهلها وكل ما فيها بسخطٍ وقسوة، ويروي أخبارًا وحكاياتٍ قد تناهت إليه أو عرفها وعاصرها. فهي حديث سمر لا حكاية لها غاية القصة المعروفة اليوم ولا بنيتها ولا حبكتها. تبرز المقابلة ما بين بغداد وأصفهان مادةً رئيسة لحديث أبي القاسم البغدادي فيمدح كل ما في بغداد من جو وطبيعة وطعام وشراب ونبات وثياب ومجالس الهوى والسمر وجوارٍ وكل ما يخطر في باله، ويذم أصفهان وكل ما فيها ذمًا قبيحًا ويشنِّع على أهلها تشنيعًا فظيعًا، فيملأ حكاية بالسباب والشتائم متخيِّرًا أقبحها وأشنعها، لذا فنراه يتقلب من أقصى اليمين في المدح والثناء إلى أقصى الشمال في الذم والانتقاص، وما بين هذين النقيضين يدور حديثه وينتقل من موضوع إلى موضوعٍ يحدِّث به حضوره الذين غُيِّبوا وأشيرَ إليهم بالمبني للمجهول في جلِّ المرات، فيتسيّد صوت أبي القاسم على الحكاية ولا نكاد نسمع صوتَ آخر مباشرٍ إلا ما يشير إليه الراوي، لكنها إشارة لا نشعر معها بوجودٍ ماديّ لمن يُجالسه إلا بما يقدح شرارة شتائمه من جديد أو يُسفِّه بهم ويذم بذكر بغداد ومحاسنها. ويُمكن أن نسشتفَّ من حكاية أبي القاسم البغدادي سماتٍ برزت في مقامات الهمذاني هي الحديث في مجلس، عدم التورِّع في استخدام الألفاظ والشتائم أو عدم الالتزام بخُلقٍ عام كما نرى في مقاماتٍ الرصافيّة والديناريّة والشاميّة، والراوي الجوَّال وهو حال عيسى بن هشام وصاحبه الإسكندري، وجود الشعر في بُنية الحكاية. فهذه الحكاية وإن لم تكن شهيرة كسائر المصادر التي ساهمت في الهمذاني للمقامة فإنَّ لكاتبها فضلًا وتأثيرًا ولو على نحو غير مباشر.
ختاما لا يعيب الهمذاني هذا الاستلهام، فقد جمعَ ما تناثر وصبَّ في مجراه ما تغاير، وما الأدب إلا خلاصة التجارب الذاتيّة والغيرية والمعرفة المباشرة وغير المباشرة والتجربة الإنسانية جمعاء، فليست وظيفة الأديب المبدع أن يختلق أفكاره من العدم حَسْب ويقدِّمها في قالب أدبي راقٍ بل يكون أيضًا في إعادة القراءة والتجديد للقديم، لا سيما في العصور الخالية إذ الإبداع فيها لا يقتصر على الإتيان بالجديد فهو في إعادة صياغة القديم ومحاكاته والنسج على منواله. ولا يخص هذا أدبَ جماعة من الناس فهو عامٌ يشملُ جميعَ من خطَّ بالقلم في خالي الأمم.
بنية المقامة
تطغى على مقامات الهمذاني بُنية متشابهة في جُلِّها، أضحت فيما بعد البُنية التقليديّة للمقامة، أكَّدها الحريري في مقاماته، وهي تقوم على أجزاءٍ ثلاثة رئيسة:
1- التوطئة. يروي فيها الراوي (عيسى بن هشام عند الهمذاني) حاله، كأن يكون في سفرٍ أو تجارةٍ أو جماعة من الناس في نادٍ أو سوقٍ. يعمل هذا الجزء الموطِّئ في تهيئة المتلقّي للجزء التالي الذي يُمثِّل قلبَ المقامة وغايتها.
2- الحدث الرئيس. في هذا الحدث الرئيس تظهر شخصية رئيسة -أو أكثر- تتميَّزُ بأنها تتحدَّث حديثا بليغًا ذا مُحسِّنات لفظية ومعنوية، وغاية الحديث في الغالب استحصال المال بالحيلة أو المعونة من المستمع (كُدية)، وتكون مُتنكِّرة لا يعلم السامعون حقيقتها، ثم تغادرُ المكانَ بعد نيل المُراد.
3- الملاحقة وكشف الحقيقة. غالبًا ما يدفعُ الفضول والشكُّ الراويَ للحاق المكدَّي لمعرفة حقيقته، أو أن يعرفَ من بيانه وبلاغته شخص صاحبه (أبو الفتح الإسكندري عند الهمذاني).
في خضمِّ هذه الأجزاء الرئيسة الثلاثة للمقامة تتفاعل الشخصيات ويُنتج الحدث في المقامة فتتبيَّن غايتها وموضوعها، وسمات الشخصيات وسلوكها، وحقيقة الناس الذين نكَّروا أنفسهم حتى لا يُعرفون. إنَّ أبرزَ ما في المقامات هو التفاعل الثنائي ما بين الرواي/ الشخصيّة وبين الشخصية الرئيسة التي يقوم عليها الحدث ويتمحور حولها. لكنّ المقامة لا تعدمنا تبيُّن كون عيسى بن هشام هو الآخر شخصية رئيسة وإن قام بأخذ دور الراوي، ويُضفي عليه وظيفة أخرى يؤديها، فهو مشاركٌ في الحدث وراوٍ له. ونجد أنَّ ثنائية الراوي والشخصية المشاركة تتبدل، فنجد في مقاماتٍ أنَّ عيسى يتحول إلى الشخص الفاعلِ الباني للحدث دون مشاركة الإسكندري كما في المقامة الإبليسيّة أو أن يكون النصف الأول من المقامة خاصٌ بعيسى كما في المقامة الأسديّة، وهي مقامة تشهدُ نضجًا فائقًا ونموذجًا أعلى لنصِّ المقامة. وفي مقامات يقومُ الإسكندري بوظيفة الراوي كما في المقامة المضيرية ومقامة الوصيّة. في حين تغيب عن مقاماتٍ أخرى كالبشريّة والغيلانيّة هذه البُنية التقليدية ويكون عيسى راويًا مفارقًا لمروِّيه يحكي عما لم يشهده بعينه، أو يكون راويا ثانيا بعد الراوي الأول الرئيس وهو الآخر راوٍ يلعب وظيفة ثنائية في الرواية والتفاعل المُنتج للحدث.
يُشيرُ د. عبد الله إبراهيم إلى عنصرٍ فنيّ وردَ في المقامات وهو غيابُ الإسناد الطويل والاكتفاءُ براوٍ واحد، وهو حسبُ خلاصته، أدَّى إلى خلخلة الإسناد وتجاوز وظيفة القديمة فجاءت الأخبار طليقة من القيود التي كانت تحبس المتون في أطر مغلقة. مما يعني أننا نشهد في بنية المقامة تحرَّرًا من الأعراف السائدة بروايةِ الحديث، لا سيما الحديث النبوي، وما للإسناد من أهمية في ضبطِ الحديث ورجاله وبيان درجته، لكن ما نقفُ قُبالته هو ضربٌ آخر للسند متمثلًا بسؤال مَن الذي يروي عن عيسى؟ إذ تبدأ مقامات الهمذاني جميعًا بصياغة واحدة تقريبًا وهي “حدَّثنا عيسى بن هشام قال”. نجهل من الذي يروي هنا هل هو الهمذاني أو شخصٌ غيرُه، الراجحُ هو الهمذاني لكن كونها مقاماتٍ مُتخيَّلة فإنَّ حقيقة الراوي هنا مثارُ شكٍ وتساؤل، وهو الضرب الأقوى لبُنية السند إذ الخبر يرويه مجهول لا يُعرف مما يجعل الخبرَ برمَّته عُرضة للتكذيب فلا يُعرف راويه ولا أخلاقه ولا صدقه من كذبه. بيد أنَّ السؤال المعارضَ هل نحن بحاجة إلى معرفة حقيقة هذا الراوي المتواري في فعلٍ واحدٍ “حدَّثنا” فاسحًا المجال كلَّه لعيسى بن هشام، كأنه هو الراوي الأول وما المتلقِّي إلا واحدٌ من الجماعة التي كان يُحدّثها عيسى بن هشام. وهنا نجد أنَّ ثمة مقامة خفيّة، قد يجوز لنا تسميتها بالمقامة الإطارية، تضم المقامات الأخرى أشبه ما تكون بالحكاية الإطارية. لا يدلُّنا شيء إلى المقامة الإطارية سوى جملة “حدَّثنا عيسى بن هشام قال”، والمقامة الإطارية تأخذ معنى “الحديث في الجماعة أو المجلس”، والمتحدِّثُ هو عيسى بن هشام والمستمعون هم من يروون عنه أو مِن بينهم مَن يروي عنه في “حدَّثنا”، وتضمُ هذه المقامة الإطارية المقامات التي رواها عيسى بن هشامٍ سواء في مجلسٍ واحد أو مجالس عدَّة. وهنا يبرزُ لدينا معنيانِ للمقامة المعنى القديم وهو الحديث في الجماعة والمعنى الاصطلاحي الذي شرعَه الهمذاني في مقاماته، وكلاهما موجود في كلِّ مقامة، إذ مقامات الهمذاني أولًا حديثٌ في مجلس، وثانيًا قصةٌ مسجوعة عن الكُدية براويةٍ وبطلٍ يتعارفان في نهايتها ثم يفترقان.
عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري
يتشاركُ عيسى بن هشام وأبو الفتح الإسكندري في تسيّد شخصيات المقامات وأحداثها، فالحدث في كلِّ مقامة هو نتاج تفاعل عيسى والإسكندري، فيُشكِّلان معًا بتفاعلهما بُنية المقامة. يلعبُ عيسى دور راوية الحدث ويلعب الإسكندري دور الفاعل في الحدث، قد تنقلب الأدوار أحيانا أو تتبدّل أو يتشاركان في الفعل لكن السائد هو اقتران عيسى بالرواية والإسكندري بالفعل. إنَّ ما يجمع عيسى بن هشام بأبي الفتح الإسكندري أكثر من صداقة ومعرفة، بل أشبه ما يكون بتبعيّة الأول للثاني، لكنها تبعيّة من نوعٍ مختلف تبعيّة تقوم على الصدفة وغايتها الفضول. يلتقي عيسى في تجواله وأسفاره برجلٍ غريبٍ ذي فصاحة وبيانٍ فيتبعه ليعرفَ هويته. صحيحٌ أنَّ الفضول هو محرِّك عيسى لكن لهذا الفضول دافعٍ نفسيّ متمثل بسؤال هل هذا هو صاحبي؟ فيلاحقُ الرجل الغريب فيعرفُ فيه أبا الفتح، أو أنه يعرفه في أثناء حديثه فيتّجه إليه. نرى في ذلك أنَّ الإسكندري ثابتٌ في مكان وعيسى ينجذب إليه، وحتى في تلك المقامات التي رافق فيها عيسى أبا الفتح الإسكندري فإنَّ تبيعةَ عيسى واضحةٌ كما في المقامة الموصليّة. عند تفحُّص هذين الشخصيتين تبرزُ لنا سماتٌ لازمة لها فهي تتشابه في بعضها وتتنافر في أخرى، فعيسى رجلٌ غنيّ يتجوَّل مسافرًا بين البلاد يعملُ تاجرًا أحيانا، ويكون سعيه في سفره أحيانا أخرى هو طلبُ شواردِ الألفاظ ونوادرها أو معانيها، فهو ليس في سعي لطلبِ العلم بل لطلبِ نوعٍ محددٍ من اللغة يقوم على غير الشائع. لنتخيَّل حالَ رجلٍ يُسافرُ على مطيّته من بلدٍ إلى آخر مُتعبًا نفسه في القفار والبراري ومُعرّضًا نفسه لأخطار الطريق واللصوص ومغامرًا في الخروج، ولأجل ماذا؟ لأجل كلمة لم يسمع بها أو معنى بليغ لم يصل إليه. إنَّ عيسى رجلٌ فريدٌ من نوعه فأين ذيَّاك النظير! وهو يكشفُ بهذا السلوك أنَّه أديب وعارفٌ بالشعر والأدب واللغة كما المقامة في القريضيّة، وهو كريم وشجاع كما في المقامة الأسديّة، ومجاهد يخرجُ للجهاد في الثغور كما في المقامة القزوينيّة. وبتقدِّمِ عيسى بن هشام بالعمرِ نرى أنَّ له صيتًا وشهرة كما في المقامة المغزليّة إذ يقول “دخلتُ البصرة وأنا متسع الصيت كثيرُ الذكر”، ووُلِّي ولايات كما في المقامة التميميّة إذ يقول “ولِّيت بعض الولايات في بلاد الشام”، أو توليّه القضاء كما في المقامة الشاميّة إذ يقول “لما ولِّيت الحكم في بديار الشام”. إنَّ عيسى بن هشام الذي أمامنا رجلٌ ذو سماتٍ كريمة، ومرَّ في حياته بمراحلَ مختلفة قلَّبته في أحوال شتى فمن طيش الشباب إلى وقار الكبار، وأكسبته معرفته للإسكندري ومرافقته تعرُّفًا على الجانب الآخر من النفس البشريّة حيث الخداع والمكر والحيلة وسلب أموال الناس بالباطل. يجدرُ الإشارةَ أيضًا إلى أنَّ عيسى بن هشام مثل الإسكندري، لم يخرجْ للحياة على نمطٍ واحدٍ فقد مرَّ بمراحلَ مختلفة في إبداعه قبل أن يصل الهمذاني إلى النمط الأخير في مقاماته، وتحديد ملامح شخصيّة عيسى بن هشام وإسناد مهمة الرواية إليه. فمثلا كان عيسى في المقامة البغداذيّة فقيرا محتالا خدع الرجل السواديّ حين جعلَ يأكل على حسابه دون أن يفطنَ السواديُّ إلى حيلته. السؤال الأخير قبل الانتقال إلى الإسكندري من أي بلدٍ هو عيسى؟ لا تكشف المقامات عن موطنه الحقيقي، فهو دائم السفر والتجوال ونجد إشارة إلى الوطن في ثلاث مقامات هي متتابعة زمنيا حسبما أرى، ومع أنها في أثناء عودة عيسى بن هشام من اليمن إلى الوطن فلا نعرف أيَّ وطن سيصل إليه إلا في المقامة الشيرازية، وحتى هي لا يمكننا أن نقول فيها إن شيراز موطنه. يقول في المقامة الفزاريّة “وأنا أهمُّ بالوطن فلا الليل يثنيني بوعيده ولا البعد يلويني ببيده…”. ويقول في المقامة الملوكيّة “كنت في منصرفي من اليمن وتوجُّهي إلى نحو الوطن…”. ويقول في المقامة الشيرازيّة “لما قفلت من اليمن وهممتُ بالوطن…” فيتقدَّم زمنيًا بعدها ليقول “حتى أتيتُ شيراز. فبينا أنا يوما في حجرتي إذ دخل كهل قد غيَّر في وجهه الفقرُ…”. هل شيرازُ موطنه، هذا ما يبدو عليه إذ جملة “فبينا أنا يوما في حجرتي” تُشير إلى ذلك، لكن هل هذا حقيقيٌّ أو تُراه يرى في كلِّ بلدٍ يستقرُّ فيه موطنَه؟ هو أقرب إلى ذلك كما في المقامة القريضيّة واستقراره في جُرجان.
إنَّ الحديث عن وطن عيسى يأخذنا إلى الطرف الرئيس الآخر في مقامات الهمذاني وهو أبو الفتح الإسكندري، البطلُ الذي حرَّك المقامات وأحداثها ولغتها وبؤرة قوَّتها وانبثاقها. أما اسمه فغير معروف، وكنيته فأبو الفتح، ولعلَّ الفتحَ هنا أنَّ الله فتحَ عليه مجاهلَ اللغة وعلومها ومغاليق الفصاحة وبيناها وخزائن الشعر وعوالمه القصيّة، ولقبه فهو الإسكندريّ، لكن أيُّ إسكندرية بالضبط فهذا ما نجهله، وسنتجول قليلًا بحثًا عن مسقطِ رأسه. يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان8: “قال أهل السير: بنى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمَّاها كلها باسمه ثم تغيَّرت أساميها من بعده، وصار لكل واحدة منها اسم جديد… ومنها الإسكندرية التي بأرضِ بابل، ومنها الإسكندرية التي هي ببلاد الصُّغد وهي سمرقند، ومنها الإسكندرية التي تُدعى مَرغبلوس وهي مرو [في تركمانستان]… ومنها الإسكندرية التي سُميت كوش هي بَلخ [في أفغانستان]، ومنها الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصر”. ذكر الواقدي مواضعَ بلداتٍ أخرى سُميت بالإسكندرية، وما نقلته أعلاه هي المدن التي يُرجَّحُ أنَّ أبا الفتح الإسكندري انحدر منها، ولم يذكر الهمذاني أي مقامة أبعد مكانًا من الشام غربًا، لذا أستبعدُ أن تكون إسكندرية مصر هي المقصودة، فتبقى أمامنا الإسكندرية في بابل وسمرقند ومرو وبلخ، فمن واحدةٍ منها ينحدر الإسكندري، وربما لا ينحدر من أي منها فهو من كلِّ البلاد، الطوَّاف في الأرض، المتجوِّل بين مدنها، لا يُعرف له مُقام ولا وجهة، ينتمي إلى كل بلاد الإسلام. وإن كان انحداره من الإسكندريّة التي أكَّدها كثيرًا، فهو متعدد ومتنقّل. يقول شعره في غير مقامةٍ واحدة:
أنا جوَّالةُ البلا * د جوَّابة الأفق
أنا خُذروفة الزما * ن وعمَّارة الطُّرق
لا تلمني لك الرشا * د على كُديتي وذُق
ويقول:
إسكندريّة داري * لو قرَّ فيها قراري
لكن ليلي بنجدٍ * وبالحجاز نهاري
وأبو الفتح الإسكندري ليس رجلًا منحدرًا من الإسكندرية يجوب بلاد الإسلام وحدها، لكنه ينتسبُ كذلك إلى أكثر من قوم. فيقول:
إنَّ لله عبيدًا * أخذوا العمرَ خليطا
فهمُ يمسون أعرا * بًا ويضحون نبيطا
ويقول:
أنا حالي من الزما * نِ كحالي من النسب
نسبي في يد الزما * نِ إذا سامه انقلب
أنا أمسي من النبيطِ * وأُضحي من العرب
أما قومه فهم بني ساسان، ولهذه النسبة للمكدِّين إلى ساسان تأويل مشهور بأنها إشارة إلى الذل والهوان الذي أصابهم بعد سقوط إمبراطوريتهم على يد الجيش الإسلامي، وكان آخر ملوكها يزدجر بن شهريار بن كسرى أبرويز بعد أن دام حكمه عشرين سنة. تذهب الحكاية المتداولة بأن يزدجر عملَ مُكدِّيًا بعد سقوط إمبراطوريته وهزيمة جيشه، لكنَّ الفردوسي في الشاهنامه، ملحمة ملوكِ فارس، يقول غير ذلك9. يذكر الفرودسي أنَّ بعد انتصارَ جيش سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) في القادسية وأخذه المدائن؛ أرسلَ ماهويه، وزير يزدجر، إلى ملكِ سمرقند وهو من الترك يُطمّعه بالبلاد فأقبلَ بجيشه إلى مرو حيث كان يزدجر. تقابل الجيشان وبخيانة ماهويه هُزمَ جيش يزدجر ففرَّ من المعركة واختبأ في طاحونة، فلما جاء الطحَّان وأبصره طلبَ منه الشهريار، يزدجر، بعض الطعام فذهبَ وأخبر زعيمَ الرزق في القرية بحال ضيفه وطلبه الطعام، وعلم من الوصفِ أنه يزدجر فدبَّر مكيدة لقتله فقتله بخنجرٍ مسموم في الطاحونة.
يمتازُ أبو الفتحِ الإسكندري بأنه مكدِّي طوّاف في الأرض، عارف بالشعر والشعراء، متمرس في أحوال الدنيا حنّكته السنون، أديب أريب وواعظ بليغ، له سمعة شهيرة ومعروف بنبوغه ومقالاته، لا يتورع عن الحيلة والكذب حتى باسم الرسول لينال من أموال الناس، بخيل لا يَخرجُ فَلسٌ من جيبه، وله في كل زمان حال وفي كلّ مكان مقال فتراه واعظا يوما وفي آخر ماجنًا، ومحتالا يوما ولصًا في آخر، وصاحبَ عيالٍ يومًا وفي آخر متزوَّجٌ قد ضاقت عليه الأرض وزوجه كما يدَّعي، وتقيًّا في النهار ومعاقرَ خمرٍ في الليل، وقرَّادًا في بلدٍ وفارسًا في آخر. فهو كما يقول: ويحك هذا الزمان زور/ فلا يغرنَّك الغرور/ لا تلتزم حالة ولكن/ در بالليالي كما تدور.
متقلَّبٌ متعدِّدٌ “أدعية الرجال، أحجية ربات الحجال”، ومستمرٌ في التجوال والسعي وراء المال، لكن المالَ لديه ليس الغاية بل السعي إليه بأحوال مختلفة، فهو كما يقول ليس بحاجة إليه: لا يغرنَّك الذي/ أنا فيه من الطلب/ أنا في ثروة تُشَقْ/ ـقُ لها بُردةُ الطرب/ أنا لو شئتُ لأتخذ/ ت سقوفا من الذهب.
لكن من لا يتعلّم من الإسكندري سيبقى مسبوقًا بخطوة، ومْن عرفَ الإسكندري علمَ أنَّه متملِّصٌ متغيّر متنكّرٌ، إذا ما جئت تُمسكَ به هربَ، وإذا ما حسبتَ نفسكَ قبضتَ عليه تسلَّل. لا يُمكن تثبيته بدبوسٍ، وكلُّ ما يسعنا فعله هو الحديث عنه وأخباره ومحاولة تقفّي أثره وآثاره.
النص المتجوّل
إنَّ التجوال في مقامات الهمذاني عنصرٌ مهم يكشفُ الكثير من طبيعة عالمِ المقامات سواء المُتخيَّل أو الحقيقي الذي انبثقت منه، وسلوكِ الشخصيات، ومقرون بطبيعة نص المقامة، وسمة أسلوبيّة للغة المقامة. وأعني بالتجوُّل الحركة والانتقال وعدم الثبات في مكان واحد والسفر المستمر. تُبيَّن أقوال الإسكندري وأشعاره كما سبق ذكرها هذا السلوك المتجوِّل مثل: أنا جوَّالةُ البلا * د جوَّابة الأفق/ أنا خُذروفة الزما * ن وعمَّارة الطُّرق، وحياة عيسى بن هشام وهو في كلِّ مقامة نراه قدَّ شرَّق وغرَّب بين البلاد. فما معنى هذا التجوُّل وهذه الحركية في النص والشخصيات؟ تأخذنا الإجابة إلى خارجِ النص، والعودة إلى عالم الكاتبِ وحياته. نرى أنَّ الهمذاني، الذي ماتَ في الأربعين من عمره، عاشَ حياته متنقلا بين البلاد من المدن فقد وُلدَ في همذان ثم انتقلَ إلى جرجان ثم نيسابور وخراسان وغزنة إلى أن استقرَّ في هراة، إحدى مدن خراسان، حيث مات. لم يثبت الهمذاني في حياته القصيرة في بلدٍ دون أن تحدِّثه نفسه لأسباب مختلفة بالخروج والذهاب إلى أخرى، فهو جوَّابة ومسافر بين المدن، وإن كانت الرقعة الجغرافية التي تنقَّل فيها قريبة من بعضها، لكن وفقًا لطبيعة زمانه وآلية التنقُّل وطبيعة الولايات الإسلامية وولاتها وكلِّ ما يرافق ذلك من صعوبات وخصائص يجعلنا ننظرُ إلى الهمذاني بأنه إنسان متجوُّل. انعكسَ هذا الجزءُ من حياته على مقاماته وبُنيتها وشخصياتها ولغتها وموضوعها، وأبانت عن دولة عصرها وحدودها وحرية التنقل فيها. ونجد أنَّ مقامات الهمذاني إذا ما جُمعت في كتاب واحد تتنقل من بلدٍ إلى آخر ومن غاية إلى أخرى، فنحن لا نطيل المكثَ مع مقامة واحدةٍ حتى تنتهي وننتقل إلى الأخرى ثم التي تليها، وهكذا تجوالنا في المقامات مستمِّر. ولسبب كونها غير منظومة في سلكٍ بالتتابعِ فهذا يمنحها سمة اللا تراتبيّة لذا يمكن البدءُ بالأولى أو الأخيرة، فكتاب مقامات الهمذاني مُنفتحٌ على إمكانية البدء بقراءته من أي مقامة دون أن يختلَّ شيءٍ لأنَّ الكتاب بعدد مقاماته الحاليّة لا يخضعُ إلى أي تراتبيّة إلزاميّة. وإذا ما انتقلنا إلى بُنية كلِّ مقامة فنجد أنَّ جلَّها تبدأ بالحديث عن انتقال ورحلة وحركة لعيسى بن هشام، والعلاقة القائمة بين السماع لحديث الرجل المتنكِّر ثم رغبة عيسى في معرفته فيلاحقه ثم التعرف على شخص أبي الفتح الإسكندري والافتراق في الأخير. ويتضحُ جليًا فإنَّ الحركة لا سيما ملاحقة عيسى لأبي الفتح هو العنصر الرئيس الذي يموجُ بالمقامة ويأخذها من نقطةٍ إلى أخرى باستمرار، وما الافتراقُ في آخر المقامة إلا تهيئة لحركة جديدة وملاحقة في المقامة التالية، وهكذا دواليك. شكَّلت اللغة المعتمدة في المقامات باتباعها السجع سمةً أسلوبيةً لغويةًـ طبيعة اللغة المتحرَّكة فالسجعة تتبع السجعة، كما يتبع عيسى أبا الفتح، وهكذا كلُّ مقامة من عدة أجزاء، وكلُّ جزءٍ من عدة سطور، وكلُّ سطرٍ من عدة جمل، وكلُّ جملة من سجعة، في حركة دائمة. إنَّ للسجعِ أهميته في المقامة فهو يؤدي وظيفة العجلة للمركبة، فدورانُ للعجلة هو المساعد في تحركها وتنقُلها، وهذا الدوران يُعطي أقصى طاقة حركية له بشكله الدائري، كما الحال مع السجعِ تماما. فالسجعُ مثل العجلة الدائرة، فالسجعة الأولى نصف دورة والسجعة الأخرى المقابلة نصف دورةٍ، فتكتمل الدورة الواحدة من السجعتين، ثم الدورة الثانية فالثالثة وهكذا يتحرك نص المقامة في نمطه التقليدي الرئيس حركته الدائرية: لقاء – افتراق، لقاء – افتراق، دون أن تكون هناك نهاية. أما موضوع المقامات الرئيس، وهو الكُدية، فهو بمثابة القلبِ النابض في المقامة لأنَّ الكُدية تفرضُ الحركة والتجوال بين المدن لا سيما مع شخص مثل أبي الفتح الإسكندري. يعتمد الإسكندري على أسلوب الحيلة والخديعة وتعزز بلاغته وفصاحته من دهائه، فهو محددٍ بعددٍ من الحيل في مكانٍ واحدٍ فإذا ما نفدت جعبته فعليه التغيير، كما أنَّ ثباتَ المكدي في مكان يولِّد اعتيادًا من الناس عليه وتقلُّص مراتِ مساعدته وتأثرهم بشكواه وبيان مسألته بمرور الأيام. لذا فالكدية تفرض على صاحبها التجوال. وبما أنَّ الكدية جُزء من بنية النصّ بموضوعها فنرى أنها تفرض طبيعتها المتحركة والمتنقلة على النصِ كما رأينا في السطور السابقة، لكنها من جانبٍ آخر تستمدُ إمكانية مزاولتها من حدود دولتها. إنَّ دار الإسلام في زمن الهمذاني، بظلِ خلافة العباسيين، مترامية الأطرافية فالتحرك من بلدٍ إلى آخر ومدينة إلى أخرى سهلٌ ومتاحٌ للجميع، فلا توجد حدود وخفر حدود كما هو الحال اليوم، وما كان لمهنة الكدية أن تأخذ النمط الحركي الواسع في المقامات لو كان هناك حدودٌ إدارية تعرقل الحركة والانتقال، فالتنقل في ربوع دار الإسلام وحتى الثغور، الحدود مع دار الكفر، لا يحتاج إلا إلى مطية، ومقدرة مالية وجسدية، ورفقة أحيانا لا غالبا. لولا هذه الأرض الواسعة ببلدانها المختلفة المفتوحة على بعضها ما كان لعيسى ولا الإسكندري أنْ يتوسعوا في السفر والتجوال، ولو غلبت المحليّة على تجوالهم والتحرك في مساحة صغيرة لفقدنا هذه السمة البارزة ولفقدت الكدية عنصرًا مهمًا تعتمد عليه في التوطُّن في بلدان مختلفة مع أناسٍ مختلفين. هذه الحركة كما أشرنا تطالُ الشخصيات وسلوكياتها فعيسى تجواله لطلب العلم أو التجارة أو حتى البحث عن الإسكندري، والإسكندري لا يقرُّ له قرار في مكان حتى يهجره. التجوُّال سمةُ نص المقامة الذي نراه يتغلغل في أدق تفاصيلها مؤثرًا في كلِّ شيء من اللغة إلى الشخصيات، وعاكسًا طبيعة دار الإسلام، ومُنبثقًا من حياة الهمذاني وموضوع الكُدية. لا يتوقف تأثير التجوال عند هذا الحد فالنصوص اللاحقة عربيًا وأجنبيًا ظهرَ فيها التجوال جزءٌ من بُنيها كما في رسالة التوابع والزوابع، ورسالة الغفران، والكوميديا الإلهية، وحكايات كانتربري.
هوامش:
1- فن المقامات في الأدب العربي – ص130.
2- بديع الزمان الهمذاني – مارون عبود. ص37.
3- فن المقامات في الأدب العربي – ص105.
4- زهر الآداب وثمر الألباب، جزء 1، ص 305.
5- موسوعة السرد العربي، ج2، فصل5.
6- المصدر نفسه. ج2، ص 235.
7- المصدر.
8- معجم البلدان، ج1، باب الألف، الإسكندرية.
9- الشاهنامه، ج2، ص 269-273 – الفردوسي. ترجمة: الفتح بن علي البنداري.



