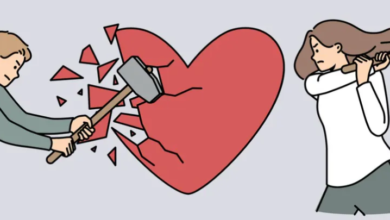كيف يسيء لنا السعي وراء الكمال؟
The school of life

ترجمة: ابتهال زيادة
من الوهلة الأولى قد يُبدي لنا بعض الأشخاص الجوانب المشرقة فيهم: التحفيز الذاتي والنشاط والدقة. يستيقظون باكرًا فجرًا، ونادرًا ما يذهبون في عطلة، ويأخذون ساعة أو حتى ساعتين عمل إضافيتين! ويُعجبون مُديريهم إعجابًا شديدًا، ويحصلون باستمرار على الترقيات، فهم متفوقون منذ صفوفهم الابتدائية، فلا يفوتون موعدًا ولا يقدمون عملًا غير متقن. معايير هؤلاء الأشخاص عالية، وتستدعي معاييرهم العالية هذه تسميتهم “سُعاة الكمال”. قد لا يصح لنا في هذا المقام أن نحدد أيَّ مشكلة. لكن ما السبب الذي يسترعي التذمر من فكرة التفاني الشديد في عالمٍ تسوده الفوضى واللا مبالاة؟ هل يمكن أن يخفي لنا هذا التفاني الشديد أمرًا أشد سوءًا؟ ما المعيب في السعي وراء الكمال؟ لا تسترعي المسألة القلق الشديد عند العمل سعيًا وراء الكمال (فهذا الفعل لا يقلق الطرف الآخر بل يجعله متميزًا) المقلق هو الحالة النفسية لهؤلاء السعاة. والمؤسف كذلك، أن السعي وراء الكمال لا ينبع في المقام الأول حبًا في المثالية بحد ذاتها، لأن منبع هذا السعي أعمق بكثير من شعور الحزن الناجم عن عدم الاكتفاء التام. بل منبعه كراهية الذات، التي غذتها ذكريات رفض أو إهمال تركها فينا أولى الناس بتقدرينا حق قدر منذ الطفولة. ونتيجة لمشاعرنا المبكرة بعدم الاستحقاق: اللا مبالاة، النقص، والاحباط والخذلان والانزعاج نصبح تواقين إلى الكمال. وقع هذه المشاعر قوي ومجفل جدًا على نفوسنا، فقد تضغطنا وتجعلنا على استعداد أقل أو أكثر للقيام بأي فعل لمحوها منا. العمل ساعاتٍ طويلة، وكسب رضى صاحب العمل، والقيام بعمل مضاعف يقومه به آخر مرتين- هذه هي الأدوات التي نسعى من خلالها لتزكية أنفسنا التي لم تحظَ بالتقدير. فقد يَعِدُ جانبٌ واحد من الدماغ الجانبَ الآخر بالوصول للسلام الداخلي في حال إتمام التحدي التالي. وقد نحسن التظاهر بمنطقية طموحتنا إلا أن عملنا يكشف بعده العبثي: كأننا ندحرج صخرة صعودًا لأعلى التل فتعود للتدحرج نزولًا من جديد. ولهذا فإننا لن نصل إلى نقطة الراحة أو الإحساس الدائم بالاكتمال. وواقعيًا نحن نعمل لأننا متعبين أكثر من كوننا مُنساقين إلى لعمل. وإتقان العمل على نحو مثالي في نظرنا ليس سوى محاولة للهروب من ذواتنا المستاءة، فالعمل بيُسرٍ هو السبيل لجعلنا كبارًا في أعين أنفسنا. ولكن لأن مشكلتنا لم تبدأ من الأساس مع العمل، فإن العمل لا يمكنه حل هذا المشكلة إطلاقًا. هدفنا الحقيقي ليس، كما نتصور أن نكون موظفين مثاليين أو أَكْفاء، بل هدفنا هو الشعور بالرضى، لا سيما أننا لا نستطيع وضع عاتق مسؤولية الشعور بالرضى على مديريننا أو زبائننا أو حتى النظم الرأسمالية التي تتطلب العمل دون كلل أو ملل: بوضوحٍ إن طبيعة العمل مع هذه الفئات تتطلب بذل المزيد من الجهود المتواصلة على الدوام، وفي الحقيقة نحن بحاجة إلى إحداث التحول في دوافعنا الشعورية. بمعنى أن اهتمامنا الغريب بالعمل على أكمل وجه، كأن نعمل تحت الانطباع المزعج بأننا أشخاص بغيضون- مشكلة لا يحلها العمل الجاد وحده. إننا بحاجة إلى التسويغ لأنفسنا استحقاقَنا الرضى منذ الطفولة و محو الاعتقاد الأبدي من أذهاننا بأننا المخطئون وعليه فإننا لم نكن أهلًا له. ليس علينا محاولة إثبات أحقيتنا في الوجود بل أن نساءل أنفسنا كثيرًا نجري استفتاء على أحقيتنا في الوجود في كل مرة نقدم فيها تقريرًا، ومع كل اختبار يتعين علينا اجتيازه، وكل عميل يتعين علينا خدمته. يظل العمل المتقن غايةً نبيلة، لكنه يصبح عرضًا من أعراض الاضطراب النفسي إن صار غطاء لنقصٍ عاطفي منذ الطفولة. يتوجب علينا أن نتقبل زمان الكسل ونضعه بموضعِ الترحاب، ليس لأننا بطبعنا كسالى لكن لأن ذلك يعكس إدراكنا بالتواصل مع أنفسنا بلطف أكثر، وألا نبالغ في غضبنا من أولئك الذين لم يبدوا لنا أيَّ تقدير أو تقبل على ما كنا عليه منذ الطفولة.