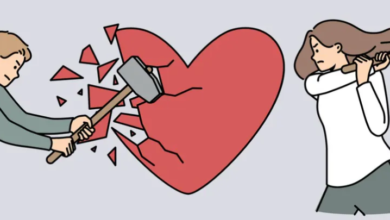كيف نحتوي ذوي الطباع الصعبة؟
The school of life

ترجمة: ابتهال زيادة
لعل أفضل ما نظهره للآخرين هو مواقفنا الاحتوائية في أوج مواجهتهم الصعوبات بتذكر أننا جميعًا ما نزال أطفالًا. قد يبدو هذا الاعتقاد غريبًا. خاصةً أن البالغين ليسوا أطفالًا. فالبالغون لديهم قدرات استنباطية تفوق كثيرًا قدرات الشباب، فأمامهم الخيارات التي تعينهم على التفرقة بين الصواب والخطأ، وهم قادرون أيضًا على إحداث الأضرار الجسيمة: هم الأدرى بذلك. في المقابل، نرى في الأطفال سحرهم في خطفهم قلوبنا، ويكمن سر هذا السحر إلى حد ما في مظهرهم الجسدي: أعينهم الواسعة الآسرة، والوجنتان المكتنزتان، وقوامهم الناعمة وأصابعهم الرقيقة الممتلئة. لكن في النهاية، يظل الأطفال يسترعون حناننا لأننا حينما نراهم يتصرفون بأساليب سيئة أو خادعة، فإننا نتفهم بسهولة الأسباب وراءها: فنرى طفلًا يضرب أخته الصغيرة بسبب شعوره بالإهمال، أو طفلا آخر يسرق الأشياء من أقرانه لأنَّ والديه يمران بأزمة طلاق، أو نجد طفلًا غادر الحفلة دون أن يقول “مع السلامة” بسبب اضطرابه من الشعور بعدم الاستحقاق.
عموما، عند ربط هذا الأمر بعلم نفس الطفولة، نُبصر حقيقة في غاية الدهشة والحلاوة، فنكتشف أن التصرفات “السيئة” والخادعة ليست سوى نتيجة للتعرض الدائم لشكل من أشكال الألم، أو الانزعاج، أو الأذى، أو الجرح. فالطفل لا ينشئ هكذا بغيضًا، بل يصبح بغيضًا استجابة للتعرض للألم أو الخوف أو الحزن. من منظور آخر، الوضع مع البالغين يختلف فعندما نواجه سلوكًا سيئًا أو مريبًا من أحدهم، فأفكارنا لأسباب مجهولة لا تتحول نحو التعمق في الأسباب وراء تصرفاتهم. لأننا راضون عن أفكارنا السريعة والقاصرة تجاههم: لأنهم بوضوح حمقى ومجانين. هذا ما يرضي غرورنا حتى الآن. ورغم ذلك فمجال طرح التساؤلات مفتوحٌ دائمًا -أن نتسائل عن سبب تصرف شخص ما هكذاـ على الأغلب سنتخبط داخل فكرة استفزازية ثائرة وصائبة مفادها: أن السبب وراء ارتكاب الأطفال الصغار والأناس الكبار للأخطاء -رغم الاختلافات في العمر والحجم- هو ذاته تمامًا. قد تكون إحدى الفئتين صغيرة لا تتجاوز حجم الكرسي، والأخرى عملاقة قادرة على حمل الأسلحة، أو نشر مقالات مطولة على الإنترنت أو تشغل الشركات وتتسبب في إفلاسها، لكن في النهاية رغم هذه الاختلافات فإن سيكولوجية الكراهية والغضب وارتكاب الخطأ هي ذاتها دائمًا: الألم أصل الشر! الشخص الكبير لم ينشئ هكذا على الشر، وطباعه الصعبة لم تكن صعبة منذ تنشئته، بل غذتها الضغينة نتيجةً التعرض لجرحٍ ما زال في انتظار الكشف عن موضعه. فالكشف عن مواضع هذه الجراح يتطلب التعامل معها بصبر وإنسانية استثنائيتين- فالتعامل معها يتطلب الاحتواء. قد يكون البحث عنها أمرًا مرهبًا من الناحية الأخلاقية لأننا نتصور أن المسألة تتطلب منا التفكير مليًا في السلوكيات المشينة، إلا أن هذا التصور غير وارد إطلاقًا، إذ يمكننا الإبقاء على استيائنا ونحن نتتبع في الوقت ذاته مسار العوامل الحقيقية المحفزة لتلك السلوكيات. قد يرهبنا أيضًا البحث من الناحية العملية لأننا نتصور أن التعمق قد يتطلب منا ترك شخص ما طليقًا ليتسبب في إلحاق المزيد من الأذى بنا أو بالآخرين، وفضلًا عن ذلك، يمكننا إبقاء المخطئ بأمان خلف القضبان العالية حتى وإن كنا نتحرى بحرصٍ شديد عن منشأ سلوكياته الانتهاكية. وبمجرد أن تتضح قصص هؤلاء المعتدين تمامًا، فسرعان ما سيعيد منظورنا صياغة نفسه. ستتغير نظرتنا في ذاك المتنمر الذي كان يترصد بنا على الإنترنت، الذي عمل حمالًا قبل بضعة سنوات ثم فُصل من عمله وسقط في براثن الاكتئاب ودخل في مواجهة مع محاكم الإفلاس، وفي السياسي الشعبوي الغاضب الذي كان يستصغره أبوه المتسلط، والمصاب بفرط النشاط الجنسي الذي يلجأ للإدمان كونه المهدئ من مخاوفه المضمرة التي نتجت عن التعرض للإهمال العاطفي في الطفولة. واقعيًا إنَّ حُكْمنا على تلك السلوكيات لن يتغير؛ ما سيتغير هو إدراكنا بالأسباب الكامنة وراء حدوثها. تَمركز مجال العلاج النفسي في مساعدتنا على رسم الروابط غير المترابطة أو المتناقضة أحياناً بين إحدى الأعراض ومنشأها. بمعنى قد يخفي التباهي جذور الخوف، وقد يخفي الغضب الشعور بالارتياب، أما الكراهية فقد تكون للحماية من الوقوع الحب. ويمكن أن يحيط البالغون أنفسهم بأجواء مليئة بالغطرسة تعويضًا عن الغياب. وقد يكون الأسلوب التهكمي علامةً على لهفة بعيدة للحنان. تميل أنظمة السجون في معظم البلدان إلى وضع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في مؤسسات منفصلة عن الجانحين الشباب، هذه المؤسسات تعامل النزلاء بقدر من اللطف الباعث للأمل- بهدف التعمق في سيكولوجية المعتدي لفهم الأسباب الدافعة وراءها والتغلب عليها. ولكن بعد هذا السن، غالبًا ما يُحبس السجناء في زنزانات معزولة وبتعبير مجازي- ستُلقى المفاتيح بعيدًا! في نهاية المطاف، هم أكثر من سيدرك كل ذلك. جميعنا مُذنبون صغارًا إن صح التعبير، فمهما كانت أعمارنا فإننا جميعًا نظل بحاجة إلى التعامل مع أخطائنا بالمواساة والاستقصاء العاطفي. وبقدرتنا على التصور الدائم لحال هؤلاء الأشخاص كحال الرضع في المهد نكون قد قدمنا إنجازًا معرفيًا عظيمًا.