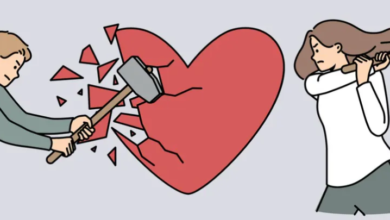فن اكتساب الثقة بالنفس
(سبيل صعب لكن غير مستحيل)

The school of life
ترجمة: دعاء خليفة
لمن الباعث على التواضع إدراك أن الكم الهائل من الإنجازات العظيمة لم يكن نتيجة للموهبة الفذة أو للدُربة، بل محض مرح الروح الغريب ذاك الذي نسميه ثقة. نقضي جل وقتنا لاكتساب الثقة بالنفس في نطاق محدود من المجالات التقنية: المعادلات التربيعية أو الهندسة الحيوية، وفي علم الاقتصاد أو القفز بالزانة. غير أننا نتغاضى عن حاجتنا الأساسية إلى اكتساب خصال متنوعة من الثقة بالنفس أكثر حرية- تلك التي تعيننا عبر عدد من المهام مثل محادثة الغرباء في الحفلات، وطلب يد إحداهن للزواج، وطلب خفض درجة الصوت من رفيق السفر، والسعي لتغيير العالم. غالبًا ما نفتقر إلى الثقة بالنفس لأن نحسبُ أن حيازتها محض توفيق غريب بعض الشيء ونادر. يكون حس الاعتداد بالنفس عاليًا عند بعض الناس، لأسباب قد يكشف عنها علماء الأعصاب يومًا ما. لكننا نتقاعس بالقول إن ما من حيلة في إيدينا حيال وضعنا هذا، ونظل حبيسي قدرنا الذي ولدنا به في الثقة بالنفس.
في الحقيقة، خلاف ذلك هو الصحيح. إن الثقة بالنفس مهارة، لا منحة إلهيّة. ومهارة تستند إلى منظورنا للعالم وما نشغل فيه من حيّز. من الممكن تدارس هذه الأفكار بمنهجيّة وتعلمها تدريجيًا، لنتمكن من تجاوز جذور التردد المفرط والإذعان، ومن الممكن تعليم أنفسنا فن اكتساب الثقة بالنفس. نستعرضُ في هذا المقال فن اكتساب الثقة في أربعة أفكار يوميّة تغيب عن معظمنا، لكنَّها المدخل الرئيس لنُخرجَ أفضل نسخةٍ لنا واثقة بنفسها في درب الحياة.
المساهمة في كتابة التاريخ
إحدى العلامات التي تميز الأشخاص الواثقين بأنفسهم عن أولئك الحييّين هو سبيلُهم إلى التاريخ. فعموما لدى غير الواثقين اعتقاد بأن التاريخ قد ولّى، وبخلاف ذلك، يودع الواثقون الثقة بأن التاريخ ما يزال في طور التوثيق، وربما يكون من صنيعهم ذات يوم.
إن الطريقة التي نلجُ بها العالمَ تحمل في طياتها انحيازًا متأصلًا نحو الانطباع بأن التاريخ قد حُسم. كل ما حولنا يتآمر لبث الشعور بأن الوضع الراهن راسخ في القدم. فها نحن أولاء محاطون بأشخاص أقدم منا بكثير، يتبعون تقاليدَ ظلت قائمة منذ عقود، بل وحتى قرون. إن مفهومنا عن الزمن يمنح امتيازات كبيرة للحظة الحالية، أما في نظر طفل يبلغ من العمر خمس سنوات فيبدو العام الماضي وكأنه قرن مضى. والمنزل الذي نعيش فيه، اتخذ شكله النهائي مثل معبد قديم، والمدرسة التي نذهب إليها كما لو تؤدي الطقوس ذاتها منذ بدء الخليقة. يُرددون على مسامعنا علة سير الأمور على ما هي عليه، ونُحثُّ على تقبل أن ما من واقع يُصنع وفق رغباتنا. لقد أصبحنا على ثقة بأن البشر أتموا رسم خريطة كاملة لنطاق الممكن. وإذا لم يحدث شيء ما، فإما لأنه غير ممكن الحدوث وإما لا ينبغي له ذلك. وما ينتج عنه هو توخي الحذر بشأن تصور البدائل. لا فائدة من بدء عمل تجاري جديد (السوق مملوء بالفعل)، أو تصدر الريادة في اتباع نهج جديد للفنون (كل شيء محدد سلفًا في نمط ثابت)، أو الامتثال لفكرة جديدة (فهي إما أن تكون موجودة وإما ضربٌ من الجنون). لكن عندما نراجع التاريخ؛ تتغير الصورة بنحوٍ حاد. ما أن يتسارع الزمن ونتسلق جبلًا من الدقائق لمسح معلومات عن القرون نرى أنَّ الثابت هو التغيير. اكتُشفت قارات جديدة، وابتكرت طرق بديلة لحكم الأمم، وتتغير كيفية ارتداء الملابس ومن هو حقيقٌ بالعبادة. ارتدى الناس ذات يومٍ عباءات غريبة، وكانوا يحرثون الأرض بأدوات خرقاء. ومنذ زمن غابر قطعوا رأس الملك. في سالف الأيام، كان الناس يتجولون في سفن هشة، ويأكلون مقل عيون الأغنام، ويستخدمون قِدْرًا لقضاء الحاجة فيه، وليس لهم معرفة بمعالجة الأسنان.
نستنتج من كل هذا، من الناحية النظرية في الأقل، أن الأمور تتغير. ومع ذلك، من الناحية العملية، ودون أن نلاحظ تقريبًا، فإننا نميل إلى تحييد أنفسنا ومجتمعاتنا عن الاعتقاد اليومي بانتمائنا إلى ذات السرد المضطرب المستمر وأننا، في الوقت الحاضر، الفاعلون الرئيسون فيه. إننا نشعر أن التاريخ هو ما كان يحدث، ولا يمكن له أن يكون ما يحدث حولنا هنا والآن. وفي محيطنا في الأقل، فإن الأمور مستقرة. لتخفيف اللا مبالاة تجاه مصادفة التغيير في كل مكان، والسلبية المتولدة منها، نلتفتُ إلى بعض السطور للنظر في سلسلة قصائد ت.س. إليوت، الرباعيات الأربع (1943):
“وهكذا، والنور يخبو
في ظهرية شتوية، في كنيسة نائية
فالتاريخ هو الآن وإنجلترا.”1
في العادة، تضفي أوقات ما بعد الظهيرة في فصل الشتاء، قرابة الرابعة مساءً، على النفس شعورًا بنيل المنال والقبول، لا سيما في الكنائس الريفية الإنجليزية الهادئة الصغيرة، التي يعود تاريخ بناء العديد منها إلى العصور الوسطى. يلفك هواؤها الساكن والمشبع بالرطوبة. وتجد الأرضيات الحجرية الثقيلة قد تآكلت ببطء جراء خطوات المؤمنين. قد يكون هناك منشور يعلن عن حفل موسيقيّ قادم، وصندوق خيري يأمل أن يلفت انتباهنا. فوق المذبح، تتوهج نافذة من الزجاج الملوَّن للقديسين (بطرس ويوحنا، يحمل كل منهما حَمَلاً) بشمس الأصيل الآفلة. لا توحي هذه الأماكن والأوقات برغبة في تغيير العالم، بل يبدو من الحكمة أن نقبل الحال على ما هو عليه، ونعود إلى المنزل من وسط الحقول، ونستدفئ بالنار في مساء هادئ. من هنا كانت المفاجأة في بيت إليوت الثالث، الذي يتردد صداه: “التاريخ هو الآن وإنجلترا”. بعبارة أخرى، فإن كل ما نربطه بالتاريخ -جرأة العظماء المتهورة، والتغييرات الدراماتيكية في القيم، والتساؤل الثوري عن المعتقدات الراسخة، وانقلاب النظام القديم- ما يزال مستمراً، وفي هذه اللحظة بالذات، في أماكن تبدو مسالمة، لا يعتريها التغيير مثل المنطقة الريفية بالقرب من شاملي جرين، في ساري، حيث كتب إليوت القصيدة. لا يسعنا رؤية تشكل التاريخ لقربنا الشديد منه. إنّ العالم يُصنع ويُعاد تشكيله في كل لحظة. ولذلك فإن أي واحد منا لديه فرصة نظرية ليكون فاعلًا في التاريخ، على نطاق كبير أو صغير. إنه منفتح على عصرنا لبناء مدينة جديدة جميلة مثل البندقية، ولتغيير الأفكار جذريا كما جرى في عصر النهضة، ولبدء حركة فكرية مدوية مثل البوذيّة.
يحمل الحاضر جميع أحداث الماضي المحتملة، ويتمتع بمرونة عالية. ولا ينبغي له أن يبعث الخوف في النفوس. فإن كيفية الحب، والسفر، والتعامل مع الفنون، والحكم، وتثقيف أنفسنا، وإدارة الأعمال، وتقدم في العمر وموتنا، تسعى جميعها لمزيد من التطوير. قد تبدو وجهات النظر الحالية ثابتة، ولكن هذا فقط لأننا نبالغ في ترسيخها. غالبية ما هو موجود اعتباطي، وليس حتميًا ولا صحيحًا، بل هو ببساطة نتيجة الفوضى والصدفة. وينبغي لنا أن نكون واثقين بأنفسنا، حتى عند مغيب الشمس بعد الظهر في فصل الشتاء، وبقدرتنا على الانضمام إلى تيار التاريخ، وتغيير مساره، مهما كان ذلك يبعث على التواضع.
الثقة بالثقة بالنفس
على الرغم من افتراضنا، مثل أي شخص آخر، برغبتنا في الوثوق بأنفسنا فقد تتولد لدينا شكوك بأنَّ اكتساب الثقة في الواقع حالٌ ذهنية غير جذابة. قد نرى، دون أن ندرك ذلك تمامًا، أنَّ فكرة كوننا واثقين حقًا مهينة بنحوٍ غريب، ونظل متمسكين سرًا بخصلتي التردد والتواضع. قد نفخر بحقيقة أننا لسنا من النوع الذي يشتكي في المطاعم، ولا نثير ضجة حول رواتبنا، ولا نطالب أصدقاءنا بإعادة جدولة إجازاتهم لتتوافق معنا، ولا نعزف موسيقانا بصوت عالٍ. إن وداعتنا تحمينا من بعض التصرفات المثيرة للاشمئزاز حول تأكيد الذات. ربما تكون صورة المعتدّ بذاته تمثلت صياغتها، في وقت مبكر من حياتنا، بحضور أشخاص كانوا غير ودودين إلى حد كبير، ومعتدّين بحقهم في الوجود. ربما كانوا متطلّبين بنحوٍ مرعب، ونافذي الصبر، وغير مقدّرين، ومتهورين، أو كانوا يصرخون في أثناء الخدمة، ويغلقون الهاتف على من يعتقدون أنه لا يعيرهم الاحترام الكافي. ربما بدأنا نعتقد أن هذا التصرف هو ما يؤدي إلى النجاح، وأنه إذا كانت هذه هي الحال، فلن نصبو إلى النجاح اللافت للنظر. لا ينبغي لنا نسيان أن الريبة في نيل الثقة كان يحظى تقليديًا بتأييد ثقافي هائل. لقد كانت المسيحية، ذات التأثير الأكبر في عقلية الغرب عدة قرون، متشككة جدا بشأن أولئك المعتدين بأنفسهم، في المقابل ينعم الودعاء بالنعمة الإلهية والمتكبرون هم آخر من يشملهم ملكوت السماوات. وأضافت النظرية السياسية لكارل ماركس (1818-1883) إلى هذه الحجة مجموعة من النظريات التي تثبت على ما يبدو أن النجاح الاقتصادي كان يقوم دائما على استغلال الآخرين. لا عجب أن نشعر وكأننا، لكي نكون مواطنين أخلاقيين، ينبغي لنا تجنب كل ما قد يُظهرنا مهتمين بمصالحنا دون أي شيء آخر. ومع ذلك، فإن هذا الموقف قد لا يخلو أيضاً من مخاطر. قد نفتقر إلى الثقة لا في اعتماد القسوة والترويج للحماقة، بل في النضال من أجل اللطف والحكمة. إن ريبتنا في الثقة قد تسمح بازدهار نسخ وضيعة من الثقة بالنفس. قد يكون الموقف الخارجي غير عادل أيضًا، وتكون نظرتنا السلبية للثقة بالنفس معتمدة بإفراطٍ على مراوغات تاريخنا، وعلى أول لقاء مع من تحلّوا بثقة في النفس لكنهم لم يكونوا أفضل نموذج يُحتذى به. ربما لا تكون مشكلتنا الحقيقية هي الثقة بالنفس بقدر ما هو الافتقار إلى الفضائل الأخرى مثل الأخلاق والجمال والفطنة والكرم، أو ربما نخطئ في تشخيص جذر اعتراضاتنا، أو ربما هم قلة أولئك الأشخاص المعرضون لخطر التحول إلى متفاخرين بإنجازاتهم أو ممتلكاتهم، وأنانيين، ومتباهين. لكن الثقة بالنفس في جوهرها متوافقة تمامًا مع كونك حساسًا ولطيفًا وذكيًا وهادئ الطبع. كثيرا ما يكون اختلاطُ الثقة بالفظاظة، وليس بالثقة بالنفس، هو ما نكرهه. علاوة على ذلك، فإن انجذابنا إلى الوداعة يخفي بعض الاستياء من الثقة بالنفس. قد لا نعجب بالخجل بقدر ما نخشى تجربة الثقة. كان هذا النوع من خداع الحماية الذاتية هو الذي فتن الفيلسوف الألماني نيتشه (1844-1900) أكثر من سواه. لقد اعتقد أن هذا خطأ نموذجي للعديد من المسيحيين، الذين قد يفتخرون بـ”تسامحهم”، لكن في الواقع يحاولون بوضوح تبرير “عدم قدرتهم على الانتقام”. يجب أن نحرص على ألا نُعامل عيوبنا الأساسية كأنها فضائل إلهية.
لسوء الحظ، لا يكفي أن تكون لطيفًا وجاذبًا وذكيًا وحكيمًا من الداخل، بل نحتاج إلى تطوير المهارات التي تسمح لنا بجعل مواهبنا فاعلة في العالم بأسره. الثقة بالنفس هي ما يترجم النظرية إلى ممارسة، ولا ينبغي أبدًا عدّها عدو الأشياء الجيدة، إنها محفزهم الحاسم والمشروع. يجب أن نسمح لأنفسنا بتعزيز الثقة في الثقة بالنفس.
التدمير الذاتي
من الطبيعي توقع أننا سنسعى دائمًا -بحكم طبيعتنا- إلى نيل سعادتنا، لا سيما في مجالين أساسيين من مجالات الرضا المحتملة: العلاقات والمهن. لذلك فمن الغريب والمثير للقلق أن نلاحظَ ما أكثر الذين بيننا وهم يتصرفون كما لو أنهم يتعمّدون إفساد فرصهم في الحصول على ما يريدون. عندما نذهب في مواعيد غرامية مع شركاء محتملين، قد نسقط في سلوك عدائي وعنيد دون داعٍ. وعندما نكون في علاقة مع شخص نحبه، قد ندفعه إلى التشتيت من خلال الاتهامات المتكررة غير المبررة والانفجارات الغاضبة، كما لو كنا على استعداد بطريقة أو بأخرى لتكدير يومنا، في حين يكون المحبوب منهكًا ومحبطًا ويضطر حينها إلى الابتعاد، وهو ما يزال متعاطفًا سوى إنه استنفد صبره في تحمل كثرة الشك وخلق الدراما. بالمثل، قد ننجرف إلى تدمير فرصنا في الحصول على ترقية كبيرة في العمل، عندما يحتد مزاجنا بغرابةٍ مع الرئيس التنفيذي، بعد تقديم عرض تقديمي مقنع بنحوٍ خاص إلى مجلس الإدارة. أو نصبح ثملين ونوجه الإهانات في عشاء مهم لأحد العملاء. لا يمكن إرجاع مثل هذه السلوك إلى حظ سيئ فقط، بل يستحق مصطلحًا أقوى ويذهب إلى عين المقصود: التدمير الذاتي. اعتدنا بنحوٍ كافٍ على الخوف من الفشل، ولكن يبدو أن النجاح يجلب حصة مماثلة في بعض الأحيان من المخاوف، التي قد تبلغ ذروتها في النهاية برغبة تفويت فرصنا في محاولة استعادة راحة بالنا.
ما عساه يفسر هذه الريبة المتعلقة بالنجاح؟ قد تكون في بعض الحالات، رغبة غير واعية في حماية أولئك الذين يحبوننا -لا سيما من اهتموا بنا في طفولتنا- من الحسدِ والتحسس من عدم كفايتهم اللَذين قد تثيرهما مكاسبنا في الحياة. قد يكون الشريك الجديد الجميل أو الترقية إلى منصب كبير أمرًا مدمرًا بصمت لمن حولنا، ويدفعهم إلى التساؤل عن مدى ضآلة ما حققوه هم في المقابل، والخوف من عدِّهم غير جيدين بما يكفي لاستحقاق صحبتنا. قد يكون من الغريب تقبل أن أولئك الذين أحبونا في صغرنا يمكن أن يكنوا مشاعر حسد تجاهنا، لا سيما مع إخلاصهم لنا في أغلب الجوانب الأخرى. مع ذلك، قد يكون أحباؤنا هؤلاء يحتملون درجة من الندم بداخلهم بشأن مسار حياتهم، وما يصاحب ذلك من مخاوف إهمالهم، وشعورهم بعدم أهميتهم من قبل الآخرين، حتى من أطفالهم. ولربما صادفنا في تقدُّمنا في العمر مُذكِّراتٌ معبرة عن عدم التكبّر وعدم نسيان بدايتك المتواضعة، ومناشدات مقنعة بعدم نسيانها أو التغاضي عنها، لذا يمكن أن ينتهي بنا الأمر في مأزق: فالنجاح الذي نتوق إليه يهدد بإيذاء من نحبهم شعوريًا. يكمن الحل، عندما نكتشف المأزق، بتجنب تدمير ذواتنا بأن نتحلّى باللطف ونغدو استباقيين حول الأسباب الحقيقية التي تحرض من يعنيهم أمرنا على الشعور بالقلق الشديد بشأن إنجازاتنا. يجب إدراك أن يعنيهم أمرنا لا يخافون في نهاية المطاف من نجاحنا، بل يخشون أن نهجرهم ونذكرهم بأوجه القصور لديهم، ثم فإن المهمة لا تتمثل في تفويت الفرص؛ إنها محاولة طمأنة رفاقنا القلقين بقيمتهم الأساسية عندنا وما نكنّه لهم من ولاء.
النوع الثاني الشائع من مدمري الذات هم أولئك الذين يرون أن ثمن الأمل باهظ جدا. عندما كنا أصغر سنًا، ربما تعرضنا لخيبات أمل قاسية بنحوٍ استثنائي في وقت كنا فيه أضعف من أن نتحملها. ربما كنا نأمل أن يبقى آباؤنا معًا، لكنهم انفصلوا. أو كنا نأمل أن يعود والدنا في النهاية من بلد آخر ويقيم معنا. ربما تجرأنا على حب شخص ما، وبعد بضعة أسابيع من السعادة غيّر موقفه بسرعة وغرابة وسخر منا أمام أقراننا. في مكان ما في شخصياتنا خُلقَ رابط عميق بين الأمل والخطر، جنبًا إلى جنب مع تفضيل مماثل للعيش بهدوء مع خيبة الأمل بدلاً من العيش بحرية أكبر مع الأمل. وعلاجُ هذا في تذكير أنفسنا بمدى استطاعتنا، على الرغم من مخاوفنا، التحلي بالأمل وتجنّب الوقوع في شعور فقدان الأمل الدائم. ما عدنا نحن الذين عانوا خيبات الأمل المسؤولة عن ضعفنا الحالي. إن الظروف التي شكلت حذرنا لم تعد تنتمي إلى واقع البالغين. قد يكون العقل الباطن، كعادته، يقرأ الحاضر من خلال عدسات العقود الماضية، غير أن ما نخشى حدوثه، في الحقيقة، قد وقع، نحن نُسقط على المستقبل كارثة تنتمي إلى ماضٍ لم تتح لنا الفرصة لفهمها والحزن عليها بنحوٍ كافٍ. علاوة على ذلك، ما يميز مرحلة البلوغ أساسًا عن الطفولة هو أن فرصة إتاحة مصادر الأمل للشخص البالغ تفوق ما يتاح للطفل. يمكننا أن ننجو من خيبة الأمل هنا أو هناك، لأننا لم نعد نسكن في مقاطعة مغلقة، تحدها الأسرة والحي والمدرسة. ينفتح العالم أمامنا كبستانٍ نرعى فيه مجموعةً متنوعةً من الآمال التي ستفوقُ دائمًا خيبة الأمل الساحقة التي لا مفر منها، سوى إنها عرضية ونملك فرصة للنجاة منها.
أخيرًا، قد ندمر النجاح بالتواضع أي بالشعور بعدم استحقاقنا المكافأة التي تلقيناها. فقد نعيد النظر في وظيفتنا الجديدة أو حبيبنا الجديد بتسليط الضوء على جوانب في أنفسنا ندرك أنها أقل درجة من الكمال: كسلنا وجبننا وغباؤنا وعدم نضجنا- ونستنتج أنه لا بد من وقوع خطأ ما، وعليه يجب إرجاع هدايانا إلى من يستحقها. لكن هذا أمر لطيف، وإن كان مؤسفًا، عن سوء فهم الطريقة التي يُوزع بها النجاح والألم. إن الكون لا يوزع مواهبه وأهواله بالمعرفة الإلهية الدقيقة للخير والشر داخل كل واحد منا. معظم ما نفوز به ليس مستحقًا تمامًا، ومعظم ما نعانيه ليس كذلك، وخير دليل هو أن أجنحة السرطان ليست مليئة بالأشرار على نحوٍ استثنائيّ. فعندما نشعر بالاضطهاد لعدم جدارتنا إزاء تقبل الآخرين لمحاسننا، نحتاج فقط إلى تذكير أنفسنا بأننا قريبًا لن نستحق عذاباتنا أيضًا. إنَّ أمراضنا، وسقطاتنا العامة من الوقار، والهجر العاطفي، ستكون في الوقت المناسب غير مستحقة كما قد يكون كذلك جمالنا، وارتفاعاتنا، وشركاؤنا المحبون الآن. لا ينبغي لنا أن نقلق كثيرًا بشأن المحاسن، ولا أن نتذمر بمرارة شديدة من المساوئ، بل أن نتقبل منذ البداية، عن طيب خاطر وهاجس مغتم، العشوائية المطلقة ولا مبالاة القدر.
قد يكون من المفيد أن نضع مفهوم التدمير الذاتي في الاعتبار عند تفسير تصرفاتنا وتصرفات الآخرين الغريبة. يجب أن يساورنا الشكُ عندما نلحظ أننا نتصرف بطريقة شاذة حول من نحبهم حقًا أو نسعى لإثارة إعجابهم. علاوة على ذلك، يجب في مواجهة أنواع معينة من الخبث وعدم الموثوقية في الآخرين- أن نجرؤ على تصوّر أن الأشياء ليست تمامًا كما تبدو، قد لا يكون بين أيدينا خصم خبيث، بل مدمر ذاتي مجروح بنحوٍ مؤثر، ويستحق في المقام الأول القليل من الصبر كما ينبغي إقناعه بلطف عدمَ إلحاق المزيد من الأذى بنفسه. يجب علينا أن نتصالح ونساعد الآخرين على إدراك مدى صعوبة الاقترابِ من تحقيق الأشياء التي نريدها حقًا، وما يثيره الاقتراب من قلق في بعض الأحيان.
استحضار الموت
تقبع الكثير من خططنا في التأجيل يوميا، فالعلاقة العاطفية سيكون في صالح الطرفين إنهاؤها، ومن المذهل التعرف إلى الشخص الجديد، وتعدُ هذه الوظيفة البديلة باستعمال مواهبنا الدفينة، وهذا المنزل يطل على البحر والمناظر الجميلة. مع ذلك نظل مكتوفي الأيدي. قد تطرأ لحظات من الإدراك القلق في الساعة الثالثة فجرًا، غير أننا ننحّي آمالنا في النهار ونمضي قدمًا. نزجّي الوقت بالتفكّر في الاستمتاع بالأشياء الجميلة التي سنفعلها بعد التقاعد. وندع الحياة تتسرب من بين أيدينا. يكمن جذر ترددنا في حسِّ الخطورة. كل خطوة تعرضنا لمخاطر مروعة- قد لا يكون المنزل الجديد مناسبًا، وتغيير العمل قد يؤدي إلى الهلاك، قد يرفضنا الحبيب، ونندم على تركنا للعلاقة العاطفية السابقة. غير أن تقاعسنا عن العمل ليس بلا تكلفة، نظرًا لأن بالتحرر من الإدراك الواعي المعتاد يكمنُ رعبٌ أكثر من الخسارة بنحو جدليّ- مأساة خسارة حيواتنا. نتجاهل بسهولة كبيرة الحقيقة الأغبى، ومع ذلك أعمقها حيال وجودنا، وهي أنه زائلٌ. تبدو الحقيقة المرة عن فنائنا غير قابلة للتصديق إلى حد أننا نعيش فعليًا كما لو كنا خالدين، كما لو سنمتلك دومًا الفرصة لمعالجة آمالنا المؤجلة ذات يوم. سيكون وقت لذلك السنة القادمة، أو التي تليها. لكن بتضخيم مخاطر الفشل، نقلل من جدية المخاطر الكامنة في السلبية. بالمقابلة مع الفكرة المرعبة لرحيلنا الأخير، فإن الآلام والمتاعب الناجمة عن خطواتنا الجريئة الأخطر لا تبدو بذلك الرعب في نهاية المطاف. علينا تعلم إخافة أنفسنا أكثر بقليل في جانب عسى أن يقل خوفنا في الجوانب الأخرى.

شاب يحمل جمجمة، 1626 لوحة الرسام فرانس هالس. هذه اللوحة ترمز إلى نوع فانيتاس (فن الخواء)، وهو تذكير بزوال الحياة، وسمته الجمجمة في العادة.
تكاد تثير استغرابَنا معاناتُنا فكرة المدة الزمنية التي سنقضيها هنا. بداية تبدو الحياة لا نهائية. في سن السابعة يبدو كما لو سننتظر إلى الأبد حتي يحين موعد أعياد الميلاد. في سن الحادية عشرة قد يبدو من المستحيل تصور معنى أن نبلغ الثانية والعشرين. في الثانية والعشرين، يبدو الثلاثون بعيدًا بنحوٍ سخيف. تؤذينا فكرة الوقت كونه يبدو طويلًا جدًا، ومع ذلك يتبين أنه قصير جدًا. عادة، لا ينشغل الناس بفكرة الموت إلا في أحداث قليلة مختارة من حياتهم. إن بلوغ الأربعين أو الخمسين يمكن أن يؤدي إلى انعكاس مفاجئ للمنظور. ينتابنا الذعر أو يصيبنا الاكتئاب. نشتري سيارة جديدة أو نتناول آلة موسيقية. ومع ذلك، فإن ما يشير إليه هذا حقًا هو فشل دراماتيكي في الترقب. إن الجانب الاستثنائي ليس في أننا نموت، بل في أن الوعي بحقيقة طبيعة الوجود لم يرسَّخ في أدمغتنا في لحظة مبكرة وأكثر ملاءمة. إن أزمة منتصف العمر ليست صحوة مشروعة، بل علامة تفضح فقر استعدادنا لحقيقة الفناء.
لا ينبغي لنا أن نحتاج إلى ما يوقظنا لاحقًا. في الثقافة المثالية، سيؤثر فينا فناؤنا بمنهجية منذ سن مبكرة. سيكون يومٌ محددٌ في كل شهر مخصوصا لحضور الجميع جنازة شخص غريب. كل نشرة أخبار سيتبعها بث مباشر من دار رعاية. يبدأ التوجيه المهني بتأمل قصير حول مدى انتشار النوبات القلبية وسرطان البنكرياس. سيكون لدينا نصب تذكارية قاتمة بنحوٍ مثير للإعجاب في جميع أنحاء مدننا (في مواقف السيارات في السوبر ماركت وحول ملاعب كرة القدم): “إلى أولئك الذين أهدروا حياتهم”. سيُتعامل مع القلق حيال وجهة الحياة على أنه سمة مثيرة للإعجاب ومهمة. غالبًا ما تسمع الناس يقولون: “أنا معجبٌ بفلانٍ حقًا فهو قلقٌ جدا بشأن إهدار حياته”. حتى بدون هذا الدعم المثالي على مستوى المجتمع ثمة خطوات يمكننا اتباعها بأنفسنا تعمل على تكثيف وعينا بمحدودية مدتنا الزمنية بنحوٍ مفيد: يجب أن نكوّن مجموعتنا الخاصة من التنبيهات، ربما تمثال جمجمة، أو مجموعة من إحصائيات السرطان، أو صورة مكبرة من نوع الشعيرات الدموية التي يمكن أن تؤدي لسكتة دماغية. نحن بحاجة إلى لقاءات منتظمة وفعالة مع تذكير بأنَّ شيئًا آخر يُوجب خوفنا أكثر بكثير من مجرد الإحراج الناتج عن الإمساك بيد شخص ما، أو تكبد القليل من المتاعب عند تغيير تخصصنا الجامعي.
1- الأعمال الكاملة: رباعيات أربع ت. س. اليوت، ترجمة توفيق صايغ، ص ١٣٢. (المترجمة).