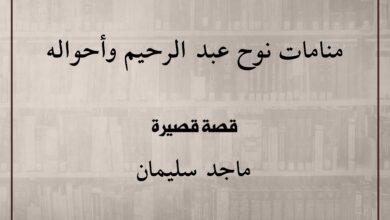خيوط
قصة قصيرة

أعرف هذا المكان وتحفظه ذاكرتي جيداً. صفي الدراسي، الصف الرابع. وهؤلاء الذين يضجون ويملؤون الحجرة صياحاً هم أصدقائي. وهذا الذي يقف يائساً أمام اللوح هو معلمي. أتقدم خطوات وأجول ببصري على المقاعد المصطفة فيقع اختياري على المقعد الأخير. أضع حقيبتي الثقيلة على الأرض وأجلس في مقعدي. يصرخ المعلم فجأة وقد انتفخت أوداجه وكادت عيناه أن تخرجا من محجريهما كفى يا أولاد! هيا، ليضع كل منكم كراسته أمامه وليكتب خلفي ما سأكتبه الآن. خمس دقائق وسأمحو كل ما مكتوب على اللوح، والويل لمن سأرى كراسته فارغة! أرعبتني جدية أستاذي في توبيخه لنا ففتحت حقيبتي مسرعاً وأخرجت كراستي ثم أخرجت القلم من جيب الحقيبة. حاول صديقي على المقعد أن يضحكني بنكتة اخترعها لتوه لكنني تجاهلته وأمسكت بقلمي. وما إن بدأت أكتب حتى شعرت بشيء يضغط على معصمي بخفة. دققتُ النظر فإذا بخيط رفيع لا يكاد يُرى معقود بإحكام حول يديّ، وفي نهاية تلك العقدة خيطٌ يمتد طويلاً جداً حتى اضطررت أن ارفع رأسي لأرى نهايته، فإذا هو يصل إلى السقف. نظرت إلى سقف الفصل فراعني منظره. لم يكن سقف فصلنا الخرساني الذي اعتدت وجوده. بل كان مجرد أقمشة حريرية ثقيلة رُصت فوق بعضها بإهمال. شاهدت خيوطاً أخرى ممتدة نحو ذلك السقف. تتبعتها فوجدت أنها قد لفت حول قدميّ أيضاً بل إن أحدها قد عُقد حول جزء من شعري. تحسستُ رأسي واتضح أنني محق. يا للرعب! إنني أبدو كدمى المسرح المخيفة التي أكرهها. لكن لم لا يتحدث أصدقائي حول مظهري؟ لماذا لم ينتبهوا لهاته الخيوط المعقودة حول جسدي؟ ألا أبدو لهم مخيفاً؟ أو في الأقل سخيفاً ومضحكاً بمنظري هذا؟ لم أكن مرتعباً أو خائفاً بقدر ما كنت مندهشاً من وجودها. وسط تعجبي واندهاشي سمعت خشخشة في الأعلى فرفعت رأسي لأنظر. وما أغرب ما رأيته! كان ثَمَّ يدان تبرزان من وسط تلك الأقمشة، إحداهما خشنة ومليئة بالشعر والأخرى بيضاء ناعمة. كانتا تمسكان بأصابعهما الخيوط التي تلتف حول جسدي ورأسي وتتحركان ببطء وثبات. ثوانٍ قليلة وإذا برأسين لا أجهلهما يظهران خلف تلك الأيدي. هذان رأسا والداي، نعم. تنفرج شفاههما عن ابتسامة ماكرة، ويحدقان إلى بأعين وادعة رفيقة. كانا صامتين تماماً وكذلك كنت أنا. لم أندهش لرؤيتهما هنا في فصلي وبين أصدقائي، بل على العكس أحسست بسعادة بالغة، حتى لم أعد مهتماً إن كان شكلي سيبدو مضحكاً بهاتهِ الخيوط الغريبة أم لا. رن جرس الفسحة فشاهدتهما مجددا يمسكان بالخيوط حول جسدي ويطلان برأسيهما من خلف الأقمشة الحريرية ذاتها. لم يكن ثمة وجود للسماء التي أعرفها ولا للأسقف المسطحة، بل أقمشة حريرية في كل مكان!
في الظهيرة عندما غادرت بوابة المدرسة كانت الخيوط موجودة أيضاً تتحكم بسيري وتوجهني حيث أرادت يدا والداي في الأعلى. وكنت أسير سعيداً لا مبالياً بوجودها!
هأنذا الآن في الحي الخلفي لمنزلنا أستعد وبعض رفاقي في الثانوية لخوض مباراة كرة القدم مع مجموعة أولاد من الحي المجاور. يبدأ رفيقي أحمد، الذي يتولى دائماً تقسيم الفريق بتوزيع المهام علينا، حاتم أنت حارس المرمى كما أتفقنا، أثق بك. هيا لا تحدق هكذا ببلاهة وارتدِ قفازاتك.
وجه أحمد حديثه هذا إلي منفعلاً بشدة ومتقمصاً دور الكابتن الذي يحمل على عاتقه مسؤولية منتخب دولة لا فريق أولاد الحارة! تأخر الفريق الخصم فأخذنا نناقش خطة اللعب، وأدلى كل واحد منا بدلوه. وبينا نحن في غمرة نقاشنا إذ مرت بالقرب منا فتاة في مثل عمرنا، فتوقف معظم رفاقي عن النقاش وأخذوا يلقون نكات تافهة وأبصارهم تشيعها. أفرغ أحدهم ما في جعبته من كلمات غزل كان قد حفظها من شباب حارتنا الكبار، وأتبع ذلك بكلام بذيء اشمأززت منه لدى سماعي إياه، لكن جميع الرفاق من حولي أخذوا يقهقهون بصوت عالٍ معجبين ببراعته وظرافته المعهودة. ساءني تصرفهم ذلك وأغضبني فرحت أقول مندفعاً ألا تخجلون؟ إن ما تفعلونه لأمر مشين و منافٍ للأخلاق وأنتم تعلمون هذا!
تطلعوا إلي جميعاً بنظرات هازئة مستنكرة وانبرى رفيقي أحمد ليقول
– حاتم ألا تسأم من لعب دور الرجل الشريف؟ جرب أن تلعب دوراً آخر ربما يكون مُسلياً أكثر من هذا!
ضجَّ الجميع بالضحك مرة أخرى. ربما أكون مبالغاً كما يظنون! لا بل أظنني على صواب ولست أبالغ. وكعادتي، حاصرتني الشكوك للحظات بما أعتنق من مبادئ كنت أحسب أنها واضحة جلية كصفحة الماء ولا يختلف فيها اثنان. هل أنا مجرد متزمت ثقيل يعتقد -بغرور- أنه إنسان سوي وشريف؟ هل أكون أنا وحدي على صواب فيما كل هؤلاء الرفاق على خطأ! لست أدري ربما أكون كذلك.
زاد ضحكهم اشمئزازي فاستشطت غضباً ونويت أن أغادرهم الآن ودون تأخير، لكنني سرعان ما تراجعت إذ تذكرت أن مباراة اليوم مهمة وحاسمة ولا يجدر بي أن أضيعها لنزوة غضب لا مفر من أن تزول وتنتهي. حضر الفريق الخصم فأخذ كل لاعب منا مكانه وأخذت أنا مكاني عند شِباك المرمى. حملت القفازات وهممتُ بارتدائها، لكن شيئا مرعباً باغتني وجوده. أجل تلك الخيوط اللعينة! مجدداً رأيتها معقودة حول جسدي. نظرت إلى الأعلى. الأقمشة الحريرية تغطي السماء. ماذا أصنع الآن. داهمني الخوف وبدا الارتباك واضحاً على ملامحي. سأصبح أضحوكة بلا شك. سيضحك جميع الرفاق الآن لسبب منطقي. ألا يعقل أنهم لم ينتبهوا إليها حتى اللحظة؟ أو ربما انتبهوا وتجاهلوا. لا! شيءٌ كهذا لا يمكن تجاهله. ما الذي عليّ فعله؟ هل أنزعها أم أدعها على ما هي عليه وأواصل اللعب؟ لكن.. إذا نزعتها فسوف أضل طريقي إلى المنزل، فهي التي تعينني على معرفة الطرق والسير بأمان. إن رأسي يؤلمني ولا متسع من الوقت لدي لأفكر بعقلانية، ستبدأ المباراة الآن. رباه هل من حل لهذه المعضلة!
ترررن ترررن! رن جرس المنبه اللعين. إنها السابعة صباحاً. نهضت من على سريريَ الوثيرِ بصعوبة، فاغتسلت وارتديت ملابسي وشربت الشاي الذي أعدته أمي، كل ذلك في غضون عشر دقائق فقط. حزمت أوراقي ووضعتها في حقيبة سوداء متوسطة الحجم أحملها على كتفي كل صباح وأنا في طريقي لخوض معركة البحث عن عمل. على الطريق العام وقفت أنتظر حافلة تُقلني إلى موقع إحدى الشركات الخاصة التي أعلنت قبل يومين عن وجود وظائف شاغرة لديها. ركبت حافلة صغيرة وحافلة أخرى بعدها ثم حافلة ثالثة. ثلاث حافلات لأصل إلى موقع الشركة. لكم أن تتخيلوا مقدار ما أعانيه في سبيل أن أجد وظيفة لائقة. بل أنا راضٍ حتى بأقل من لائقة، المهم أن تتوفر لدي الخبرة. هاته التي يطالبني بها الجميع ولا أعلم كيف أجدها. أحيانا يراودني شعور بأنها ليست سوى مؤامرة كونية حيكت ضدي. هذه الخبرة. أعرف صديقاً درس معي في ذات الكلية وكان لا يحضر إلا مرة في الشهر، وإن حضر فعقله في عالم آخر. وهو يعمل الآن في إحدى المؤسسات الحكومية. متى تسنى له أن يمتلك الخبرة؟ هل يعيش في عالم غير عالمنا هذا له قوانين تخصه وحده؟ وآخر أيضاً هو أسوأ من سابقه. كنا لا نرى وجهه إلا في الامتحانات. ولا يعلم إلا الله كيف كان يجتازها. والآن هو صاحب منصب مرموق في إحدى الشركات. كيف يكون ذلك؟ يقول لي كثيرون السر في العلاقات. كن أخطبوطاً! سر مع هذا واضحك مع ذاك، امدح فلاناً في وجهه وابصق عليه حين يولي ظهره. لا! لا طاقة لي بهذا. إن معناه أن انسلخ من طبيعتي التي ولدت و نشأت عليها. مع ذلك بدأت أحس أن ليس هنالك سوى خيارين أمامي. الانسلاخ ومعيشة ميسرة تضمن لي حياة رغدة أو الثبات وشظف العيش! حيرة تواجهني كل يوم، وتجعل رأسي يدور وتصيبني بالغثيان. ألا يوجد حلٌ بين هذا وهذا هنا؟ ولماذا لم يخبرني أحدهم بذلك قبل أن أخوض معارك تُكلل بالهزيمة في كل مرة.
أوقفتني الحافلة بالقرب من الشركة فأكملت الطريق مشياً تحت لهيب شمس محرقة. وصلت فاجتزت مكاتب عديدة -وكنت أحفظ هذه الخطوات عن ظهر غيب- وفي الطابق الثاني قابلت مدير الموارد البشرية. بدا لي رجلاً معتداً بنفسه مؤمنا بأهمية ما يقوم به كما هي عادة هذا النوع من الموظفين. ثم بدأت الأسئلة الروتينية المرهقة. ورحت أجيب كأني كنت مُسجلاً يضغط أحدهم على رأسه فيعيد الهراء ذاته في كل مقابلة. حاتم كريم. بكالوريوس نظم معلومات مع مرتبة الشرف. حائز على شهادة في دورة كذا ومن معهد كذا..
– ماذا عن سنوات الخبرة؟
– لا يوجد.
– أها. لا بأس. أجاب بذلك فيما ارتسمت ابتسامة حقيرة على وجهه عرفت منها أن لا مكان لي هنا. هممتُ بأن أقول ولكني أعرف أُناساً وُظفوا من دون خبرة. ما السبب برأيك؟ لكن الإجابة معروفة وواضحة ولا داعي لإحراج نفسي. سيقولون ما شأننا بهم؟ هذه شركة لها وزنها وسمعتها ولديها معايير وقوانين لا تحيد عنها.
عند عتبة الباب وقفت ممسكا بحقيبتي التي أفرغت حملها دون فائدة. رفعت يدي لأحجب شعاع الشمس عن وجهي وإذا بي أرى الخيوط اللعينة ذاتها معقودة حولها. لا لن أبقى على هذه الحال. سئمت وأصابني التعب. سأمزق هاته الخيوط. لا حاجة لي بها بعد الآن. سأمزقها حتى وإن كنت لن أعرف طريقاً للعودة بعد ذلك. وأخذت أمزقها بضراوة. فككت ما استعصى علي منها بأسناني مثل وحش مجوّع هائج. عندما انتهيت أخذت أسير في الطرقات كالأبله واسأل كل من أقابله يا عم هل تعرف الطريق إلى خور مكسر من أين؟
– من هنا يا بُني.
لكن الطرقات بدت لي مختلفة عما كنت أعهده. تغيرت معالمها. أخذت أركض مرعوباً وأنعطف من حي إلى آخر. أسأل كل من يقابلني هل تعرف الطريق إلى الخور؟ فيرد هل تبحث عن مكان ما هناك. لم أنت مضطرب هكذا؟ لست مضطرباً يا هذا إنني أبحث عن بيتي! أضعت بيتنا. نسيت الطريق إليه. واستمررت بالركض حتى لم تعد قدماي تقويان على حملي. أصابهما خدرٌ غريب كأنما قد انفصلتا عن جسدي وأخذتا تسيران دونما إرادتي. أخذت وجوه المارة تحاصرني وتبث في أوصالي رعباً مضاعفاً. وجوه كثيرة تظهر تارة بملامح سليمة وتارة مشوهة. أراها تحدجني بنظرات غريبة. نظرات مشفقة، وأخرى هازئة. أسمع وشوشاتهم التي ترتفع إلى صيحات تكاد تمزق طبلة أذني
– ربما فقد عقله! مجنون بلا شك! رجل في الخامس والعشرين من عمره يتوه عن بيته، غير معقول! هذا كثير.. الطريق واضحة وقل من يتوه فيها!
أخذت أركض وأركض. تلاحقني صيحات هؤلاء الناس وتخترقني نظراتهم كخنجر مسموم يكاد يمزق روحي. إلى أين أهرب! أين الطريق وأين الوجهة. أشعر بأنفاسي تتلاحق وتكاد تنقطع. رعب خانق. ضباب.. ضباب يلف كل شيء. ثم أستيقظ أخيراً! يبلل العرق ملابسي ويخفق قلبي بعنف. لقد كان حلماً مفزعاً. الخيوط المعقودة والأقمشة الحريرية، ووالداي الطيبان المعلقين خلفها! كل ذلك كان كابوساً رهيباً.
فاطمة ياسر: قاصة من اليمن.