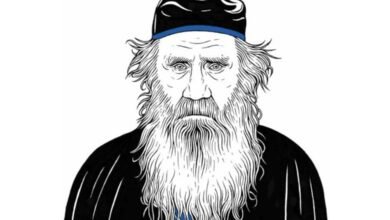توما الأكويني (1225-1274)
Great Thinkers

ترجمة: موسى جعفر
قد يبدو غريبًا للوهلة الأولى أن نتتلمذ على يدي توما الأكويني فهو بعد كل شيء قديس من القرون الوسطى قيل إنه يرتقي في الهواء، وتراوده رؤى عن مريم العذراء. وكان مهتمًا كثيرًا بتفسير كيف تتحدث الملائكة وتتحرك. لكنه رغم ذلك مهمٌ لنا فهو يساعدنا في حل المشكلة التي ما زالت قائمة إلى اليوم: كيف نصالح بين الدين والعلم، والمنطق والإيمان. كان الأكويني فيلسوفًا وقديسًا ورعًا، استحدث فهمًا جديدًا لموضع المنطق في حياة الإنسان انطلاقًا من رفضه خسارة إيمانه أو الإيمان بغير دراية. وأكبر مساهماته هي تعليم مجتمع غرب أوروبا أن أي امرئ يستطيع -مسيحيًا كان أو غير ذلك- معرفة الحقائق الكبرى متى ما استخدم هبة الرب الأعظم إلى البشر: المنطق. لقد حل معضلة في تفكير المسيحيين هي تساؤل أنى لغير المسيحيين أن يملكوا الحكمة وليس لهم اهتمام بالمسيح أو علم به على الإطلاق. لقد عَولَم الذكاء وفتح عقول المسيحيين على رؤى الإنسانية جمعاء من كل القارات والأوقات. نحن ندين للأكويني بعالمنا الحالي، الذي يصر على أن الأفكار الصالحة يمكن أن تنبع من أي مكان في العالم بغض النظر عن العقيدة والخلفية.
ولد توما الأكويني لعائلة إيطالية نبيلة في عام 1225. وارتاد في شبابه جامعة نابولي، وهناك تعرف على مصدر معرفة كان يعاد اكتشافه حينها هو مؤلفات الرومان القدماء والإغريقيين، الذين نبذت الأكاديمية المسيحية أعمالهم في السابق. وتأثر هناك أيضًا بالرهبنة الدومينيكانية، وهم مجموعة رهبان اختلفوا عن الفرق السابقة بالاعتقاد أنهم يجب أن يعيشوا في العالم الخارجي لا في دير.
قرر الأكويني أن ينضم إلى هذه الفرقة معارضًا إرادة عائلته. لكن «وَرَعهم» جعلهم يخطفونه ويحبسونه في برج امتلكوه. ورغم أنه كتب من معقله رسائل يأس إلى البابا استعرض فيها قضيته والتمس أن يطلق سراحه، كان البابا مشغولًا بالقضايا السياسية حينها، فظل الأكويني في البرج محبوسًا، وأمضى الوقت يكتب الرسائل إلى الرهبان الدومينيكانيين ويرشد أخواته. ويروى أن عائلته أرسلت إليه في تلك المدة مومسًا ترتدي ثيابًا مكشوفة الصدر بأمل أن تغريه بعيدًا عن فكرة الرهبنة، لكن الأكويني طرد الشابة بقضيب حديدي.
بعد أن أدركت عائلته ألا فائدة من حبس ابنهم «الضال»، أطلق سراح الأكويني أخيرًا ليلتحق برهبان الدومينيكانية. فارتحل إلى باريس ليستكمل في جامعتها تعليمه الذي قوطع فكان طالبًا هادئًا لكنه مؤلفًا غزير الإنتاج على نحو استثنائي، إذ أَلَّف قرابة 200 جزءٍ عن اللاهوت المسيحي في أقل من ثلاثة عقود. تميزت عناوين كتبه بالجمال والغرابة مثل الخلاصة اللاهوتية والخلاصة ضد الوثنيين. أيضًا فقد أصبح معلمًا مشهورًا جدًا وشديد التأثير، وسمحت له القيادة الدومينيكانية في النهاية بتأسيس مدرسته الخاصة في نابولي. هذا وبلغ تفانيه للمعرفة أنه حتى في آخر أيام عمره البالغ تسعة وأربعين عامًا عملَ على كتابة تعليق موسع لسفر نشيد الإنشاد. وطُوِّبَ بعد موته في الكنيسة الكاثوليكية، وهو اليوم القديس الشفيع للمعلمين.
تمثّل أحد طموحات الأكويني الثقافية الأساسية في فهم كيف للناس أن يميّزوا الصحيح من الخطأ، بمعزل عن الاهتمام الأكاديمي لأنه أراد لكونه مسيحيًا معرفة كيف للشخص أن يكون واثقًا أن أعماله ستسمح له بدخول الجنة. علمَ الأكويني أفكارًا كثيرة تبدو صائبة بحق نتجت عن غير المسيحيين. على سبيل المثال فهو قد احترم أرسطو خصوصًا، الرجل غير المطلع على حقائق الإنجيل إطلاقًا. وبسبب هذه المعضلة، وضع الأكويني حجة بالغة الأهمية لتوافق المعتقد الديني والفكرة المنطقية.
وكان يعلم أن الكثير من الفلاسفة وثنيين لكن ذلك لم يحجب البصيرة عنهم! لذا اقترح آنذاك إمكانية استكشاف العالم بإجادة عبر المنطق فقط. افترض الأكويني لنجاح ذلك التقسيم أن الكون وكل حركاته تعمل وفق نوعين من القوانين: «القانون الطبيعي» و«القانون الأزلي» المقدس. واعتقد أن العديد من القوانين يمكن استنباطها من تجربتنا الحياتية. فيمكننا أن نكتشف كيف نصهر الحديد، أو ننشئ قناة للماء، أو ننظم اقتصادًا عادلًا، وهذه هي القوانين الطبيعية. لكنه أيضًا اعتقد أن هناك قوانين أزلية منزَّلة، وهي الأشياء التي لا يستطيع المنطق استنباطها بمفرده، كمعرفة أننا سنحاسب بعد الموت من رب رحيم، أو أن المسيح كان مقدسًا وبشريًا في ذات الحين، ولمعرفتها يجب علينا الاعتماد على الوحي في الكتب المقدسة: يجب علينا التسليم به إيمانًا بسلطة أعلى.
حدد الأكويني في شرح كتبه عن الفيلسوف الروماني بوثيوس اعتقادًا يشيع آنذاك هو «يعجز العقل البشري عن معرفة أي حقيقة ما لم ينر ضياء الرب بصيرته»، أي إن كل شيء يُهمِّنا فهمه يجب أن يصدر من مصدر موثوق منفرد هو الرب. لكن هذا الاعتقاد كان بالضد من الفكرة السابقة التي حاجج بها الأكويني من أن «ليس من الضروري أن يتفتح العقل البشري بنور جديد من الرب لفهم تلك الأشياء المندرجة في مجال معرفته الطبيعي».
كانت الحركة الثورية التي يحركها الأكويني تهدف أيضًا إلى وهب «القانون الطبيعي» مساحة مهمة. إذ أشادَ بأهمية التجربة والملاحظة الذاتية. وقلقه كان من أن الإنجيل مصدر رفيع المستوى قد يبتلع الملاحظة: وينبهر الناس بالوحي من السلطة العليا فيهملون تأثير الملاحظة وما نستطيع أن نكتشفه بنفسنا.
الفكرة التي أوضحها الأكويني هي أن كلا من القانون الطبيعي والقانون الأزلي المنزل مهم. فهما ليسا متناقضين بالضرورة. بل إن المشكلة تنبع حين نعتمد على واحد منهما وحسب. وأيهما يجب علينا تطويره يعتمد على الميل الذي لدينا حاليًا.
ما زال التوتر بين السلطة الأعلى والتجربة الشخصية قائمًا إلى الآن رغم أن «وحي» السلطة العليا اليوم لا يعني العودة إلى الإنجيل بالطبع، بل العلم المنظم. النسخة العصرية من ذلك هي إنكار أي نوع من المعرفة لا يتفق مع المعلومات المكدَّسة من التجارب والبيانات والنمذجة الرياضية ومراجع الدوريات المراجعة من النظراء.
يشغل الفن والأدب والفلسفة اليوم الحيز الذي عرَّفه الأكويني بالقانون الطبيعي. فهي تحاول فهم العالم من منطلق التجربة الشخصية، والملاحظة والتفكير الذاتي. إنها ليست موثقة بختم السلطة الأعلى، التي صارت العلم بدلًا من الإنجيل.
كان معاصرو الأكويني مدركين عموما للإغريقيين والرومانيين القدماء، لكن نظرتهم كانت أن «الوثنيين» ليس لديهم شيء مفيد في أي موضوع ظنوا أنه يهمهم. لم يكن خطأ القدماء أنهم عاشوا قبل المسيح، لكنهم -بنظر السالف ذكرهم- مخطئون في أهم قضية في الحياة: المعتقد الديني. وهذا بدا عيبًا فظيعًا فلا شيء آخر فكر فيه الفلاسفة الوثنيون يمكن أن يكون مفيدًا أو مهمًا. لكن الأكويني حاجج بإمكانية أن يملك الذين ضلوا في بعض الأشياء الأساسية الكثير لتعليمنا إياه، لقد كان يشخص حالة من الخيلاء الفكري. لدينا ميل لإنكار الأفكار بناء على خلفيتها، أي إننا لن نرغب بالاستماع إلى شيء ما لم يأت من «المكان المناسب». وقد نعرف المكان المناسب اليوم بأنه مختبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عوضًا عن الإنجيل سابقًا، لكن الدافع ما زال نفسه.
وهكذا فإن الملحد الحداثوي المقيم في لندن مثلًا قد يرى من غير المعقول أن ينتفع بشيء من قراءة إنجيل يوحنا لأنه يعتقد أن في الإنجيل أخطاء جلية في نقاط جوهرية: إنه محشو بمعجزات مختلقة، وفيه أخطاء بدائية عن أصل العالم. وهذا مشابه لتفكير مسيحيي القرون الوسطى عن الكتّاب القدماء الكافرين.
إنَّ نقطة الأكويني الأساسية هي القانون الطبيعي فرع من القانون الأزلي، ويمكن اكتشافه بملكة المنطق المستقل. ضرب الأكويني وصية المسيح «اصنع معروفك للآخر كما تحب معروف الآخر لك» مثالًا، فقال إن المسيح ربما وهب لهذه الفكرة صيغة معينة بارزة، لكنها كانت حجر أساس المبادئ الأخلاقية في معظم المجتمعات على مر العصور. كيف يكون هذا؟ حاجج الأكويني أن السبب هو عدم حاجة القانون الطبيعي إلى تدخل الرب المباشر ليكون معروفًا للبشر. فالواحد سيتبع مقاصد الرب تلقائيًا بالتفكير المنطقي الدقيق وحده.
انبثقت أفكار الأكويني في وقت كانت الحضارة الإسلامية تعاني فيه، كما المسيحية، معضلةَ إعادة توفيق الإيمان والمنطق. ازدهرت الخلافة الإسلامية وقتا طويلا في إسبانيا والمغرب ومصر منتجةً ثروة معارف وفلسفات جديدة. لكنها أصبحت بسبب نفوذ القادة المتعصبين دينيًا، أكثر تزمتًا وجورًا في وقت ولادة الأكويني. فهي على سبيل المثال تجاوبت بعنف مع الفيلسوف الإسلامي ابن رشد، الذي كان -كما الأكويني- متأثرًا بأرسطو بشدة، وحاجج أن المنطق والدين متوافقان. على أي حال، فقد حرص الخليفة -المهووس بألا يهجر كلمات الله الحرفية- على حظر أفكار ابن رشد وحرق كتبه.
قرأ الأكويني لابن رشد ورأى أنه يشترك مع العالم المسلم بمشاريع مماثلة. لقد علم أن رفض العالم الإسلامي الثوري المتزايد للمنطق يضر بحضارته الفكرية التي كانت مزدهرة يومًا. وبفضل أفكار الأكويني -ولو جزئيًا- لم تعانِ المسيحية من عمليات التسفيه التي حدثت في الإسلام.
كان الأكويني رجلًا شديد الإيمان لكنه وضع نظامًا فلسفيًا لعمليات الشك والتحقيق العلمي المفتوح. إنه ينبهنا إلى أن الحكمة (بمعنى الأفكار التي نحتاج إليها) تأتي من مصادر متعددة: من البديهة لكن أيضًا من المنطق، من العلم وأيضًا من الوحي، من الوثنيين أو الرهبان. كان القديس متفهمًا لجميع ما ذكر، وأخذ واستخدم كل ما كان ناجحًا، بغض النظر عن مصدر الأفكار. قد يبدو هذا واضحًا اليوم، لكن ألا تلاحظ كم أننا نحيد عن هذا النهج في حياتنا؟ كم من الأحيان نرفض فكرة لأنها تأتي فقط مما نراه «مصدرًا خاطئًا»، كأن يكون شخصًا بلهجة معيوبة، أو جريدة بمبدأ سياسي يختلف عنا، أو أسلوب نظم يبدو معقدًا أو يسيرًا، أو عجوزًا ترتدي طاقية صوفية…