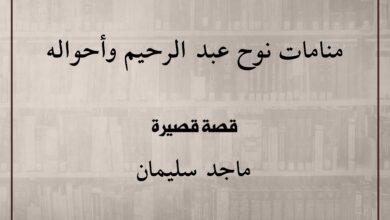الحبُّ وشيء آخر
قصة قصيرة

أعاين هندامي وقيافتي وأنا أقف أمام مرآة الخزانة المشعورة. “أريد أن أحب. بتُّ قادرًا عليه ومملوءًا به”. (سمعت هذه العبارة في أثناء عقد قران قريب لنا ولم أفهم معناها)، أحادث نفسي، ثمَّ أخرج قنّينة العطر الَّتي أهدانيها صديق لي في عيد ميلادي الأخير وأطفق أغتسل بها.
“مشط العرايس. ماذا تفعل؟ خنقتنا برائحة عطرك”.
تنهرني عمَّتي من غرفة الجلوس فلا أردُّ عليها. كنت مشغولًا بالفكرة والقرار.
“لا ينقصني شيء لتنفيذ قراري. ملابسي ما زالت جديدة، وعطري، كما يخبر الحال، شغَّال ومؤثِّر. صحيح أنَّ سحنتي لا تزال زائغة الملامح، فلحيتي مثل غزل البنات والحبوب تحتلُّ أرنبة أنفي وبعضًا من خدودي، لكنَّ المنظر العام يسمح بالحب”.
أتوقَّف هنيهة وأنا أقلِّب الكلمات التَّالية في فكري، ثمَّ أتابع “ثمَّ إنَّ الحبيبة موجودة، أو هكذا أحسبها. نعم، صحيح، إنَّها ابنة الجيران كما في معظم الحكايات الَّتي سمعتها في المذياع أو تابعتها على التلفاز. هي أنضج منِّي على ما أعتقد. تفاصيل جسدها توحي بذلك. لكنَّ الحبَّ لا يعترف بهذه الفوارق، بل هو يعترف بدقَّات القلب والتَّفاعل الكيماوي ما بين الخفقة والنَّظرة”.
أقف عند النَّافذة وأنظر باتِّجاه بيتها. أراها هناك تستند إلى إطار النَّافذة كعادتها كلَّ يوم، وتنقر بأصابعها على الحافَّة بتضجُّر هادئ وهي تتابع حركة المارَّة في الشَّارع وضياع الدَّقائق. لم أستطع أن أنظر أكثر فقد لمحتني. أرسلت إلي غمزة من عينيها الفائرتين، فغاب نظري عن الوعي.
حتَّى الآن لم يرتقِ ناظري أعلى من مستوى توسُّد ذراعيها عندما يتابعها.
هي التَّعليمات نفسها الَّتي أطلقها على مسامع قريبي وأنا أعلِّمه قيادة الدَّرّاجة. كانت الفكرة الّتي استندت إليها في ذلك هي الشّائعة: المحافظة على التَّوازن. ولفعل هذا كان الأمر مباشرًا: ركِّز بصرك على المقود أو الذِّراعين. أسند الدَّرّاجة بكلتا يديَّ كي يقودها مطمئنًّا، ثمَّ أفلتها بعد مسافة قليلة دون أن أخبره. نجحت الفكرة، لكنَّه اصطدم بعمود لم يره. نكرِّر العمليَّة ونركِّز على التَّوازن، فيذهل البصر عن المحيط ليصطدم مرَّة أخرى بعائق آخر. لكنَّه هذه المرَّة تمكَّن من الإمساك بمقود الدَّراجة بقوَّة وسيطر على توازنه.
عندما لمحتها صدفة من بعيد مضى قلبي يهبط أضلعي خفقتين خفقتين وهو يهرول للقائها. تجرَّأت يومها على رفع بصري إليها قليلًا فصار عند مستوى النَّحر. عند ذلك الارتفاع شعرت بدوار يلفُّ رأسي، فراح نظري يتزحلق متعثِّرًا وصولًا إلى ملتقى النَّهدين. من يومها اكتشفت أنَّني مصاب برُهاب المرتفعات.
“الآن، حافظ على توازنك وارفع نظرك لترى ما حولك”.
رحت أحدِّث نفسي دون أن أجرؤ على تحييد بصري الَّذي بدأ يزيغ نتيجة الطَّلعات والنَّزلات الَّتي فرضته عليه جغرافيا جسدها. وكأنَّها حدست بما يجول في رأسي، فهزَّت صدرها كي تُسقط ما علق به من نظراتي ومضت دون أن تلتفت.
“احتفظ بتوازنك وارفع نظرك كي لا تصطدم بشيء”. هكذا نصحته وهو يحاول للمرَّة الألف تحقيق معادلة التَّوازن والتَّواصل البصري مع تضاريس المحيط ومنحنياته. استطاع تلافي العمود والرَّصيف والمركون من العربات، لكنَّه لم يستطع التَّحكُّم بالدَّرّاجة دون أن يتابع أين تمشي الدَّواليب، فوقع مجدَّدًا.
في صدفة جديدة أحاول أن أرفع نظري ببطء كي يعانق نظراتها. أصعد به وأصعد مرورًا بنحرها ورقبتها وشفتيها وأنفها. كانت تبتسم باستخفاف ولؤم.
“حافظ على توازنك وتركيز بصرك. أبق رأسك مرفوعًا”.
لم أنبس ببنت شفة. عادت كلُّ النَّظرات إلى التَّساقط على الدَّرب المؤدّي إلى عينيها وتجمَّعت عند ذاك الملتقى حيث أصابني الدُّوار في مرَّة سابقة. لم تهزهز صدرها كما فعلت في تلك الصُّدفة، بل بقيت ساكنة وهادئة، ثمَّ غمزتني وغادرت بلا مبالاة وهي تداعب بأصابعها نظراتي الَّتي تعلَّقت بها.
“أهذا هو الحبُّ؟ إنَّه سهل جدًّا. ما عليَّ سوى النَّظر وما عليها إلّا الابتسام. الباقي تتكفَّل به تضاريسها وحرارتي”.
أبقي على وقفتي وأنا أتابع قيادته المتردِّدة. التَّوازن موجود، النَّظر مركَّز، والرَّأس مرفوع، لكن، ترتجف الدَّراجة نتيجة اضطراب حركة السَّاقين، فما يزال الارتجاف يراودهما بين الحين والآخر، إنَّما، لا بأس. الدَّراجة تسير، والقيادة تتحسَّن، وخفقات القلب تنتظم. ويبقى النَّظر معلَّقًا بين شفتيها.
“أريد أن أحبَّك، فهل تسمحين لي بذلك؟”.
تطلق ضحكة رنَّانة تسقط نظري صريعًا ليهمد عند الملتقى المكشوف دوماً.
“كم تدفع لقاء سماحي لك بحبّي؟”، وتتابع قهقهتها.
يغرق بصري هناك. فأتابع سياسة ضبط النَّظر والنَّبض.
“متى كان تبادل المشاعر مدفوع الثَّمن؟”. أردت أن أسألها لكنَّها تتركني وتمضي صاعدة إلى شقَّتهم، أو ربَّما هي روحي الَّتي تصعد إلى القمر. أشقُّ طريقي بين ما تساقط عنها من خفقاتي ونظراتي وقهقهاتها على درجات السُّلَّم لأدخل إلى المنزل بدوري مخذولًا.
صارت قيادته للدَّرّاجة مثاليَّة: توازن ونظرات ثابتة ورأس مرفوعة وساقان متمكِّنتان تحرِّكان الدَّوّاستين بثقة. لم يعد يخشى حائلًا أو طارئًا، بل بات قادرًا على تجاوز المطبَّات وحاويات الزِّبالة والنَّظرات وكلَّ ما يتحرَّك أو يخفق.
“صار باستطاعتك أن تحب”، أنكزه، فيضحك.
أنتظر بزوغها عند الأفق، لكنَّها لم تعد تشرق كما في الصَّباحات الخوالي.
عندما رأيتها آخر مرَّة، لم ترني، بله لم تكن ترى أحدًا. لم تكن مطرقة، لا.. لكنَّ عينيها بدتا تسابقان نفَسَها وهي، في لهفتها، لا تكاد تحاول أن تتجاوز المارَّة دون أن تصطدم بهم. حتَّى قدماها ما كانتا ثابتتين في خطوهما، بل هما تحلِّقان معها وكأنَّها تقطع ذلك الدَّرب على ظهر سحابة. عند زاوية الشَارع، حيث لمحت قريبي واقفًا، تتوقَّف وترفع نظرها حتَّى يقطع الدَّرب الطَّويل الواصل إلى عينيه. تبسم له ونظره ينساب حتَّى يقف عند ملتقى النَّهدين، حيث ما زالت ثلَّة من نظراتي الماضية متجمِّعة، فيضحك لها، ويمضيان.
بعد دروس طويلة لقريبي استطاع أن يقود درّاجته، بعد أن حافظ على توازنه.. وعلى تركيز نظره.. وعلى إبقاء رأسه مرفوعًا.. كما استطاع أن يحبَّها. أمَّا أنا، فبقيت نظراتي الأخيرة هناك، متشبِّثة بحافَّة الملتقى القديم، كذلك بقيت لا أتقن قيادة الدّرّاجات الهوائيّة، ولم أتقنها يومًا.
محمد أمين جميل الشامي: قاص من سوريا