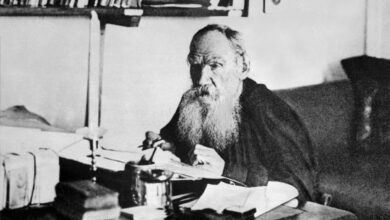ليلة – فسيفولود جارشين
قصة قصيرة

ترجمها عن الروسية: عمران أبو عين
رنّت ساعةُ الجيب الموضوعة على المكتب بنغمتين برتابة مُكررة. يَصعُبُ التمييز بين هذه النغمتين حتى لأصحاب الأُذن الحساسة، أمّا لصاحبها، وهو رجلٌ شاحب، فيجلسُ أمام هذه الطاولة، ينقرُ على هذه الساعة وكأنّها أغنية كاملة.
– قال الرجلُ الشاحبُ مُحدِّثاً نفسه هذه الأغنيةُ حزينةٌ وكئيبةٌ، الزمن نفسه يُغنيها، كأنّه يُغنيني، على نحو رتيبٍ ومدهش. قبل ثلاث سنوات، أربع، أو عشر سنوات دقّت الساعة كما الآن، وبعد عشر سنوات سوف ترنُّ كما الآن.. تماماً كما هي الآن!
وألقى الرجلُ الشاحب نظرةً مُتكدرة عليها، وعلى الفور حوّل نظره إلى ما كان ينظرُ إليه من قبل دون أن يلحظ شيئاً.
– بهذا الإيقاع مرّت الحياة بأكملها، بتنوعها الظاهر بالحزن والفرح، باليأس والبهجة، وبالكراهية والحب. والآن فقط في هذه الليلة، في الوقت الذي ينامُ فيه الجميع في هذه المدينة الضخمة، في المنزل الكبير، في الوقت الذي لا تسمع فيه أيّ صوتٍ سوى صوت دقات القلب ورنين الساعة، الآن فقط أرى أنّ جميع هذه الأحزان والأفراح وكل ما حدث في الحياة، ليست إلا أشباحا، بلا جسد. أولئك الذين كنتُ أركضُ خَلفهم ولا أدري لماذا، وكذلك الذين هربتُ منهم ولا أدري لماذا أيضاً. لم أكن أعلم حينها أنّ الحياةَ فيها شيء واحد، وهو الوقت. يمضي الوقتُ ويتحركُ بلا رَحمة، لا يتوقفُ عندما يرغب البائسُ أن يتوقفَ مدة أطول، ولا خُطوة بمقدارِ ذَرّة، حتى في الأوقات التي تكون فعلاً قاسية وثقيلة، حتى إنك تتمنى أن تكون حُلماً قديماً، الزمنُ لا يعرف إلا أُغنية واحدة، تلك التي أسمعها الآن بيأسٍ واضح.
كان يفكرُ في ذلك، وبقيت الساعةُ تدقُّ وتدقُّ بإزعاج، مُكررة أغنية الزمن الأبديّة. أثارت هذه الأُغنية لديه الكثير من الذكريات.
– حقاً إنه شيءٌ غريب. يحدثُ أحياناً أنّ رائحةً بعينها أو عُنصرا غير مألوف يُعيد للذاكرة صُورة كاملة عن موقفٍ أو تجربةٍ ما. أتذكَّر ماتَ رجلٌ أمامي، توقف عزفُ أرغن إيطالي أمام النافذةِ المفتوحة، وفي تلك اللحظة تحديداً، عندما تكلّم المريضُ بكلماتٍ غير مُترابطة وانحنى برأسه وتأوَّه أَلماً، سُمِعَتْ نغمة من “مارتا”:
للفتيات
للطيور
سهامٌ حمراء…
وإلى الآن، في كُلّ مرّة أسمع فيها العزف -في بعض الأحيان ما زلتُ أسمعه- الابتذال لا يَموتُ كثيرا، تظهرُ مباشرةً أمام عيني وسادة مُجعّدة وعليها وجهٌ شاحب. وعندما أَمُرُّ بجنازةٍ، وحالما تبدأ مَعزوفة صغيرة ترنُّ في أُذني:
للفتيات.. للطيور…
يا للقرف! لماذا بدأتُ أفكِّرُ في ذلك؟ أها، أها، لماذا هذه الساعة، التي كان يجبُ أن أعتادَها، تُذكِّرني بذلك كثيراً؟ كل حياتي. “أتذكّرُ، أتذكّرُ، وأتذكّر..” أتذكّرُ جيداً حتى تلك الأمور التي يجبُ نسيانها وعدم تذكرها. بسبب هذه الذكريات، يشحَبُ وَجهي وتتجمع قبضتي وأضربُ بها الطاولة بقوّة. وها هي ذي الضربةُ يَطغى صوتُها على صوت رنين الساعة، وللحظةٍ لم أعدْ أسمعها، فقط للحظةٍ واحدة، بعدها يُسمَعُ وبعناد “تذكّر، تذكّر… تذكّر”.
– نعم حقاً هأنذا أتذكّرُ، لا داعٍ لتذكيري. الحياةُ كُلّها، كأنّها بحجمِ راحة اليد، أمرٌ يُثير الإعجاب!
صرخَ بصوتٍ عالٍ مكسور، وتقلَّصَ حلقه. خُيِّلَ له أنّهُ رأى حياته بأكملها. تذكّر صفاً مُسلسلاً من التجارب القاتمة والمُظلمة التي كان هو بطلُها، تذكّر كُلَّ قذارات حياته، قَلَّبَ كُلَّ أوساخ روحه، علَّهُ يجدُ شيئاً مُشرقاً، إلا أنّه لم يجدْ فيها ولا ذَرَّة مشرقة نقيّة، وكان على يقينٍ بأنّه لم يبقَ في روحه سوى الأوساخ.
– ليس فقط لم يبقَ، لكنْ لم يَكُن هنالك شيئاً بالأصل -هكذا صحَّح لنفسه-. سمعَ صوتاً خجولاً ضعيفاً خارجا من أعماق روحه يقول
– يكفي، أليس كذلك؟
لم يكن يستمع لهذا الصوت، أو لنقلْ في الأقل تظاهرَ بأنّه لم يسمعه، واِستمرَّ في تعذيب نفسه.
قَلَّبتُ كُلَّ شيءٍ في ذاكرتي، ويبدو أنني كنتُ على حقٍ، لا شيء أتوقف عنده ولا مكان لأضعَ قدمي فيه لكي أقفز خُطوة للأمام. ثم إلى أين؟ لا أعرف، لكن فقط يجب الخروج من هذه الدائرة المُفرَغة. ما من دعم من الماضي، لأنّ كُلَّ شيءٍ كذبٌ، كُلَّ شيءٍ خِداعٌ. كنتُ أَكذبُ وخَدعتُ نفسي دون أن ألتفت للوراء. هكذا يقومُ المُحتالُ بخداعِ الآخرين، يتظاهرُ بالثراء، ويتحدَّث عن ثرائه الموجود “هناك” في مكانٍ ما ولم يتسلمه بعد، ويأخذُ يستدينُ المال من كُلِّ الاتجاهات. لقد كنتُ أقترضُ من الحياة لنفسي، وحان الآن وقت التسوية والسداد، لكنّني مفلسٌ خبيثٌ سيئ السمعة.
أخذَ يُردِّدُ هذه الكلمات في عقله بنوعٍ من المُتعة، وكأنّه فخورٌ بها. ولم يلحظ أنّهُ هو نفسهُ مَنْ وصفَ حياته كاملةً بالخداع وخلطَ نفسه بالأوساخ، وكذبَ على نفسه الكذبة الكُبرى في العالم، وهي الكذبُ على نفسه. في الواقع لم يكن يُقدِّر نفسه اطلاقاً. وليخبرهُ أحد ما بعُشرِ ما كان يتحدّثُ به عن نفسه في ذلك المَساء الطويل، لَظهرَ مُباشرةً على وجههِ الاحمرار ليس فقط بسبب العِتاب بل من الغضب. وسيكونُ قادراً على الرد على مَنْ أساء إلى كبريائه، والظاهر أنه هو نفسه الآن قد داسها بلا رحمة.
هل هو نفسه؟ وصلَ إلى مرحلةٍ لم يعد يستطيع أن يقولَ فيها عن نفسه أنا نفسي. في رُوحه خرجت العديد من الأصوات: تحدَّثوا بأشياءٍ مُختلفة، وأيّ من هذه الأصوات لم تكن تَخصه، لم يعد يَفهم، أيُّها أناه هو. كانَ صوتُ روحه الأوّل يَجلِدهُ بعبارات بعينها، بعبارات بدتْ جميلة. وكانَ الصوتُ الثاني غير واضح، لكنّهُ بنبرةٍ حزينة مُستمرة طاغيةً أحياناً على الصوت الأول.
“لا تنتحر”!
– قال هو: لماذا؟ من الأفضل الاستمرار في الخِداع حتّى النهاية، اخدعِ الجميع. امنحْ من نفسك للآخرين، وسيكونُ ذلك جيداً لك. وكان صوتٌ ثالث هو نفسه ذلك الصوت الذي سأل: “يكفي، أليس كذلك؟” لكنّه تحدَّثَ بصوتٍ لا يكاد يُسمع، ولم يحاول حتى سماعه.
– اخدعْ نفسك. تظاهرْ واصنع من نفسك ليس ما أنت عليه، لكن شيء آخر… لكن، ألم أكن أُحاول فِعلَ ذلك طوال حياتي؟ ألم أكن أَخدع، أُقامر من باب السخريّة؟ وهل تحقق شيءٌ “جيدٌ؟” ما حدث هو أنّني أنهارُ مُمثِّلًا، حدثَ أنّني آخر غير أنا في حقيقة الأمر. حقاً، هل أنا أعرفُ نفسي في حقيقة الأمر؟ أنا مُتحيِّرٌ في مَعرفةِ نفسي، لا يَهُم، وعلى كُلِّ حال، فإنّني أشعرُ بالتحطم والانهيار ساعاتٍ مُتتالية، وأقولُ لنفسي كلمات مُثيرة للشفقة، من تلك الكلمات التي أنا بنفسي لا أُصدِّقُها، أقولها قبل الموت. هل حقاً قبل الموت؟
– نعم، نعم، نعم! صرخ بصوتٍ عال، في كُلّ مرّة كان يَجمع قبضته ويضرب بها حافة المكتب: لا بُدَّ من وضعِ نهاية للارتباك. العُقدة مربوطة بطريقةٍ لا يُمكن فكّها: يجبُ قَطعها. لماذا كان عليك سحبها، وتمزيق الروح بالخرق؟ لماذا كان ضرورياً عندما قرّرتَ أن تجلِسَ مع هذه النغمات، من الساعة الثامنة مساءً إلى هذه اللحظة؟
**
كان حقاً قد جلسَ في مكانٍ واحد من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة صباحاً.
في الساعة السابعة مساءً من هذا اليوم الأخير من حياته، خَرجَ من شقته واستأجر سائقا، وانطلق متوجهاً إلى أقصى طرف المدينة. حيث يعيشُ صاحبه القديم، الدكتور، الذي يعلمُ بأنّه سيكون مع زوجته في المسرح. كان يعلمُ بأنَّ أصحاب المنزل ليسوا فيه، فهو لم يكن ذاهباً لرؤيتهم. كانوا سيسمحون له في دخول المكتب، صديقا مُقرَّبا للعائلة، وهذا ما كان يرغبُ فيه.
“نعم، رُبَّما سيسمحون، سأُخبرهم بأنّي سأكتبُ رسالة، على أن لا تُقرِّر دنياشا أن تظلّ تتسكع حولي في المكتب…”.
– صرخَ في سائق الأُجرة، حسناً يا عم لتسرع أكثر.
كان السائق صغير الحجم بظهرٍ مُنحنٍ خَرف، برقبةٍ رقيقة جداً، مَلفوفٌ حولها وِشاحٌ مُلوَّن، بشعرٍ مُجعّد رمادي ظاهر من تحت قُبعة دائرية كبيرة، زَمَّ شفتيه، وتحدَّثَ بصوتٍ مَكسورٍ وبعجلة
– لنسرع يا بابا، لا شَكّ في ذلك يا حضرة النبيل. لكن، لكن! امشي أيتها المُدللة! يا لهُ من حصان، سامحني أيُّها السيّد، لكن،… ضَربه بالسوط، وأجاب على ذلك بحركةٍ بطيئة بذيله. أرغبُ في نيل رضاكم، لكن المالك أعطاني مثل هذا الحصان… مثل هذا فقط، يستاءُ السادة، ماذا سنفعل؟ وهنا يُجيب المالك: أنت أيُّها الجد كبير وهذه الدابة لك، وأنتم من الجيل نفسه، ويبدأ الآخرون بالضحك، إلامَ يحتاجون؟ هل حقاً يفهمون؟
– لا يفهمون؟ سأل الراكب وهو شارد يفكر في الوقت ذاته في كيفية عدم إدخال دنياشا المكتب.
– لا يفهمون أيُّها السيّد النبيل، لا يفهمون! كيف لهم أن يفهموا؟ شبابٌ صِغارٌ حَمقى. فأنا الوحيدُ من بينهم العجوز، هل يَحقُّ الإساءة لرجلٍ عجوز؟ لقد عشتُ ثمانين عاماً، وهم لم تظهر أسنانهم بعد. خدمتُ ثلاثة وعشرون عاماً جنديا.. حقا إنّهم حمقى… حسناً، طاعنٌ في السن، جامد!
ضرب الحصان بالسوط مرّةً أُخرى، لكنَّ الحصان على ما يبدو لم يُعرْ ذلك أيّ اهتمام، لذا أضاف:
– ماذا سنفعل حيال ذلك؟ هو أيضاً في الحادية والعشرين، انظر ها هو ذا يهز ذيله.
على المبنى الضخم، أشارت الساعة الدائرية الكبيرة إلى السابعة والنصف.
“لا بُدَّ أنَّهم غادروا” هكذا أخذَ يفكِّرُ الراكب في الدكتور وزوجته، “لكن رُبّما ليس بعد…”.
– لا تُسرع يا جدي من فضلك! قُدْ ببطءٍ فلستُ في عجلةٍ من أمري.
– معروف يا بابا، على مهل، فرح الرجل العجوز. ذلك أفضل، الهدوء.
سرنا هنيهة صامتين، وأصبحَ الرجل العجوز أكثرَ جُرأة.
– هلّا أخبرتني يا سيّدي –قال ذلك والتفتَ بوجههِ للخلف نحو الراكب، أظهرَ وَجهاً مُنقبضاً متجعّداً بلحيةٍ رمادية رفيعة وجُفونٍ حمراء- من أين يأتي الهجوم على الشخص؟ كان لدينا سائقٌ شاب اسمه إيفان، شابٌ صغير لا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، لا يدري أحد لأيِّ سببٍ قتل نفسه!
– من؟ سأل صاحبنا الراكب بهدوء.
– نعم، إيفان، إيفان سيدوروف. عاش معنا نحن أصحاب تأجير العربات، كان شاباً نشيطاً مهذباً، سأخبرك بذلك مباشرة. ها هو ذا الحال! تناولنا العشاء يوم الاثنين وخلدنا إلى النوم. نام إيفان يومها من دون عشاء. قال إن رأسه يؤلمه. وفيما نحن نيام نهض إيفان وخرج. ولم يرَ أحدٌ ذلك. في الصباح وجدناه مُعلّقاً بمُسمار في الإسطبلات. نزعَ الحزام من المسمار، ووضعه جانبه، وربط الحبل… يا إلهي! حدثَ ذلك كأنه في القلب. فما السبب الذي يجعلُ سائقاً يشنق نفسه؟ وكيف يخرج ذلك من سائق؟ أمرٌ مُذهل!
– لماذا؟ -سألَ صاحبنا الراكب- سألَ وهو ينظِّفُ حلقه ويلفُّ معطفه حولَ يديه المُرتجفتين.
– ليس لدى السائق مثل هذه الأفكار. العملُ صعبٌ وثقيل، من الصباح الباكر، من دونِ ضَوءٍ، ومَعروفٌ الصقيع والبرد. يكونُ التفكير هنا فقط في التدفئة وحساب الأرباح ودفع أُجرة النوم والسكن. التفكير هنا صعب. لكن كما هو معروفٌ أيُّها السيّد، أنَّ كُلَّ الأفكار تتواردُ إلى ذهنك مع مثل هذا الطعام.
– عن أيِّ طعامٍ تتحدَّث؟
– من الخبز، من الرئتين. بَعدها يقومُ الشاب، يرتدي جلبابه ويشربُ حصته من الشاي، ويتجوَّل في الغرفة، يسيرُ والخطيئة محيطةٌ به. رأيتُ ذلك من قبل، في فوجنا في تينجينسكم في القوقاز، كان هناك المُلازم الأمير…
– توقف، توقف. صاح الراكبُ فجأةً، هنا إلى الفانوس، سأُكملُ سيراً على الأقدام.
– كما تريد، سيراً على الأقدام، ليكن على الأقدام… شكراً لكم.
استدار سائق الأُجرة، واختفى وسط العاصفة الثلجية، ومشى الراكبُ إلى الأمام مُكتئباً. وبعد عشر دقائق، صعدَ إلى الطابق الثالث وضغط على الجرس المُنجَّد بقماشٍ أخضر ومُزخرف بنحاسٍ لامعٍ ونظيف. بدت له دقائق الانتظار بلا نهاية، حتى فُتِحَ له الباب. تغلَّب عليه النسيان البليد، والماضي المُؤلم وثرثرة السائق العجوز والحالة الغريبة التي أجبرتهُ على السير على قدميه، وحتى النية المُبيَّتة التي جاءت به إلى هنا. لم يكن أمامه سوى باب أخضر بأشرطةٍ سوداء مُعلَّقة بمسامير برونزيّة، ولم يكن في نظره إلا هذا الباب في العالم.
– أأخ، ألكسيي بتروفيتش؟
كانت دنياشا هي التي فتحت الباب وبيدها شمعة.
– لقد غادرَ السيّد والسيّدة منذ لحظات، كيف لم تُصادفهم على الدرج؟
– غادروا؟ آه يا له من إزعاج! لقد كذبَ بغرابة لدرجة جعلَ وجه دنياشا الذي كان ينظرُ إليه يقعُ في حِيرة. كان عليَّ أن أُقابله، اسمعي يا دنياشا، هل يمكنني الدخول لمكتب السيّد دقيقة واحدة؟ -سأل بصوتٍ مُرتَجِف خَجول- فقط لكتابة مُلاحظة… هكذا… دقيقة…
طلب ذلك بإقناع، دون أن يتحرك أو يخلع معطفه. وشعرتْ دنياشا بالحرج.
– ما الذي تتحدثون عنه ألكسيي بتروفيتش، أهذه المرّة الأولى؟ قالت بملامح غاضبة، لو سمحتم، على الرَّحب.
“على كُلّ الأحوال، لماذا أقولُ كل هذا؟ إنّها تأتي معي، لا بُدَّ من إبعادها، أين سترسلها؟ خَمِّنْ… هل خَمَّنتَ؟… خَمَّنتُ الآن”.
لم تكن دنياشا قد خَمَّنتْ شيئاً، على الرغم من المفاجأة التي تعرضت لها من خلال سلوك ولباس الضيف. لقد تُركَتْ وحدها في الشقة الكبيرة، وكانت سعيدة بأن تبقى ولو خمسة دقائق مع شخصٍ حي. وضعتِ الشمعة على الطاولة ووقفتْ عند الباب.
“اذهبي، اذهبي لأجل الله”.. هكذا صرخ ألكسيي بتروفيتش بينه وبين نفسه.
جلسَ على الطاولة وتناولَ ورقة وأخذَ يُفكِّرُ في شيءٍ يَكتُبه، شعرَ بأنَّ نظرات دنياشا تخترقه، وتهيأ له وكأنّها قد قرأت أفكاره.
كتب -وهو يتردّد بين كل كلمة وأخرى ويتوقف قليلاً- بيوتر نيكولايفيتش، كنتُ أريدُ البحث معك في مسألةٍ مهمة، تلك…
همس: “تلك… تلك… أووه ما تزال واقفة”.
-دنياشا! لو تكرمتم أحضروا لي كُوباً من الماء. قال ذلك فجأةً وبنحوٍ حاد وصارخ.
– حاضر، ألكسيي بتروفيتش. قالتْ ذلك واستدارتْ ذاهبة.
عندها نهضَ الضيف سريعاً على رؤوس أصابعه واتَّجهَ إلى المنضدة التي علّق عليها المُسدس والسيف اللذان كانا يسُتخدمان في الحملة التركية. فكَّ غِطاء الجِراب بمهارةٍ وأخرجَ المُسدَّس ووضعه في جيبه، وتناولَ بعدها مجموعة من الطلقات وحشاها في جيبه. بعدها بثلاث دقائق كان كوب الماء الذي أحضرته دنياشا قد شُرِب، والرسالة غير المكتملة مختومة، وألكسيي بتروفيتش متوجهاً لمنزله. “يجبُ أن تتوقف، يجبُ أن تنتهي” أخذَ رأسه يردّد ذلك. لكنّه لم ينتهِ عند وصوله. دخلَ الغُرفة وأغلقها بالمُفتاح وألقى بنفسه على الكنبة، رأى لوحة فوتوغرافية معلّقة، كتاباً، ورسماً على الحائط، وسمع دقات الساعة التي نسيها على الطاولة، وأخذَ يُفكِّر. جلسَ بلا حراك، ولا حتى أي عضلة فيه قد تحركت، بقيَ على ذلك الوضع حتى مُنتصف الليل، حتى تلك اللحظة التي وجدناه فيها.
**
لم يخرج المُسدَّس بسهولةٍ من جيب المعطف الضيق، وعندما كان مستلقياً على الكنبة، اتضح أن جميع الطلقات باستثناء واحدة، كانتْ قد سقطت من ثُقبٍ ضيّق في المعطف. خلعَ ألكسيي بتروفيتش المِعطَف وكان على وشك أن يتناول سكيناً؛ ليشُقَّ به جيب المعطف ويستخرج الطلقات، إلّا أنه ثابَ إلى رُشده وابتسم لاويا شفتيه الجافتين وتوقف.
– ما العمل؟ واحدة تكفي.
– أووه نعم، قطعة صغيرة واحدة من هذه، تكفي لكي يختفي كل شيء وإلى الأبد. العالم بأكمله سيختفي، لن يكون هناك أسفٌ ونَدم، ولا كبرياء مَجروحة، ولا عَتب ولومٌ للنفس، ولا أُناسٌ كارهون يتظاهرون بالطيب والحبّ، أشخاصٌ تُشاهدهم وتحتقرهم ومع ذلك تتظاهر بالحبّ اتجاههم وتتمنى الخيرَ لهم. لن يكون هُناك خداعٌ للنفس وللآخرين، ستكون هناك الحقيقة، الحقيقة الأبديّة لعدمِ الوجود.
سمعَ نفسه ولم يعد يُفكِّر، بل يتكلم بصوتٍ عالٍ. وخُيّل إليه بأنَّ كُلَّ ما قاله مُثيرٌ للاشمئزاز.
– مرّةً أخرى… تموت، تقتل نفسك- وهنا لا يُمكنك الحصول على فرصةٍ للحديث. أمامَ مَنْ ستتباهى؟ أمام نفسك. “أووه، هذا يكفي… يكفي”. كرَّرَ بصوتٍ تَعب ومُنخفض، وحاولَ فتح مِزلاج المُسدَّس بيدين مرتعشتين. أطاعته فتحة المزلاج أخيراً، دخلت الطلقة المُلطخة بشحمِ الخنزير داخل الأسطوانة، وبدا الزناد وكأنّه جاهز من تلقاءِ نفسه. لا يمكن لأيِّ شيءٍ أن يمنع الموت، مُسدَّسٌ مثالي، مُسدَّس ضابط. البابُ مغلق ولا يمكن لأحدٍ أن يدخل.
– حسناً يا ألكسيي بتروفيتش. قال ذلك وهو مُمسكٌ بقوة بالمِقبَض.
– والرسالة؟ -ومضتْ فجأة في رأسه- هل من الممكن أن تموتَ دون أن تترك ولو سطراً واحداً؟
– لماذا ولمن؟ كلُّ شيءٍ سيختفي، لن يكون شيءٌ، بماذا سيهمني…
– هكذا هو الحال، ومع ذلك سأكتب. هل من المُمكن عدم التَّحدُّث ولو مرة واحدة بحريّةٍ مُطلقة دون الشعور بالحَرج من شيءٍ وخصوصاً من نفسك. تبدو حالةً نادرة، نادرةٌ جداً تحدثُ مرّة واحدة فقط.
وضعَ المُسدَّس، وأخرج من الدُّرج دفتر ملاحظات، وغيّر العديد من الأقلام التي تكسرت معه ولطخت الصفحة، وأفسدت العديد من الأوراق، كتبَ أخيراً “بطرسبورغ 28 نوفمبر، *187” بعدها انطلقت يده على الورقة وأخذَ يكتبُ كلمات وعبارات لا يكاد هو نفسه أن يَفهمُها. كتبَ بأنّه سيموتُ بهدوءٍ، فليس عنده شيء يَندم عليه، ما الحياةُ إلا كِذبة، والنّاس الذين أحبّهم -لو كان قد أحبَّ شخصاً حقاً، ولم يتظاهر أمام نفسه بأنّه يُحب- لم يكونوا قادرين على إبقائه على قيد الحياة، لأنّهم لم يعودوا يستطيعون تقديم شيء “استنفدوا قواهم”، وما عادوا يُثيرون اهتمامه ما أن يدرك حقيقتهم. وبأنّهُ فَهِمَ نفسه التي لم يكن فيها شيء سوى الكذب، وأنّه إن فعلَ شيئاً في كامل حياته فلم يكن ذلك بدافعٍ من الخَير بل من الغرور، وأنّه لم يَقُمْ بأيِّ عملٍ شريرٍ وغيرِ شريف، ليس من باب الافتقار إلى الصفات الشريرة لكن من بابِ الخَوف من النّاس. وهذا لا يعني أنّه يرى نَفسه أسوأ من “أنت الذي ستبقى حتى يومك الأخير” وأنّه لا يطلبُ المغفرة وأنّهُ يموتُ مُحتقِرا النّاس بما لا يَقِلُ احتقاراً لنفسه. وانفجرتْ عبارةٌ قاسية بلا معنى في نهاية الرسالة: “وداعاً أيُّها النّاس! وداعاً أيَّتُها القُرود المُتعطشة للدماء”.
لم يبقَ سوى التوقيع على الرسالة. وعندما انتهى من الرسالة شعرَ بالحَرِّ وصعدَ الدم إلى رأسه. نسي المُسدَّس وحقيقة أنّه عندما يتخلص من الحياة سيتخلص من الحرِّ أيضاً، نهض وتوجه نحو النافذة وفتحها. شعرَ بلفحةِ هواءٍ باردٍ تَصفعُه. توقف تساقط الثلج وبدت السَّماء صافية، وعلى الجانب الآخر من الشارع حديقة جميلة بدتْ تَلمعُ تحت ضوء القمر. بدت العديد من النجوم في السَّماء الصافية البعيدة، وكان أحدها أكثرَ سطوعاً واحمراراً…
– “السِّماك الرَّامح”، (حالة فلكيّة، يكون فيها النجم أحمرَ) همسَ ألكسيي بتروفيتش. كم من السنوات لم أره؟ من أيامِ الثانوية عندما كنتُ أدرس…
لم يكن يرغب في رفعِ عينيه عن النجم. كان أحدهم يمشي مُسرِعاً في الشّارع، ويدقُّ بقوّةٍ برجليه الباردتين على ألواحٍ، بمعطفٍ باردٍ مع صرير العَربة التي تسيرُ على الثلج المُتجمِّد. مع مُرورِ سيارة أُجرة مع شخصٍ سمين، كان ألكسيي بتروفيتش لا يزالَ على حالِهِ مُتجمِّداً.
– ضروري! قال لنفسه أخيراً.
توجَّه إلى الطاولة. كانت المَسافةُ بين النَّافذة والطَّاولة خطوتين، لكنْ بدا له وكأنّه يمشي زمنا طويلا. عندما تقدَّم كان قد أخذَ المُسدَّس، ومن خلال النَّافذة المفتوحة، سمعَ صوتَ ناقوس من بعيدٍ، صوتاً مُرتجفاً لكنّهُ واضحٌ.
– ناقوس! قال ألكسيي بتروفيتش ذلك مُتفاجئاً، وأعادَ المُسدَّس إلى الطَّاولة وجلسَ على الكنبة.
**
– ناقوس! -كرَّر ذلك- لكنْ لماذا؟
– يتلُون الإنجيل، أم ماذا؟ إلى الصَّلاة… الكنيسة… شُموع، يَخدمُ الأب العجوز ميخائيل بصوته الحزين المُرتَجِف، يُشعِرُكَ بالنُّعاس. يكادُ ضوءُ الفجرِ يَخترق النَّافذة. يقفُ الأب إلى جانبي برأسٍ مُنحنٍ، يرسم الصَّليب سريعاً بحشدٍ من الرِّجال والنِّساء وخلفنا سجودٌ على الأرض مُتواصل… ياه كم مضى على ذلك!
مَرَّ وقتٌ طويل حتى إنه لم يَعُد بالإمكان التَّصديق بأنّ ذلك قد حدث، وأنّني رأيتُ ذلك حقا ولم أقرأه أو أسمعه في مكانٍ ما. لا، لا كان هذا كُلّ شيء، وكان الوضعُ أفضل. ليس فقط أفضل بل جيداً جداً، لو كان الوضعُ الآن هكذا لما كانت حاجة للمُسدَّس.
– توقف! همست له أفكاره. نظرَ إلى المُسدَّس ومدّ يَدَهُ إليه، لكنّه سحبها على الفور.
– هل جبنت؟ همست له أفكاره.
– لا لم أخف، لم يعد شيء مخيف، لكن الناقوس، ماذا عنه؟
ألقى نظرةً على ساعته.
-لا بُدَّ أنّه نداء للصّلاة. سيذهبُ النّاسُ للكنيسة، والكثير سيشعرون بالتَّحسُّن. في الأقل هكذا يقولون. وبالمُناسبة كنتُ أنا أيضاً أشعرُ بالتَّحسُّن. كنت حينها فتى صغيراً، لكن ذلك مات ومضى، ولن أشعر بالتَّحسُّن الآن من أيّ شيء. هذه حقيقة.
– حقيقة! وُجِدَت الحقيقة بمثل هذه اللحظة.
بدت هذه اللحظة حتمية. أدارَ رأسهُ ببطءٍ ونظرَ مُجدداً إلى المُسدَّس. كان المُسدَّس كبيراً حكوميّاً، من طراز سميث وويسون، أصبح الآن أبيض باهتاً نتيجة التّجوال الطويل في حافظة الدكتور. كان موضوعاً على الطاولة ومقبضه باتجاه ألكسيي بتروفيتش، الذي استطاعَ أن يرى خشبَ المِقبَض المُهترئ مع حلقة من الدانتيل والزّناد الذي يبدو جاهزاً، مع ظُهور طرف المُؤخرة الموجهة نحو الحائط.
– هناك الموت، لا بُدَّ من أَخْذِهِ، تقليبه…
كان الشّارع في الخارج هادئاً، ما من أحد من المَارة، ومن خلال هذا الصمت، ضربَ من بعيد صوتُ ناقوس آخر. ضربتْ موجاتُ الصوتِ، ودخلت من خلال النّافذة المفتوحة لتصلَ إلى ألكسيي بتروفيتش. تحدَّثوا معه بلغةٍ أجنبية عنه، لكنّهم قالوا شيئاً كبيراً، شيئاً مهماً ومهيباً. تتالت الضربات، وعندما ضرب الناقوس في المرّة الأخيرة وانتشرَ الصوتُ ودخل لفضاء ألكسيي بتروفيتش، كان بالتأكيد قد فقدَ شيئاً ما.
أدى الناقوس عمله؛ ذكَّر الرَّجُل المُرهق التَّعِب بأنَ هنالك شيء آخر غير عالمه الصغير الضيّق، عالمه الذي عذبهُ ودعاهُ للانتحار. غمرتهُ موجات من الذكريات، ذكريات مُجزَّأة غير مُترابطة، بدت وكأنّها شيء جديد تماماً عليه. لقد رأى الكثير في هذه الليلة، تذكّر الكثير من الذكريات حتى تخيّل أنّه شاهدَ حياته بأكملها، لقد شاهدَ نفسه بوضوح. شعرَ بأنّ لديه الآن جانبا آخر، هو نفسهُ الجانب الذي كان قد أخبره به صوتُ روحِهِ الخجول.
**
– هل تَذكُر نفسك عندما كُنتَ طفلاً صغيراً، تعيشُ مع والدك في قرية نائية بعيدة، لم يكن والدك رجلا سعيدا، لكنه أحبَّكَ أكثر من أيِّ شخصٍ أو شيءٍ في العالم. أتذكُرُ كيف كُنتما تجلسان معاً في أمسيات الشتاء الطويلة، هو مع حساباته وأنت مع كتابك؟ اشتعلت شَمعةُ الشحم بضوئها الأحمر وبدأت تتضاءل تدريجياً، حتى تقوم أنت بملقطك وتُزيل السخام عنها. كان هذا عملُك الذي تؤديه، على نحوٍ لافت حتى إنَّ والدك كان يرفع عينيه عن “الكتاب المنزلي” وينظرُ إليك بابتسامته الحنونة والحزينة، وعندها تلتقي أعينكما.
– قُلتَ انظر يا أبي كم من الصفحات قد قرأتُ. تقول ذلك وأنت تُمسك بالصفحات التي قرأتها وتريها لوالدك.
– اِقرأ… اِقرأ يا صديقي! يقولُ الأب ذلك ويعود مُنغمِساً في حساباته.
كان يسمحُ لك بقراءة كل شيء، فقد اعتقد أنَّ الأفضل هو ما سيبقى في نفس وَلَدِه العزيز. وأنت تقرأ وتقرأ، لم تكن تفهم كلّ شيءٍ بوضوح، على أنّه وبطريقتك الطفولية كنتَ تفهم الصورة العامة.
نعم، بدا كلّ شيء كما هو، الأحمر بقي أحمرَ دون أن يعكس الأشعة الحمراء. عندها لم يكن هناك أشكال جاهزة للانطباع، أفكارٌ من تلك التي يُصِبْ فيها الشخص بكامل نفسه، دون أن يهتم إذا كان الشكل مناسباً أم أنّه يُشكِّل هزَّةً وصَدعاً. وإذا كنت تُحبُّ أحداً فإنّك كنتَ تُدركُ ذلك، فلا شَكَّ في هذا.
نظرَ إليه وجهٌ ساخرٌ وبديع، نظرَ إلى عَينيه واختفى.
– وهذه؟ هل أحببتها؟ لم يعد ما يمكن قوله، فقد لُعِبَ بالمشاعر بنحوٍ مُذهل. لكن يبدو أنّه يتكلم ويُفكر بإخلاص حينها. ما أكثر ما كانَ من العذاب والمُعاناة؟ وعندما أتت السعادة، ظهرتْ أنّها ليست سعادة على الإطلاق، ولو كُنتَ حينها قادر على تنظيم الوقت “انتظر، توقف، هنا جيداً”. وسأظلُّ أُفكّر فيما إذا كنت سأطلبُ أم لا. وعندها، وبوقتٍ قريب سيكون ضرورياً دفعُ الوقت إلى الأمام… لكن لا تفكِّر في هذا! يجب التفكير فيما كان، وليس فيما بدا.
كان فقط القليل، طفولةٌ واحدة. ولم يبقَ في ذاكرته سوى شَذرات غير مُتماسكة، بدأ ألكسيي بتروفيتش بجمعها بنهمٍ. يتذكر المنزل الصغير، غُرفة النوم، حيث كان ينامُ في مواجهة والده.
أتذكَّر السجادة الحمراء المُعلّقة فوق فراش والدي، قبل النوم في كُلِّ مساء كان ينظرُ إليها، ينظرُ إلى السجادة ويرى فيها بكُلِّ مرّةٍ أشكالاً جديدة، الزُّهور، الوحوش، الطّيور، وُجوها بشريّة. أتذكَّرُ الصّباح الذي كانَ يَفوحُ براحةِ القَشّ، ذلك القَشّ المُستخدم لتدفئة المنزل. يجرّ نيقولاي الصغير ضمة من القَشّ ويضعُ حُزمة صغيرة على باب المَوقِد. كانَ يحترق بمرحٍ ووضوح وينفثُ برائحةٍ لطيفة، كان أليوشا مُستعدّاً للجلوس ساعة كاملة أمام المدخنة لكنّ والده يدعوهُ لشربِ الشّاي، قبلَ البِدء بتحضير الدّروس. يتذكّر كيف أنّه لا يفهم الكُسور العشريّة، وكيف أنّ والده يَغلي غَضباً ويُحاول أن يشرحها له.
يفكّر ألكسيي بتروفيتش “يبدو أنّه نفسه لم يكن يعرفها في ذلك الوقت”.
ثم التاريخ المُقدَّس، فقد أحبّه أليوشا أكثر شيء. صُورٌ خياليّة وضخمة. قابين، وبعدها قصة يوسف، الملوك، الحروب. كيف كان الغُرابُ يَجلِبُ الطعام للنبي إيليا. وكان هناك صورة: جلس إيليا على الصخرة مع كتابٍ ضخم، ويُحلِّق طائران نحوه، ويحملان في منقاريهما شيئاً دائريّاً.
“بانا”، انظر يجلبُ الغربان الطعام لإيليا، لكن “فوركا” نفسه يَسرقُ كُلَّ شيء.
غُراب ذو أنف وأقدام مطليّة باللون الأحمر -اخترع نيقولاي ذلك- يقفزُ جانباً على ظهر الكنبة ويمُدُّ رقبته ويحاولُ سحب إطارٍ برونزيٍّ لامع مُعلّقاً على الحائط. داخل هذا الإطار صورة مُصغَّرة لشابٍ ذي صِدغين ناعمين، يرتدي زيّاً أخضر غامقاً مع كتافيّة، وباقة حمراء مع صليبٍ في عروته. هذا كان أبي نفسه، بسن الخامسة والعشرين.
ومضت الصورة والغُراب، واختفيا.
– وبعدها، ما يعني هذا؟ المِذوَد، الحضانة. أتذكّر أنّ كلمة المِذوَد كلمة جديدة عليّ، على أنّني كنتُ أعرف المِذوَد في الفِناء من قبل، بدا هذا المِذوَد مميزٌ جدا. درسنا العهد الجديد بنحوٍ مُختلف عن العهد القديم. لم يكن كتاباً غليظاً. كان الأب يُخبر أليوشا بنفسه عن المسيح، وغالباً ما يقرأ صفحات كاملة من الإنجيل.
– “من ضربَكَ على خَدِّكَ الأيمن اَدِرْ لهُ خَدَّكَ الأيسر” هل تفهم ذلك يا أليوشا؟
وأخذ الأب يشرح طويلاً لكن أليوشا لم يكن يستمع. وفجأةً قاطع معلمه:
– بابا، هل تذكر عندما أتى العم ديمتري إيفانوفيتش؟ وهذا ما حدثَ بالضبط، لقد ضربَ فوما على وجهه، وكان فوما ما يزالُ واقفاً، وضربهُ العم ديمتري على الجانب الآخر، وفوما ما يزالُ واقفاً. شعرتُ بالأسف عليه وأخذتُ أبكي.
– “نعم، حينها بكيتُ” -قال ذلك ألكسيي بتروفيتش- وأخذَ يذرع الغرفة طولاً وعرضاً. “عندها بكيت”.
شعرَ بالأسف على هذه الدموع لصبي يبلغُ ست سنوات، آسف لذلك الوقت، الذي كان يستطيعُ البكاء لأنَّ شخصاً أعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه أُصيب في حضورِه.
**
ظلَّ الهواء البارد يتطاير تجاه الغُرفة من النّافذة، بدا وكأنَّ البُخار المُتصاعد يتدفَّق للغُرفة التي كانت بدأت تبرد حقًا. لمبةٌ كبيرةٌ مُنخفضة، بضوءٍ عاكسٍ خافت، تقفُ على المكتب، تحترقُ جيداً إلا أنّها تُضيءُ فقط مساحةَ الطَّاولة وشيئاً من السقف، شَكَّلت بُقعة ضوئيّة مُرتجفة، وبقيّة الغُرفة كانت مُظلمة. يُمكن للمرءِ أن يَرى فيها خزانة ملابس فيها كُتبٌ، أريكة كبيرة، وبعض الأثاث، مرآةٌ على الحائط بانعكاسٍ خفيف لمكتب الطّاولة ومجسم ضخم، قَلِقٌ ثائرٌ يمشي من زاوية لأخرى، ثمانية خطوات إلى هناك ومثلها إياباً، وفي كُلِّ مرّة يظهرُ وميضٌ في المرآة. في بعض اللحظات كان ألكسيي بتروفيتش يتوقف عند النّافذة، تدفَّق البُخار البارد على رأسه الساخن وصدرِه ورقبتِه العارية. كان يَرتجفُ بشعورٍ غير مُنعش. استمرَّ في الاختيار من ذكرياته بنحوٍ مُجزّأ وغير مُترابط، تذكّر المئات من التفاصيل الصغيرة، حائراً فيها دون أن يستطيع فهم الشيء المهم، فيها تحديداً. كان يعرف شيئاً واحداً فقط أنّه حتى سن الثانية عشرة، عندما أرسله والده إلى الصالة الرياضيّة، كان يعيش حياة داخلية مختلفة، ويتذكّر بأنّه كان وقتها بحالةٍ أفضل.
– ما الذي يجذبُك إلى هناك، إلى الحياة شبه الواعية؟ ما الشيءُ الجيدُ الذي كان في سنوات الطفولة؟ طفلٌ وحيدٌ وشخصٌ بالغٌ وَحيد، “بسيط” كما أسميته بنفسك بعد موته. لقد كُنتَ على حق، كان “بسيطاً”، شخصٌ بسيطٌ، شوّهته الحياة بسرعة وسُهولة، حطَّمتْ كُلَّ ما هو جميل فيه، كل ما جمعه في شبابه، لكنه لم يحمل أيَّ شيء سيئ. وعاش حياته ضعيفاً، بِحُبٍّ ضعيف، الذي -تقريباً- وجَّهه نَحوك.
فكَّر ألكسيي بتروفيتش في والده، وشعرَ أوّل مرّةٍ بعد سنوات وأعوام طويلة، شعرَ بأنّه يُحبُّه رغم بساطته، ورَغِبَ ولو لدقيقة واحدة أن يعودَ لطفولتهِ، إلى القرية، إلى المنزل الصغير، ليَحضُن هذا الرَّجل المُحطَّم، يحضُنُه كطفلٍ صغير. رَغبتُ في ذلك الحُبّ النقي البَسيط الذي لا يعرفُه سوى الأطفال وبعض الكبار الأنقياء الذين لم يتسخوا.
– هل من المستحيل إعادة تلك السعادة، هذه القُدرة على معرفة أنّ ما تُفكِّرُ به وتُدركُه صحيحاً؟ كم مرّت من السنين ولم أختبر ذلك! تتحدَّثُ بحرارةٍ كأنّه شيء صادق، لكن في روحك دُودة تَمتصُّ وتَطحن. الفكرة في هذه الدودة ماذا يُقالُ يا صديقي، ألا تَختلق كُلَّ ذلك؟ هل تُدرك حقاً ما تتفوه به الآن؟
ظهرتْ عبارة أُخرى في رأس ألكسيي بتروفيتش، على ما يبدو إنّها سخيفة “أتعتقدُ حقاً بما تُفكِّرُ فيه الآن؟”. كانت عبارة سخيفة، لكنه فهمها.
– نعم، لقد فكَّر تحديداً فيما خطرَ له، لقد أحبَّ والده وعَلِمَ بأنّه يُحبُّه. يا إلهي! القليل من الشعور الحقيقي الذي لا يموت في داخلي، ألـ”أنا”! هناك عالم حقاً، عالمٌ ذكَّرني به الناقوس الذي دَوَّى صوته. عندما قُرِعَ الناقوس تذكَّرتُ الكنيسة، تذكَّرتُ الحَشد، الجماهير الضخمة، تذكَّرتُ الحياة الحقيقة. هذا المكان هو الذي يجبُ أن تُحبّه كحُبِّ الأطفال، المكان الذي تَهربُ إليه من نفسك، كما يُحِبُّ الأطفال، ففي النهاية يُقال هنا.
توَجَّه إلى الطّاولة، فَتحَ أحد الأدراج وأخذَ يُنقِّب فيه. كان في الزاوية المُظلمة كتاب باللون الأخضر، اشتراه من معرض عموم روسيا بسعرٍ مُنخفض، سحبهُ بسعادة، تَسارعت الأوراق في عمودين ضيّقين تحت أصابعه، أعادت له الكلمات والعبارات المُتزاحمة في ذاكرته. بدأ يقرأ، وقرأ الصفحة الأولى وتتابعت بعدها الصفحات حتى إنه نسي العبارة التي طالَ الكتاب لأجلها. كانت هذه العبارة مَعروفة له من زمنٍ طويل ومَنسيّة كذلك، عندما وَصلَ إليها أذهلتهُ لضخامةِ المعنى الذي تحملُه في ثمانية كلمات “لو لم تعودوا، وترجعوا كالأطفال…”
خُيّل إليه أنّه قد فَهِمَ كُلَّ شيء.
– هل أدرك ما معنى هذه الكلمات؟ تعود كالطفل! هذا يعني أن لا تضع نفسك بالمرتبة الأولى في كُلِّ شيء. اِنزع من القلب هذه الروح البغيضة، غريبة الأطوار ببطنها الضخم، هذه الذات المُقزِّزة كالدودة تمتصُ الروح وتُطالِب دائماً بالمزيد. من أين سأحصلُ عليها؟ لقد أكلت كُلَّ شيء. كُلُّ القوّة، طوال الوقت كانت لخدمتك. أطعمتكَ والآن أعبدك، كرهتُك إلّا أنّني ما زلتُ أعبدُك، ضحِّيتُ في سبيلك بكُلِّ ما هو جميل، بكُلِّ ما هو مُتاحٌ لديّ، وهأنذا أنحني وأنحني وأنحني.
كرَّرَ هذه الكلمة، وعادَ يمشي في الغرفة لكن بخطوات ضعيفة، بتمايلٍ مع رأسٍ مُنحنٍ لصدره، بوجهٍ مُبلل بالدموع. توقفت قدميه عن طاعته، وجلس مُتكئاً بذراعه على حافة الكنبة، وأمالَ رأسَهُ الحار على يديه، وبكى كطفل. واستمرَّ فُقدان القوّة هذا طويلاً، لكنّه لم يشعر بالعذاب من ذلك. تدفقت الدموع أقلّ، وما من خجلٍ بسبب الدموع أمام أيّ مَن كان سيظهر في تلك اللحظة، لم يكن ليوقِفَ هذه الدموع التي حملت الكراهية. لقد شعر أنّه لم يلتهم ذلك الصنم الذي كان سنواتٍ ينحني له، وأنّه بقي شيء من الحبِّ وحتى التضحية بالنفس، وأنّه ما زال في الحياة ما يستحق سكب ما تبقى. أين ولأيِّ غرضٍ لم يكن يعلم، وفي تلك اللحظة لم يكن بحاجةٍ لمعرفةِ أين يذهب ويضع رأسه المُذنب. لقد تذكَّر المَرارة والمُعاناة التي رآها في حياته، الحياةُ المريرة الحقيقة، مُقارنةً بعذاباته الشخصية لم تكن شيئاً ذا بال، وفَهِمَ أنّه لا بُدَّ من الذهاب إلى هناك بحُزنه ويأخذ جزءاً منه ويتقبله، وعندها فقط سيحِلُّ السّلام في روحه.
– مُخيف. لم يعدْ بإمكاني العيش بمخاوفي أنا وعلى حِساب نفسي، من الضروري رَبط الحياة الخاصة بالمُشترك العام، بالحياةِ العامة، بمُعاناتها وأفراحها، وأن نُحِبَّ ونَكره ليس لأجل “أنا” ستلتهمُ كُلَّ شيءٍ ولن تُقدِّم بالمُقابل أيّ شيء، لكن من أجل الحقيقة المُشتركة بين النّاس، الموجودة في العَالم، ومهما صرخت ومهما تحدَّثتِ الروح، ورغم كُلِّ الجُهود المَبذولة لطَمسِها وإغراقها. نعم نعم، كرَّرَ ألكسيي بتروفيتش بقلقٍ رهيب، كُلُّ هذا مكتوبٌ في هذا الكتاب الأخضر، ويُقالُ للأبد وحقيقي، يَجِبُ “رَفض نفسك، وقتلُ أناكَ أنتَ، ورَميها على الطريق”.
– ما الفائدةُ التي ستجلِبُها لنفسك أيُّها المجنون؟ همسَ صوت. ولكنَّ الصوت الذي بدا فيما مضى خَجولاً صرخَ في الرد
– اصمت! وما الفائدةُ التي سيجلِبُها لنفسهِ إذا ما مَزَّق نفسه لأشلاء؟
قفز ألكسيي بتروفيتش على قدميه، واستقامَ بكاملِ جذعه. أسعدتهُ هذه الحُجَّة، لم يشعر بمثلِ هذه السعادة لا من النجاحات الحياتيّة ولا من حُبِّه للمرأة. وُلدت هذه البَهجة في القلب، وانفجرتْ فيه مُتدفقةً إلى كُلِّ أعضاءه، أحيتْ فيه ذلك المَخلوق البائس التعس. رَنّت الآلاف من النواقيس رسميًا، وأشرقتْ وأنارت الشَّمس العالم بضوئها الباهر واختفت.
اللَّمبةُ التي أضاءت الغُرفة الليلة الطويلة، أصبحت باهتة أكثر وأكثر وفي النهاية انطفئت تماما. لكن ما عاد ظلامٌ في الغرفة، لقد بدأ النهار. تدفَّق ضوءٌ رماديٌّ باهتٌ تدريجياً إلى الغرفة ليُضيء بخفوتٍ سلاحاً مَحشوّاً ورِسالة فيها لَعنات مَوضوعة على الطّاولة، وفي مُنتصف الغُرفة جُثَّة بشريّة بتعبيرٍ مُسالم وسعيد على وجهٍ باهتٍ شاحب.
1880
مُلاحظات:
*الملاحظة الأولى: “السِّماك الرَّامح” حالةٌ فلكيّة وضعناها بين قوسين عند ذكرها.
*الملاحظة الثانية: أليوشا هو اسم تدليل لألكسيي.
*الملاحظة الثالثة: “بانا” و”فوركا” عند ذكرها في سياق إطعام النبي إيليا، يبدو أنّهما شخصيات توراتيّة أو أسطوريّة.
*الملاحظة الرابعة: كلمة “المِذوَد” تعني مِعلف الدَّابَّة، عبارة عن حوض محفور في قطعة من الصخر. في الإصحاح الثاني من إنجيل لوقا نقرأُ كيف أنَّ مريم العذراء بعد أن وَلدتْ ابنها، قمّطتهُ واضجعتهُ في المِذوَد.
* فسيفولود ميخائيلوفيتش جارشين (1855- 1888) كاتب من الإمبراطوريّة الروسيّة، ولد في مقاطعة باخموت. سبقَ أن تَرجمنا للكاتب قصة بعنوان “الضفدع المُسافر”.